وقائع الاستبداد الديني

هذا موضوع يرمينا في بعد تاريخي أبعد لتفسير العلاقة بين القوة الاستبدادية، والعمل الفني القائم على أصالة لغوية قومية وحريصاً على دفع الاسترابة التي يخالطها القهر الذي ينطلق من عقاله القمعي، وفي التراث الممتد سوف نعثر على ما فعلته خلافة أبي عباس السفاح بخصوصها، وما نتج عن عداوة المنصور لأبي حنيفة النعمان الفقيه، وابن المقفع الباحث والكاتب، والشاعر سديف من جلد وتعذيب وسجن وقتل؛ وما فعله عهد المهدي في بشار بن برد وأبي العتاهية وحماد عجرد وعبدالكريم بن أبي العوجاء؛ وما حدث في عصر هارون الرشيد الذهبي من سجن لبشر بن المعتمر الهلالي شيخ معتزلة بغداد، وإعدام لصالح بن عبدالقدوس، ومروان بن أبي حفصة، وما فعله المأمون من سجن الفقيه أحمد بن حنبل وقتل أبي نواس. وقتل المعتصم لدعبل وتاريخ الواثق الحافل من تعذيب لأحمد بن حائط المعتزلي ونفي مروان بن أبي الجنوب وحبس ذي النون المصري المقصوف وجلد الفيلسوف الكندي ومصادرة كتبه، وما فعله المتوكل من سجن علي بن الجهم والشاعر الجماني العلوي محمد بن صالح العلوي وقتل بن الزيات واضطهاد المعتزلة ومطاردتهم وتحويل حياتهم إلى جحيم مقيم. وقتل المعتضد لابن الطيب السرخسي تلميذ الكندي الفيلسوف العظيم وعقاب المكتفي لابن الرومي الشاعر المرهف بدس السُم وقتل محمد بن داود الجراح وتعذيب أبي الفضل البلخي وصلب الحلاج والتمثيل بجثته.
الجد المتوحش الذي ألقى بظلال إرثه المشؤوم على حبس البارودي وعلي الغاياتي ونفي شوقي واغتيال فودة ومحاولة قتل محفوظ وتشويه كليلة ودمنة ومصادرة ألف ليلة وليلة والصراع الفاشل لتحرير المرأة والتغلُّب على التعصب الديني والوصول لحكم عادل والتخلُّص من الطاغية وتحقيق قيم المواطنة الحديثة واستيعاب الآخر؛ وظهور موضوع المسكوت عنه أمام العقول الملوَّثة التي ترصدت للمبدعين والمستنيرين تتصيد لهم الأخطاء فأطاحت بعلي فاهمي من الجامعة، والسبب هو حصوله على درجة الدكتوراه في فرنسا عن بحثه “المرأة في الإسلام”، ورفْضُ تدريس جورجي زيدان المسيحي للتمدن الإسلامي، وفصل الشيخ علي عبدالرازق من منصبه القضائي وإسقاط شهادته الأزهرية عنه بسبب تأليفه كتاب “الإسلام وأصول الحكم” والعاصفة التي واجهت عميد الأدب العربي طه حسين بسبب كتابه “في الشعر الجاهلي” حتى جاء عهد عبدالناصر ودولته البوليسية التي نصبت محاكم التفتيش لكل مفكر، فهاجم مجلس الشعب رواية “أنف وثلاث عيون” لإحسان عبدالقدوس بدعوى أنها تخرج عن التقاليد المرعية وأن حُسن الأسلوب وجمال الصياغة والمعالجة الموضوعية لا تغفر للكاتب طرحه لمسائل توجد فعلاً في المجتمع لا يستطيع حتى الأنبياء إنكارها؛ فصودرت الرواية قبل اكتمال نشرها، فطلب عبدالقدوس صك الغفران برسالة إلى عبدالناصر كما فعل نزار قباني ليتمكن من نشر ديوانه “هوامش على دفتر النكسة” وكما فعل ثروت أباظة لعرض فيلمه “شيء من الخوف” لكن عبدالناصر كان سلبياً، يلعب لحسابه وأفكاره للموازنة بين الأزهر والجماعات الإسلامية فظلت رواية “أولاد حارتنا” رائعة نجيب محفوظ ممنوعة من النشر في مصر حتى بعد حصول مؤلفها على أرفع وسام أدبي، جائزة نوبل 1988 بعد وفاة عبدالناصر وتركه لتقاليد قمعية ارتضاها كل حاكم بعده وسار على نهجه من عنف مع طوائف اليسار وإحجام لليمين المعتدل.
وحفلت المعتقلات من عام 1959 حتى 1964 بالأدباء والمبدعين والمفكرين حتى جاء السادات بانفتاحه ومذاهبه البهلوانية التي قد لا يميزها أيّ شيء إلا أنها غير ناصرية وكلها استعراضية تعوّض فشله في الظهور على السينما؛ فقضى على أنصار الناصرية والبعث القومي اليساري الجديد بالاستعانة بسجناء الإخوان المسلمين الذين تمّ شحنهم بالغلّ في معتقلات ناصر، ليتحالف معهم للقضاء على بقايا نظام جمال، لكن هذا التلاعب بالنار أودى بحياته هو شخصياً في حادث دراماتيكي معروف؛ لكن دعواه بإقامة دولة دينية تزامنت مع انقلاب محمد ضياء الحق في باكستان ثم قيام الثورة الإيرانية وإعلان الجمهورية الإسلامية برعاية دول النفط دون أن تُقدِّم الحلول الدينية أيّ أفكار لعلاج ثورة الخبز في مصر والسودان وغيرها؛ بل كانت تهدف إلى تدمير مؤسسات الدولة المدنية وبالتالي القضاء على حرية الإبداع والتعبير باعتبار أن مشايخ الطريقة الجديدة هم أصحاب الفرقة الناجية الحائزة على الدين حصرياً والوصية على تنفيذه، فهي نائب الحق والناطق باسم الشرع وكلمة الله على الأرض.
وظهر الاستبداد المعنوي ثم الإرهاب الجسدي بعماء وحشي، فقتل الشيخ الذهبي صاحب أهم كتاب عن مدارس التفسير القرآني ثم اغتيال فرج فودة ومحاولة قتل مكرم محمد أحمد وقتل رفعت المحجوب ومحاولة اغتيال عاطف صدقي وعمليات تصفية قيادات بالدولة ثم طعن محفوظ في منتصف عام 1994. وفي فترات لاحقة صودرت “وليمة لأعشاب البحر” لحيدر حيدر و”آيات شيطانية” لسلمان رشدي فأعلن الخميني أن دم سلمان حلال، وفي عام 2011 كانت للظواهري فتوى تكفير نجيب محفوظ ووصف أعماله بالإلحاد وهو يجدد البيعة للملا في أفغانستان!.
أما حركة الوسطية الإسلامية فمارست دور المشاهد، فمن ناحية اكتفت بالتنبيه من أخطار التغريب دون دراسة أو تنفيذ، ومن ناحية أخرى لم تستطع الوقوف أمام أطراف الغلو والتشدد في ظل إثارة سياسية عامة سممت جو الحوار
هذا الإرهاب الديني الذي بلغ حقاً مراده وكبح الكثير من التيارات المستنيرة وعَقَل أقلاما وعقولا وانعكس الظل الكئيب على قيادات ثقافية هيمنت على المشهد بفكر سياسي متأقلم يهدف إلى إرهاب معنوي خانق بدأ بتقليص دور المفكر الناهض ويصل إلى تقديم تقارير تعاون في إصدار أحكام مثل حكم التفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته، والظلم في مسائل الترقية بالجامعات؛ وتغريم جمال الغيطاني مبلغاً ضخماً لدفاعه ضد الحكم الظالم على الشاعر أحمد حجازي، وكان الرقيب بالمرصاد لأعمال سينمائية كثيرة من “المهاجر” ليوسف شاهين حتى “بحب السيما”، حتى تفاقم الإعياء وانحدر أي أمل في الرقي، وتحول حضور العقل النقدي إلى تخلف مُقيم!
هنا دعاة الإسلام لا المسيحية هم من وجب عليهم التزام حدود صلاحيات معينة لا يجاوزونها للتدخل في شؤون دنيوية، الخبراء فيها أعلم بها. وهكذا تعقد الحوار –الصراع- بين الدينيين والعلمانيين بدءاً من إشكالية ضبط المصطلحات، ومسألة وضع العلماني العربي في سلة واحدة مع العلماني الغربي ونسق فكري واحد؛ ثم انقسام الإسلاميين على أنفسهم بين متشدد مفكر وإصلاحي ليبرالي، وانقسام العلمانيين إلى علماني ثوري وعلماني نهوضي توافقي -وعلماني ليبرالي!- وهنا تبدّت إشكالية أخرى هي تبني فرقة بعينها من بين الإسلاميين التصدي لشريحة بعينها من العلمانيين وانتقاد ملمح واحد فقط من أيديولوجياتهم وتنفيذ فلسفتهم المادية الخالصة ونزعتهم الإلحادية الجريئة وطموحاتهم في اقتلاع الدين من المجتمع بالكامل، فاعتبروا بذلك العلمانية ما هي إلا حملة تبشيرية تزعم تدمير العالم الإسلامي ويجب وقف امتدادها السرطاني.
على محور آخر هناك العلماني الداعي بشكل معتدل لتبعية الغرب مع استقلال مفهوم المواطنة مع إلغاء الاستقلال الحضاري، ودعاة فصل الدين عن الدولة وهم الأغلبية في مراكز التوجه السياسي والإعلامي والثقافي والأكثر نفوذاً في أنظمة المؤسسات الوطنية ومنهم طائفة كبيرة تدين بعقائد الإسلام ولا تعاديها، ولا يختلفون عن الإسلاميين في الأصول الثابتة والمصادر الاعتقادية والعقائدية، لكنها فقط تختلف معهم في شكل الدولة، أي هي تكون إسلامية بالمصطلح الذي تعنيه لدى الإسلاميين أو مجرد دولة مسلمة تدين بالإسلام وتدافع عن شرائعه وشعائره.
دعك من تهمة الوصف بالعلمانية لكل من ينادي بحرية الفكر والتعبير، ومصطلح علمانية نشأ غربياً ليشير إلى هؤلاء الذين رفضوا تدخل الكنيسة وسيطرتها على الحياة العامة والشؤون السياسية، ودس اللاهوت المسيحي ومعاييره لقياس شؤون الحياة اليومية والهمّ الدنيوي. وكان غرضهم جعل الدنيا الواقعية هي محور التفكير والمصدر الأوحد للفكر والممارسات ودراسات الاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلم والتعليم والإعلام. وهذا في نظر رجال الدين تضييق للنظرة وبُعد عن الفكر الكوني الروحاني الذي ينبغي أن يراعي مسائل حسابات يوم القيامة، لكن العلمانيين رأوا أنهم بهذا إنما يوسّعون المجال فيفتحون الباب لكل المذاهب والطوائف للجلوس على مائدة مشاركة همّ واحد وقرار واحد.
هذه الطلائع الغربية خلقت النهضة الحديثة بوضعها الكنيسة ولاهوتها في إطارها اللازم؛ فاستخلصت المجتمع المدني والدولة من براثن قدسية التصورات الكنسية التي فرضت الرجعية والجمود لعدة قرون. وعندما ساد الفكر الغربي وظهرت آثار المد الحديث في الفلسفة وأنماط التفكير والتعبير، برز مصطلح “العلمانيون” في المجتمع الإسلامي بعد شيوع هيمنة الاستعمار الغربي على البلدان العربية والشرقية؛ ولعل أول من أدخل هذا المصطلح علينا هو إلياس بقطر المصري، مترجم الحملة الفرنسية وكتبها “عالمانية” نسبة إلى العالم المضاد لله وللكتاب المقدس. ثم أشاع استخدام هذا التعريف ليصف بقية المثقفين والكتاب الذين نهجوا نهج الحضارة الغربية الحديثة حيث صار الإسلام في دولة لا تديرها الشريعة؛ وهكذا يصير الإسلام مجرد دين كالمسيحية، يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ بينما يرى الإسلاميون أن المسيحية يمكنها الاكتفاء بدورها في جدران الكنائس، لكن الإسلام أشمل وأعمّ وله من التاريخ الحضاري ما يرفعه فوق مناهج الاستشراق ومكونات الخيار الحضاري الغربي، وأن العلماني المسلم أخطأ في اجتهاده وحسبوا أن الخيار الإسلامي في شكله المملوكي العثماني هو الاحتمال الحقيقي والوحيد حرصاً على ضمان النهضة الإسلامية، لكنهم -اللهم إلا مدرسة الإحياء والتجديد على يد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده- لم يقدّموا نموذجاً حضارياً أو رؤية بديلة، بل استخدموا لغة عنيفة خشنة وبرزت بينهم فصائل تميزت بالغلوّ والجمود، ودوائر عقيمة في المؤسسات الإسلامية التقليدية، وحلقات الذكر والخرافة الصوفية، وتجاهل أكثرهم سنة الله في التغير والتطور والتنوع متوهمين قدسية إلهية على تجارب السلف، وخنق الحاضر والمستقبل في صندوق صدئ ملتزمين بحرفية النص دون التبصر في روحه؛ دعك من تبعية رأي الشارع لحركات كبرى ادعت تبنيها بعث صحوة إسلامية كبرى بحدة ليست غير مألوفة على طباع الرجل الشرقي عموماً، أما حركة الوسطية الإسلامية فمارست دور المشاهد، فمن ناحية اكتفت بالتنبيه من أخطار التغريب دون دراسة أو تنفيذ، ومن ناحية أخرى لم تستطع الوقوف أمام أطراف الغلو والتشدد في ظل إثارة سياسية عامة سممت جو الحوار، فضلاً عن الالتزام التنظيمي لأتباع هذه الحركات والذي قضى على أدنى فرصة لمرونة التفاهم أو لخروج عناصر مستنيرة؛ ذات الالتزام الحزبي الذي كان قيداً على الطرف العلماني أيضاً فلم يتسع أفق الاجتهاد وتبادل الآراء وقبول الآخر، إضافة إلى وجود شعور محض بالدونية لدى الطرف العلماني بالنسبة إلى الآخر الغربي الذي يمارس دوره اللاشعوري في الاستعلاء على المدرسة الإسلامية في التحضُّر؛ هذا التضارب اللاموضوعي الذي انسحب بوعي أو دونه وبأشكال مباشرة وغير مباشرة على أطر التعامل مع الآخر والمنظار الذي يميز ثقافته واتجاهه وإنجازه الحضاري، هذا الشعور المراوغ الذي يظل مندساً، كامناً، فاعلاً، قرين نوع من الفصام المعنوي الذي يجعل الآخر الغربي مثيراً للإعجاب والخوف؛ الإعجاب بما أنجز والاندفاع لتبني منهجه وتقليده دون حرص كبير، ويجعل الآخر الديني القومي ممتلئا بالتأخر وسيطرة الأنا والدور القضائي، وبين الهوى الجارف نحو الأول والآليات الدفاعية ضد الثاني تتولد ذبذبة مفاهيم معقدة بين النفور السلبي في مخايلة التحرر الأيديولوجي، وبين الرغبة في الهروب من السجن الجغرافي والظرف التاريخي.
الجانب الأدبي من الكتب المقدسة يتوجه إلى الناس جميعاً، في كل زمان ومكان، وليس من الضروري، ولا من المحتوم، أن تكون حَبْراً، أو قسيساً، أو شيخاً من شيوخ الأزهر، لتقرأ في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، وإنما يكفي أن تكون إنساناً مثقف
ولا تفارق هذه الخاصية طبيعة أخرى تقترن بالبعد الأخلاقي والنفسي للمبدع ومدى ارتباطه أو اعتراضه على مجتمعه الكبير الذي يضم خصومة الفكر، أو جماعته الصغيرة التي تضم زملاء الاتجاه، أو حتى خليّته الدقيقة التي تضم خلاّن الحماس المماثل والأوفياء لذات الهوى، وأخيراً في حدود كيانه هو نفسه في محاوراته الذاتية الكاشفة مستبدلاً الكوجيتو الديكارتي للمعرفة بالكوجيتو الضد الذي يهتف “أنا لست آخر؛ إذن أنا موجود!” في حالة نفور سلبي ينطوي على نزعة توحيدية، تجميعية، ذات طابع قهري يناقض نفسه معتمداً على مركزية النقيض التي لا يظهر فيها- بعد أي صراع فكري- سوى تخيل أيديولوجي يدعم في النهاية التبعية المنطقية لفكرة واحدة قد لا تكون هي الأفضل في ظروف أخرى.
وفي إطار هذه المستويات المتناحرة تتجلى شواهد وغوامض كثيرة يجب أن يأخذها المتأمل الحقيقي في الاعتبار عن مناقشته الصراع بين الديني والدنيوي، وبين الإسلامي والعلماني حتى لا يكون مفهوم التحزب أحادي البُعد، حدّي الاتجاه في ظل ممارسة مستمرة لأدلجة الآخر وتشويه سمعته إما بأنه منحرف دنيء أو خائن عميل أو هو رجعي بليد، ثم وصفه بالكفر والإلحاد، أو بالغباء والتعالي، وبالتالي الحكم عليه بإعدام عمله الثقافي ونفيه من انتمائه الوطني وطرده من جنة الاعتقاد السليم؛ كما فعل المفكر حسن حنفي في مؤلفة “الاستغراب” عندما تقمص شخصية قائد استعراض ووضع كل فلاسفة الغرب في طابور عرض يحركهم كعرائس الماريونيت كيفما شاء، وكما حلا له، دون أدنى مراعاة لظروف خلقت أفكارهم، ودون أقل تميز بين الوجود الموضوعي لفيلسوف وآخر، فأقام محكمة تفتيش على صفحات كتابه واعتبر أن طائفة المفكرين أمامه الأعداء الملاعين لا لسبب سوى أنهم من أهل الغرب، وبعد أن دق بمطرقته على المنطق ورحابة الفكر السليم أصدر حكمه بالعداء لكل فكر يأتي من الخارج، وحشر الفلاسفة العظام في زنازين ضيقة بعد أن صنّفهم في مجموعات تناسب جرائمهم الفكرية.
هذا الوضع المعرفي على مستوى أكثر رقياً من مناخنا القسري القهري يفرض علينا أن نضع المفكر الكبير مؤلف “الاستغراب” في موضع التقييم والتحليل لنعرف أيّ آلية قمع أجبرته على أن يستخدم هذا المنظور التقليدي في الإسقاط والتفسير. ويرادف مفهوم القراءة للنص المقروء، حسب حكم المفكر الكبير جابر عصفور، فيغدو مرآة للذات القارئة وذلك على النحو التطبيقي الذي انتهت إليه قراءة نص الآخر في كتاب “الاستغراب”، مرادفاً نظرية المعرفة في الفلسفة التقليدية، خصوصاً من حيث أشكال العلاقة بين الذات العارفة وموضوعها المعروف، فالقراءة تومئ إلى الذات الفاعلة في المعرفة، والنص هو موضوع المعرفة، وفعل القراءة هو فعل التعرف الذي يتمّ في الزمان الوجودي والتاريخي من خلال الشعور. وليس النص المقروء، وثيقة مدوّنة في فهم حسن حنفي لعملية القراءة، ولا هو حقيقة موضوعية مستقلة أو حضور تاريخي معين، إنه صورة بلا مضمون، روح هائم بلا جسد والقراءة هي التي تعطي لهذا النص مضمونه وجسده، وبعبارة أخرى: النص لا يحتوي معنى موضوعياً كأنه شيء، إنه مجرد ورق ومداد. والقراءة هي التي تحيله إلى معنى وتجعله قولاً معلناً، ونطقاً مسموعاً، وتوجيهات عملية، ومعارك سياسية واجتماعية.
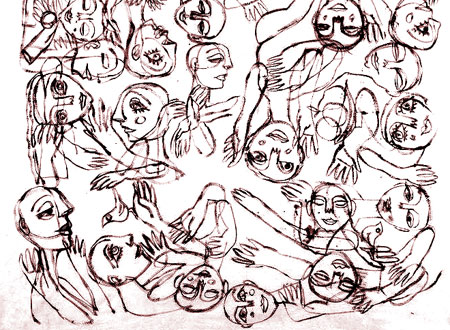
لوحة: فادي يازجي
وليست الحقيقة في قراءة النص -والكلام لدكتور عصفور- من منظور هذا الفهم، هي تطابق المعنى مع الواقع بل تطابق المعنى مع التجربة البشرية، وتجسيد هذا التطابق للشعور الفردي للقارئ، فكل قراءة إعادة بناء للمقروء، وخلق جديد له في شعور القارئ. ويعني ذلك أن النص ليس له ثواب، فهو مجموعة من المتغيرات، وأنه يتحول حسب الأحوال النفسية للقارئ الواحد، وحسب الفروق بين الأفراد، ويأخذ معاني مختلفة طبقاً لمراحل عمر الفرد الواحد، فيبدو تابعاً لتطور الفرد في مراحل عمره. ويعني ذلك أن أعماق الشعور في هذا الحال المعرفي أن ذلك ومن هذه النقطة ينشأ مبدأ الاجتهاد والتجديد، الذي يظن الإسلاميون أنه حكر عليهم، رغم أنهم لا يضعون ضمن أهدافهم الفكرية الأصلية كشف الوجه الحقيقي للإسلام في مخاطبة الآخر، وبالكلام معهم تصدم من عدم عثورهم على منابع طاقات مشروعه الحضاري وإمكانات تحقيق صورة مشرقة لحركة نهضوية وهّاجة، ربما لأن أغلب وقتهم أضاعوه في محاولات الربط بين العلمانية والعمالة والكفر والإلحاد، وبالطبع لم يلتفت أحدهم إلى إمكانات هؤلاء من خبرة وعلم ومهارة ومستوى فكري تحليلي؛ وهكذا تقف طاقات الدينيين عند الصفر لا تتعداه؛ بل الأدهى والأمر إضافة المزيد من الجهد لوضع إكسسوارات تجميلية لرجل الشارع حتى يزداد يقينه من أن هؤلاء هم أهل الحق، والهدف.. دنيوي غالباً (؟!).
عند فتح أوراق هذا الملف سوف تجد مشكلات كبيرة بلا حل -اللهم إلا الحلول السريعة الحاسمة التي لا ترضي سواهم وتعتمد في الأساس على أن نترك لهم مائدة الحوار منذ بداية الجلسة!- من هذه المشكلات، ما هو موجود في التركيب الجيني لعقل الأمة الإسلامية، ويتمثل في ظاهرة انقسام الفرق والطوائف منذ الغزو الاستعماري دون إيجاد سبل تقارب واضحة، وربما لن توجد أبداً؛ ثم المشكلة الأيديولوجية للقائمين على الدين من رجال فقه ودعوة الراسخة في عدم قدرتهم على تحديد موقفهم من العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، ومن ثمة عدم مراعاة الثوابت والمتغيرات، وبالتالي لا يصل للعابد الفرق الحقيقي بين الإلهي الملزم والبشري المرشد من الموروث الإسلامي، ثم تتسع الدائرة ليظهر الصدام مع القوانين الوضعية ودساتير الدولة والموقف من الحضارات الأخرى ودول الجوار ثم التعامل مع الأقليات غير المسلمة، والتفاعل الحضاري في زمن العولمة؛ ثم -ومن جديد- مشكلة الحوار مع العلمانيين، هذا الحوار الذي يعد أكبر معوقاته هو عدم حدوثه من الأصل بشكل حضاري لأسباب عدة لعلها أهمها هو الاختلاف على المفاهيم وعدم توحيد المصطلحات مما يجلب المزيد من الخلط والبلبلة فيزداد احتمال التقاء التيارين صعوبة.
إن مصطلحي تيار إسلامي وآخر علماني يضعنا من البداية أمام ديني ولا ديني (لا إسلامي) – ضد (الإسلام) نفسه. البعض يحب البدء بهذه المصطلحات على هذا النحو لتحفيز الحضور ضد الطرف الآخر من البداية، وكان من الممكن -إذا افترضنا حسن النوايا- أن يستبدلها بالتيار الديني والتيار المدني متجنباً الأحكام القيمة التي خرجت من جذر تعريف العلمانية الذي نبت في الغرب أصلاً؛ مع الانطباع السريع الذي يخطر على الذهن أن العلماني ليس بمسلم أولاً ويعتبر أن الإسلام أحد الدعائم الرئيسية للمجتمع الذي يجمعنا معاً. هذه الألفاظ العامة تعكس استقطاباً حاداً ينبغي تلافيه من البداية إن كنا نرغب في الوصول إلى صيغة توافقية تجمعنا على طاولة حوار هادئ يصل بنا إلى شكل للحياة يضمن الأمن والاستمرار. وكما يقول د. محمد عمارة، عندما يستخدم مصطلح إسلامي وكاتب إسلامي وتيار إسلامي، هل هذا يعني أن من لا يصنّف تحت هذا الشعار هو غير مسلم؟ هذا ما يثير شيئاً من القلق المشروع ولعله من المفيد عن الأحاديث الأكاديمي على هذا المستوى أن يقول الإنسان رأيه في هذه النقطة، فمصطلح “إسلامي” لا يعني أن غير المتصف به ليس مسلماً فنحن في تاريخ التراث والتاريخ الإسلامي القديم نجد أن كلمة “إسلامي” كأنها الرسالة، بالمعنى الحركي، سواء كان ذلك في القضايا الفكرية أو في الجهاد التنظيمي نفسه. ففي الإطار الماركسي مثلاً: الطبقة العالمة يمكن أن تكون صاحبة مصلحة في الاشتراكية ولكن الاشتراكي أو الشيوعي هو المنظم الذي يوجد في حزب، وبالتالي يكون هذا الحزب كتيبة طليعية لمن يتوجه هذا التوجه الفكري وأن وجود هذا الحزب لا ينفي وجود أناس تتعاطف مع الاشتراكية وتؤمن بها كأصحاب مصلحة فيها ولكنهم ليسوا هم بالذات اشتراكيين أو شيوعيين بالمعنى التنظيمي، أي أصحاب الموقف الذي يحوّل هذا الفكر إلى واقع تطبيقي.
مضى على الدولة الإسلامية حوالي ألف وأربعمئة وثلاثة وثلاثون عاماً وباستثناء فترة الخلافة الرشيدة كان حال المسلمين كما هو ثابت في التاريخ والتراث من أسوأ ما يكون
الإسلاميون هم أناس لهم موقف، وإن جمهور الأمة هو مسلم، والكثير من المفكرين هم مسلمون جيدون على مستوى الممارسات الشعائرية إذن المقصود هنا: قضية النظام الإسلامي كقضية جهادية ونضالية، فالإسلامي هو الذي يريد أن يضع تصور هذا الخيار الفكري موضع التطبيق لذلك فإن تعبير “إسلامي” لا ينفي إسلام التيارات الأخرى فأبوالحسن الأشعري عندما وضع كتابه “مقالات الإسلاميين” لم يكن يرى أن الذين لا يقولون بهذه المقالات ولا يشتغلون بهذا اللون من ألوان الفكر، هم غير مسلمين وبالتالي فإن استخدام مصطلح “إسلامي” هو استخدام سليم من الناحية العلمية لكنه لا ينفي إسلام الآخرين. لذلك يقول طه حسين في كتابه “رحلة الربيع والصيف” إن الجانب الأدبي من الكتب المقدسة يتوجه إلى الناس جميعاً، في كل زمان ومكان، وليس من الضروري، ولا من المحتوم، أن تكون حَبْراً، أو قسيساً، أو شيخاً من شيوخ الأزهر، لتقرأ في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، وإنما يكفي أن تكون إنساناً مثقفاً، له خط من الفهم أو الذوق الفني لتقرأ في هذه الكتب المقدسة، ولتجد في هذه القراءة لذة ومتعة وجمالاً، بل ليس من الضروري، ولا من المحتوم أن تقرأ هذه الكتب المقدسة، مدفوعاً إلى القراءة فيها بهذا الشعور الديني؛ بل تستطيع أن تنظر في هذه الكتب نظرة خصبة منتجة، وإن لم تكن مؤمناً ولا دياناً، ففي هذه الكتب جمال فني يتحدث إلى العقل الإنساني، وإلى القلب الإنساني، أحاديث تلائم ما اكتنفنا من الأطوار المختلفة والظروف المتباينة. لا يتعلق الأمر هاهنا بتذكر حالة الفقدان أو استرجاع ذكرى تقليدية لأن الشخصية الثقافية والفكرية ليست حكراً على فرقة من الناس تزعم أنها الداعية والفاهمة والعارفة والمكلفة بالنصح والأحكام؛ الأمر الذي دعمته الانكسارات الحاصلة في بلدان العالم الثالث التي ما إن حققت استقلالاتها والتي جاءت بشكل مؤسف، في الكثير من نماذجها، بدكتاتوريات مختلفة في كل شيء حتى في أشكالها القمعية فأجبرت هذه المجتمعات الناشئة على نسيان موروثها الثوري والتفتح على آفاق المستقبل، كما هو في فكر فرانز فانون، إن المشكلة في قانون الثورات، أن الأكثر تنظيماً هو الذي يحوّلها نحو أو يغير مساراتها الجوهرية -كما فعل المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين في مصر- بل وقد يدفع بها نحو المزيد من الانغلاق والتآكل الداخليين، فرأينا كيف أن القوى الثورية تنزاح للخلف ويتهمش دورها ويتقزم وتتلاشى التجارب والخبرات في مهب ريح التخلف والرغبة في الجمود. فما قيمة التراكم إذن إذا لم يتحول إلى قوة دافعة للأمام؟ لكن نكران الإحسان أصبح دليلاً على فساد طبيعة الإنسان، حتى أصبحنا نرى صنوفاً مجهولة السبب للتمرد وأنواعاً من نكران الإحسان ترتقي إلى مستوى الانتقام من صاحب الإحسان بدل الاعتراف له بالإحسان! هذا عجيب في البداية لكن الكاتب إبراهيم الكوني يتأمل التجربة فيراها طبيعية أقرب لروح الصفقة، فمن وجهة نظر المحسن إليه (الجموع اللاهية من الأقلية المضطهدة) يبدو الإحسان وثيقة عهد ينال هو بموجبها هبة دنيوية يراها هيّنة حتى لو كانت كنزا أو تحريرا لرقبة من غلّ عبودية إذا قيست بالمقابل الذي سيكسبه صاحب الإنسان “الثوري” وقد يكمن سر المفارقة الإحسانية في تأويل هذا المقابل الملفوف بالستور، وعندما يفترض حكيم مثل “سيكا” وجود عزاء لصاحب الإحسان في الارتياح الغامض الذي يشعره المحسن يغنيه عن اعتراف المحسن إليه بالإحسان فإن حكيماً آخر هو “إمرسون” يفترض العكس عندما يتحدث عن استحقاق صاحب الإحسان للصفعة من يد المحسن إليه مقابل إحسانه. وهو جدل لن يجدي في إماطة اللثام عن المقابل الذي لا يستعير غموضه من بُعده الوجودي بقدر ما يستعيره من طبيعتها الدينية.
كان لزاماً للقبضة المتزمّتة أن تعادي كل فكر ليبرالي تحرّري، على الرغم من أن العلمانية ليست موقفاً عقيداً من الدين، بل هي موقف من النظام السياسي في المجتمع، ولا علاقة له بالإيمان قلّ أو كثر
قال نيتشة في “هكذا تكلم زرادشت”: من يهب دوماً مهدد بأن يفقد الحياء – صاحب الإحسان – الثوري – الحامي – التنويري- يريد أن يدفع بإحسانه إتاوة تكفّر عنه آلام السهر والبحث التي تسري في الروح سريان الدم في البدن؛ والمحسن إليه -الأقلية المقهورة والأغلبية الصامتة- ليس في حاجة للاستعانة بالحدس لكي يدرك محنة الشريك فيستنكر الاعتراف بإحسان صاحب الإحسان، لأنه على يقين بأنه هو من حرّر، بأنه هو أيضاً من تحرّر! هذا الكلام ينطبق بحذافيره على نظرة الأوصياء على الأديان في المجتمع الحديث الذي تحرر على يد غيرهم، وهم في الغالب من القوى اليسارية الليبرالية -ويفترض المتأسلمون أن هذا نصر الله المبين!- ثم تأتي دعواهم بأن الحق والعدالة لن يأتيا إلا بإحياء العصر الذهبي للإسلام. ولكن ما هو العصر الذهبي هذا؟ ومتى كان؟
لقد مضى على الدولة الإسلامية حوالي ألف وأربعمئة وثلاثة وثلاثون عاماً وباستثناء فترة الخلافة الرشيدة كان حال المسلمين كما هو ثابت في التاريخ والتراث من أسوأ ما يكون، حتى مسألة تطبيق الشريعة لم تحدث كما يجب إلا في عهد الخلفاء الراشدين بالنص والروح. روى مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا فُتحت عليكم خزائن فارس والروم، أيّ قوم أنتم؟ قال عبدالرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: بل تتنافسون وتتحاسدون، ثم تتدابرون وتتباغضون، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض” وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا مشت أمتي المُطيطى (مشية التبختر)، وخدَمتها أبناء الملوك فارس والروم سُلط شرارها على خيارها” وهذا ما تنبأ به الرسول الكريم فأفلت الزمام من أيدي المؤمنين وضاعت الخلافة بعد ثلاثين عاماً من قيامها ثم صار الحال كما عرفنا. وكتب الشيخ الجليل محمد الغزالي في “الإسلام والاستبداد والسياسي”: وبعد أن كان حُكام الإسلام أعرف الناس به وأفقهم فيه وأحناهم على أهله أصبح أكثرهم حثالة تافهة تضُر ولا تنفع، وتفسد ولا تصلح. والرسالات الكبرى في الأرض، دينية أو مدنية، لا يحسن القيام عليها إلا عباقرتها وفلاسفتها، ولذلك كان انتقال الخلافة الإسلامية من أيدي الأكفاء النابهين من أولي السبق والكفاية إلى أيدي نفر مغمورين في دينهم وعقلهم حدثاً جلياً في تاريخ الإسلام، ولولا الملابسات التي صحبت هذا الانهيار في الأداة الحاكمة لوقف سير الإسلام كرسالة عامة. ومن هذه الملابسات أن كثيراً من ذوي الفضل، رأوا أن يعترفوا بالأمر الواقع، وأن يخدموا الدين في ظله قدر ما تواتيهم الفرص، فسلموا للولاة المتغيبين وتعهدوا للمجتمع بما يمكنهم من الإصلاح.
لقد تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، واحتكرت زعامة المسلمين أسر معينة، في العهد الأموي، فضعف إحساس الأمة بأنها مصدر السلطة، وأن أميرها نائب منها أو أجير لديها، وأصبح الحاكم الفرد هو السيد مطلق النفوذ، والناس أتباع إشارته؛ ترى الناس إن سرنا يسيرون حولنا/وإن نحن أومأنا إلى الناس ركضوا! وتولى الخلافة رجال ميتّو الضمير وشباب سفهاء، جريئون على معصية الله واقتراف الإثم، وليس لثقافتهم الإسلامية قيمة. ثم اتساع نطاق المصروفات الخاصة للحاكم وبطانته ومتملّقيه، وتحمّل هذه المغارم بيت مال المسلمين وأثّر هذا السرّف الحرام على حاجات الفقراء ومصالح الأمة، وعادت عصبية الجاهلية التي هدمها الإسلام، فانقسم العرب قبائل متفاخرة، ووقعت الضغائن بين العرب والفرس وغيرهم من الأجناس التي دخلت الإسلام قبلاً، وكان الحاكم المستبد يثير هذه النزعات الضالة، ضارباً بعضها بالبعض ومنتصراً بإحداها على الأخرى؛ حتى هانت قيم الخلق والتقوى بعدما تولى رئاسة الدولة غلمان ماجنون، وبعدها لُعن السابقون الأولون على المنابر، حتى إن شاعراً مسيحياً مدح يزيد بن معاوية فقال: ذهبت قريش بالسماحة والندى/واللؤم تحت عمائم الأنصار! وابتذلت حقوق الأفراد وحرياتهم على أيدي الولاة المناصرين للملك العضوض، فاسترخص القتل والسجن! حتى يروي الترمذي عن هشام بن حسان قال: أحصى ما قتل الحجاج صبراً فوجد مئة ألف وعشرين ألفاً!”. وروى البخاري عن سعد بن المُسيب: لما وقعت الفتنة الأولى -أي مقتل عثمان- لم تبق من أصحاب بدر أحداً، ثم وقعت الفتنة الثانية -أي الحرة- فلم تبق من أصحاب الحُديبية أحداً، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طَباخ (أي فقدوا قوتهم). والواقع أن الهزة التي أصابت الإسلام من هذه الفتن المترادفة كانت من العنف بحيث لو أصابت دعوة أخرى لهدمتها، ولكن معدن الدين وتماسك العلماء والجماهير حوله أمكن من اجتياز هذه الأزمات العصيبة وهو سالم معافى ثم يستأنف سيره في العصور من جديد.
السلفية الأصولية لا تنظر إلى العراء مثلاً إلا من زاوية الأخلاق أو من زاوية الحقيقة الأخلاقية، ولا تذهب إلى الفن باعتباره حقيقة أخرى، تعيد النظر إلى الأشياء كما تعيد النظر في الأجسام
وكان لزاماً للقبضة المتزمّتة أن تعادي كل فكر ليبرالي تحرّري، على الرغم من أن العلمانية ليست موقفاً عقيداً من الدين، بل هي موقف من النظام السياسي في المجتمع، ولا علاقة له بالإيمان قلّ أو كثر أو حتى انتفى تماماً، إنه موقف من نظام الحياة ووضع المجتمع وقوانين الدولة، ومن علاقة الدين بالدولة، لهذا لا يمنع أن أكون مؤمناً وأصوم وأصلي وأراعي تأدية الفروض وأشجعها، لكن يبقى لديّ موقف علماني من السياسة أو من نظام الدولة، وعليه لا ينبغي أن يؤدي تعبير ديني ومدني، وإسلامي وعلماني إلى تشويش على صلب القضية، فهي تعبيرات مجحفة لا تخلو من عمومية تنحرف كثيراً عن التوصيف الرقيق للرجال وللمواقف.
فكلمة ديني تعني أن العلماني لا إيمان له، وكلمة مدني تعني أن الإسلام بلا مواقف من قضية المجتمع وأركان الدولة وكلاهما غير صحيح، وماذا عن الفضائل الإسلامية والفرق العلمانية التي تختلف فيما بينها في الكثير من الأيديولوجيات والمناهج والأهداف رغم العناوين العامة والشعارات. وعندما نزلت هذه الاصطلاحات إلى رجل الشارع وحديث المقهى والندوات العامة صارت “إسلامي”! ما تعبر عن إلهي لا يخطئ أو هو متزمت مثير للملل والجمود، وكانت “علماني” تشير إلى ملحد منحرف يدعو للضلال، فصارت شُبهة!
وهكذا! فبدلاً من التحاور والتلاقي وتوحيد القوى ولو اختلفت الأفكار، نجد أننا أضعنا نصف الوقت وأغلب الجهد وكل المرض في محاولات عقيمة يثبت فيها كل واحد أنه ليس أقل من الآخر إيماناً! فلا بد من البحث عن طريقة لإعادة التعهد بالموقف الثابت الموحد، والذي لم يكن في الحقيقة سوى تكرار بديهية كان من المفروض ألا تخضع للجدال. فالحق في المساواة بين الطرفين المكمّلين بالضرورة لبعضهما البعض هو حق طبيعي لكليهما وللمجتمع والفكر، على الرغم من أن التاريخ يسرد لنا وقائع تقول بأن افتئات حق طرف على طرف كان في مناطق بعينها وأزمنة أخرى معكوساً. فلا وجود لحقيقة واحدة في دنيا الفكر وهذا مثلاً ما وقع فيه أفلاطون عندما طرد الشعراء من مدينته الفاضلة، لأنه كما قال أحد المفكرين المعاصرين، ممن طالتهم يد التكفير؛ مشكلة أفلاطون أنه جعل من الحقيقة الفلسفية معياراً للحكم على الشعر فطرد الشعراء من جمهوريته. فهو لم يوسع من معنى الحقيقة أو من تجلياتها المختلفة، فهناك الحقيقة الفلسفية والحقيقة الاجتماعية والحقيقة السياسية والحقيقة الثقافية.
هذا الفكر النائم -بتعبير نيتشة- أن نكتفي باختزال الحقيقة فيما يأتي من الدين، أو من الفلسفة، فهذا يعني إقصاء غيرها من الحقائق، والاكتفاء بالرؤية المغلقة العمياء، التي لا تغير نظرها إلى الأمور. وكما جاء في نص صلاح بو سريف “مرآة أفلاطون”: مصادرة الحقيقة باسم حقيقة أخرى هو نوع من السلفية الأصولية، أو هي تكريس لفكر التحريم والمنع، ورفض للاختلاف والنقد. حين لجأ أفلاطون إلى أرسطوفان، وهو طريح الفراش، فلأنه لم يعد يجد، ربما في زمنه من ينتقد، أو من يعيد تخيّل الواقع، بنفس السخرية التي كان أرسطوفان، ينتقد بها هذا الواقع، أو يعيد تشكيله، وفق منظور جديد، ليس هو المنظور الذي كان الفكر اليوناني غرق فيه. فأرسطوفان، بالنسبة إلى أفلاطون، في هذا الوضع، هو حقيقة أخرى، كان أفلاطون نسي في لحظة سابقة أن يُسبغها على الشعر، ما جعله في فخ التحريم والإقصاء. كما حدث مع الشعر، والفكر، يحدث اليوم مع الفن والرسم والنحت والرقص والتمثيل، ومع الآثار التاريخية القديمة.
السلفية الأصولية لا تنظر إلى العراء مثلاً إلا من زاوية الأخلاق أو من زاوية الحقيقة الأخلاقية، ولا تذهب إلى الفن باعتباره حقيقة أخرى، تعيد النظر إلى الأشياء كما تعيد النظر في الأجسام، لأن الفن لم يكن أخلاقاً بالمعنى الديني السلفي، فهو كان دائماً أخلاقاً في سياق فني جمالي، يعين ترتيب الأوضاع وفق منظور يكون فيه العراء نوعاً من النقد لهذا الاحتجاب الذي صار قهراً لمعنى الطبيعة ولمعنى الإنسان، الذي هو في حاجة إلى اختيار بدايته، أعني بداية خلقه التي كانت عراء في أصلها. أليس العراء نقداً لفداحة هذا التخفي الذي يريد الفكر الماضوي السلفي أن يفرضه علينا؟ أليست شدة الاحتجاب هي دعوة إلى العراء أو هي بالأحرى شدة عراء؟
يقول د. سعدالدين إبراهيم أنه في أوائل السبعينات أفرج الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن بقية المسجونين والمعتقلين من الإخوان المسلمين، وأعطاهم الضوء الأخضر لكي ينشطوا سياسياً، وبصفة خاصة في الجامعات المصرية التي كان يسيطر على العمل السياسي فيها حينئذ اليساريون والناصريون المناوئون لنظام السادات، ونمت التيارات الإسلامية في مصر باطّراد منذ ذلك الحين، وبدأت تشكل ظاهرة اجتماعية سياسية واقتصادية وثقافية متصاعدة. وقد أفلتت من قبضة أجهزة الدولة ورعايتها، خصوصاً عندما انحرف مسار الدولة بنسبة كبيرة عن المشروع الإسلامي والوطني، من خلال توقيع معاهدة الصلح مع الصهاينة. هذا الرأي الذي أكده الرئيس المخلوع مبارك عندما قال في حديث لمجلة دير شبيجل الألمانية أن الرئيس السادات شجع تكوين الجامعات الإسلامية بهدف مقاومة التيار الشيوعي في مصر، فرعى التطرف الديني وجعله ينمو في ظله. وظلت فصائل الإسلام السياسي تتفرع منذ بداية السبعينات لمواجهة النظام اليساري الناصري. لقد قررت أن الدولة العليا في حيثيات حكمها بقضية “الجهاد” المعروفة: ظلت سلطات الأمن غافلة عن نشاط التنظيم والذي بدأ في صيف 1980 بدعوة الشباب الانضمام إليه ووضع الخطط وجمع المعلومات وارتكاب حوادث النهب والسرقة وشراء الأسلحة وتخزينها، وتدريب أعضائها على استعمال الأسلحة، ورغم أن التنظيم قد كثف نشاطه بعد 2 سبتمبر 1981 متمثلاً في عقد اجتماعات بين قيادته، وانتقالهم بين محافظات الوجه القبلي والقاهرة والجيزة وتكثيف نشاطهم في التدريب على السلاح، فإن سلطات الأمن بما لها من سلطة الضبطية الإدارية، وهي اتخاذ الإجراءات المانعة من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام، لم تتخذ أي إجراء جد،. أي كشف هذا التنظيم وتحركاته قبل أن يبدأ في تحقيق أهدافه. هذه الحسابات الحمقاء للموازنة بين الإسلام السياسي والتيار اليساري، تحاول أن ترهب هذا بذاك، واحتواء أحد التيارين بالآخر، بل إن السادات اقترح شعار “العلم والإيمان” ليغازل الإسلاميين وليكتسب جماهيرية بين جموع الشعب الشغوف بمظاهر التدين الزائف. وفيما بعد راقته لعبة استخدام الجماعات الإسلامية لدرجة أنه بدأ يستخدم هذه الجماعات بعضها ضد بعضها الآخر.

لوحة: فادي يازجي
وفي كتابه “ذكرياتي مع جماعة الإخوان المسلمين” يروي قطب الجماعة عبدالرحمن أبوالخير أنه بعد أحداث الكلية الفنية العسكرية عام 1974 عقد اجتماع لقادة المسلمين أو ما يسمى إعلامياً “التكفير والهجرة” وعرضت الحكومة رغبتها في التعاون معها على أساس أن الجماعة تصرف الشباب عن المناهج الانقلابية وتدعو إلى الهجرة. لأن الحكومة في حاجة إلى إسلامية تستوعب الخاصة من الشباب، ثم إلى جماعة تستوعب العامة من الناس، وفي مقابل صرف الشباب عن الانقلابات يطلق الطاغوت أيديهم في العمل للإسلام بحرية غير منتهيين -أو يظنون أنه وضع مؤقت- أنهم دمى في يده؛ فالحكومة قدمت هذا العرض وتعلم تماماً أن منهج الجماعة لا يصطدم بمنهج الهجرة وخطتها الحالية، ويصرف الشباب عن التجمعات ذات المناهج الانقلابية شأن تنظيم الفنية العسكرية. يقولون للطاغوت إنهم لا يشكلون عقبة في طريقه، فحجبهم للنساء عن الجامعات والمدارس يعني أنهم يقولون له، ها نحن ذا نريحك من مشاكل تعليمهن وانتقالاتهم، وهجرتي لا تشكل خطراً انقلابياً عليك، وأسهم بذلك في تخفيف مشاكل الإسكان وأترك الوظائف فأريحك من المرتبات التي تدفع لنا. فكانت الهجرة على النحو التالي: هاجر بعض أعضاء الجماعة الإسلامية إلى السعودية واليمن وجبال المنيا بدعوى إقامة مجتمع إسلامي نقي في الهواء الطلق باستصلاح الأرض والعيش على رعي الغنم. هذه هي دائماً اليوتوبيا التي يريدون للأجيال الجديدة أن تحلم بها بينما كبارهم يرفلون في الحرير وينعمون بالنساء وأسطول السيارات، حتى العام 1977 عندما بدأت جماعة الإسلاميين في اللجوء للعنف عندما اختطفت الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف، فانتبهت الحكومة إلى أن الجماعة صارت ذات أنياب، وظهر في هذا الوقت كتاب “الفريضة الغائبة” عام 1979 لمؤلفه محمد عبدالسلام فرج ليعلن أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف، فكان هذا إيذاناً ببدء العنف بشكل رسمي ومنهجي.
وخرج منشور سري بعنوان “ميثاق العمل الإسلامي” كمعاهدة شرف ومنهج عمل وخارطة طريق جاء فيه أن الجماعة المسلمة ترفض الرياء والركون وتستوعب ما سبقها من تجارب، وذلك في إشارة واضحة من جماعة التكفير والهجرة لمعاداة الإخوان ورفض مداهناتهم للدولة والمساومات التي تجري بينهم، وكذا رفضت جماعة الجهاد هذا الأسلوب الذي دأبت الدولة والنظام على إتباعه دون ملل وبثقة كبيرة بمبدأ فرق تسد واستخدام جماعة ضد أخرى، وإطلاق حرية الحركة لإحدى الجماعات لتحجيم حركة الجماعات الأكثر تطرفاً وعنفاً في طريقة التعامل مع النظام. وهو نفس أسلوب السادات الذي أثبت فشله. ومن جهة أخرى كانت الدولة تعمل جاهدة على تشويه صورة الجماعات كافة على المستوى الجماهيري الإعلامي؛ فكانت الصحف الرسمية وقنوات التلفاز وموجات الإذاعة تعادي فكر الجماعات بشكل صريح، ويسمح الإعلام وجهاز الصحافة حتى للمعارضة بحرية الفكر والعمل ما داموا في نفس الصف، عملاً بمبدأ عدوّ عدوي صديقي، وكانت مواءمة ناجحة جداً، نراها بشكل واضح في حالة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي كان مسموحاً له نقد الحزب الوطني والظلم الاجتماعي والشخصيات العامة الكبيرة بدءاً من كبار موظفي الدولة وحتى الوزراء، وحتى رئيس الجمهورية في مقابل أنه أيضاً يفضح الجانب الدموي المادي للجماعات الإسلامية؛ هذا المنهج الذي بدأ بدعم من كتاب ومفكرين محسوبين على التيار اليساري (لعبة السادات معكوسة) بشن حملة شرسة ضدهم أضرها كثيراً التضخيم والمبالغة في شكليات معينة دون معالجة فكرية للدوافع والجذور الحقيقية لغول الجماعات، هذه المبالغات التي يستغلها أصحاب الجماعات في دعوى أن النظام يصوّرهم ببشاعة ويظهرهم كفزاعة. ضمن هذه المبالغات كانت المقاربات المستمرة بتشبيه الحركات الإسلامية السنية بالحركة الإيرانية الشيعية، وتخويف الجمهور من أن هذه الجماعات سوف تؤدي بنا إلى صورة أخرى من إيران، والواقع أن هذه الصورة كان يخشاها النظام الذي يرتعب من فكرة أن يلقى ذات مصير الشاه الإيراني، ولكنهم –إعلامياً- يحرّكون كوامن الفزع بصورة مستقبلية للحكم الإسلامي في مصر تنفّذ فيه الحدود من قطع يد وجلد وتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان. مثال على ذلك مقال كتبه حسين أحمد أمين في مؤلفه “الإسلام في عالم متغير” تحت عنوان “البيان العاشر لقائد الثورة الإسلامية” يتوقع فيه قيام ثورة في مصر، يلقي قائدها بهذا البيان بعد شهور قليلة من قيامها يتحدث فيه عن تنفيذ حكم الإعدام قائلاً ” لقد أفلحنا بتوفيق من الله وفضله أن نستأصل في الأسابيع الأولى شأفة العلمانيين والدنيويين، ورؤساء أهل الذمة والفنانين والملاحدة والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين والوفديين وغيرهم من أتباع المذاهب الضالة فاسترحنا لذلك وأرحنا”. ثم يتحدث عن وجود شقاق في مجلس قيادة الثورة “أعلم علم اليقين أن أفراداً منكم قد شرعوا يتهامسون فيما بينهم بأن تصدعاً قد طرأ على قيادة الثورة الإسلامية المباركة، وبأن الخلاف والشقاق قد دبّا بين أفرادها، وذلك لمجرد أننا قمنا خلال الأسبوع الفائت بإعدام حفنة من المارقين، والعُصاة في هذه القيادات، في حين أن عددهم لا يتجاوز ألفين وثمانمئة في جميع محافظات القطر. ثم يقول رداً على خبر إعدام الرئيس نفسه “إن بيننا وبينه خلافاً كبيراً، وأن ذلك الخلاف يرجع إلى موضوعات حيوية شتى هي لصيقة بجوهر الدين ومن أركانه، فقد أفتى هذا الفاسق المبتدع، خلال الأسابيع الأخيرة من حياته، بأن صبغة اليود لا تنقض الوضوء، وبأن ظاهر قدم المرأة ليس بعورة، وبأن اقتناء الصور الشمسية لآدميين لا غبار عليه”. هذا الشكل الإرهابي العنيف لا يبعد كثيراً عن أن يكون هو المستقبل الحقيقي المنتظر في ظل حكم الجماعات الإسلامية. هذا الكلام موثق بشكل جيد في كتاب د. أحمد جلال عز الدين “الإرهاب والعنف السياسي” فقد رصد 794 عملية إرهابية دولية وقع ضحيتها 954 شخصاً، وقع 43 بالمئة منها في دول أوروبا الغربية، ووقع في أميركا اللاتينية 22 بالمئة منها، و15 بالمئة في الشرق الأوسط، و6 بالمئة في الولايات المتحدة. وشملت العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط حرب العراق -إيران، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والحرب الأهلية في لبنان، وصار من الشائع أن تبدأ نشرة الأخبار بخبر يقول “قام ملتحون يرتدون ملابس قصيرة تشبه الزى الرسمي الباكستاني بتفجير كذا … الخ”، فيما أشار إليه فيما بعد الكاتب الكبير فهمي هويدي بمقال “التفسير الأصولي للأزمات” أورد فيه أن عام 1988 شهد تأسيس مدرسة متكاملة في الخطاب والتفكير يمكن أن نطلق عليها مدرسة التفسير الأصولي لأزمات التاريخ، تقدم على عقيدة ثابتة مفادها أن الإسلاميين هم أساس كل شرّ ومصدر كل بلاء وغم وكرب، وهذا المنهج ليس جديداً، ولكن تأسيس المدرسة وتجميع رموزها، ونشر فروعها في الداخل والخارج هو الإنجاز الذي تم بوضوح هذا العام، ويتصل بذلك أيضاً أن كفاءة العمل قد تحسنت كثيراً بحيث بات الحدث يقع في الجزائر مثلاً في الصباح، فتسمع تفسيره ‘الأصولي’ بعد الظهر في إذاعتي مونت كارلو ولندن”، ويقرأ تحليلاً موسعاً له في القاهرة على ذات الموجة خلال أيام قليلة، “الشاهد على ذلك: قضية الحل والحرمة في الغناء التي رافقت أحداث أسيوط عام 1988، والتي حاولت فيها بعض المجلات آنذاك وصفها بأنها اغتيال الوجدان المصري”، وتم اغتيال أحد القساوسة في أسيوط فتحدث راديو لندن عن الأصوليين الذين ارتكبوا الجريمة، وأنهم أربعة ملثمين ملتحين شوهدوا يفرون بعد الحادث، ثم تبين من التحقيق أن القاتل رجل مسيحي لا هو متطرف ولا هو مسلم أصلا، والمشكلة أسرية بين القاتل وزوجته، أيد فيها القسيس موقف الزوجة، فانتقم منه الزوج، لكن السمعة التي نالتها الجماعة الإسلامية جعلت الأمر يبدو ملصقاً بها.
ثم ظهور أزمة الدولار، التي وصفها أحد الكتاب بأنها من صنع الإسلاميين الذين يهدفون إلى تقويض النظام الاقتصادي. والكل يذكر حلقات مسلسل الريان. وزيادة على تأكيد قوائم مدرسة الإرهاب الأصولي التي كان من أهم نتائجها عمليات الاغتيال لأعضاء في الحركات الإسلامية في عهد وزير الداخلية السابق اللواء زكي بدر، وأورد تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان (1991) أن المنظمة تلقت على مدى العام مزيداً من التقارير والشكاوى بشأن حملات القبض العشوائي والاعتقال تركز معظمها في أوساط المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإسلامية، وفي حالات كثيرة استمر احتجاز الأشخاص الذين طالتهم هذه الحملات رغم صدور قرارات من النيابة بإخلاء سبيلهم، كما استمرت الشكاوى من رفض وزير الداخلية الإفراج عن أعداد من المعتقلين رغم حصولهم على أحكام نهائية بالإفراج عنهم، وفي حالات عديدة تحايلت وزارة الداخلية على هذه الأحكام بإصدار أوامر باعتقال جديدة، كما شملت إجراءات القبض والاعتقال أعدادا كبيرة من الفلسطينيين وبعض الجنسيات العربية الأخرى، وبصفة خاصة في أعقاب أزمة الخليج، وحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، كما طالت هذه الإجراءات مئات من المواطنين الذين ألقي القبض عليهم بعد اضطرابات شهدتها مناطق عديدة في أعقاب إعلان نتائج مجلس الشعب.
في الختام تبقى شهادة ماركسي قديم هو شريف حتاتة “إننا في حاجة إلى تحالف شعبي يقيم سلطته معتمدا على الجماهير، يُحاصر الأعداء ويشلّ إرادتهم، يُعيد بناء المجتمع ونظام الحكم بالنضال الديمقراطي الصبور الذي يدحض المصاعب ويبدد أصوات اليأس. وكل هذا يحتاج إلى صُنع ثقافة جديدة ملمّة بالعصر تتعلّم منه وتغيّره وتطرد ما عفا عليه الزمن في القيم والفكر. وتبني على ما هو إيجابي في تراثنا. إنها مهمة صعبة تحتاج إلى أن يغيّر المثقفون من أنفسهم لكن كم هو جميل أن نسعى خطوة بعد خطوة من أجل تحقيقها”.




