مدن الاستعارة.. جدلية الوهم والواقع في رواية\'خان الشّابندر\'

هذه رواية لا تهب قارئها برد اليقين ولا تسعى أن تعلّمه، وليس من همّها أنّ تصف له العالم وأن تخبره بما جرى ويجري وسيجري. إنّها تقول الحقيقة من حيث هي تنبو عن قول الحقيقة، وتعدل عن نقل المتكرّر من الأحكام، وتنفر من التذكير بالسلسلة المغلقة الكئيبة من البديهيّات.. الحقيقة التي تقولها ضفائر من الأوهام، والوهم الذي تسرده حقائق متناثرة مشتّتة تحنّ إلى وحدتها، والقراءة الصبورة الجسورة هي المالكة رباط تلك الوحدة.
ولا تغرنّ القارئ كثرة إحالات الرواية على العالم المرجعيّ، وانشدادها إلى رسن الواقع، وامتلاؤها بأصداء صاخبة من الأحداث التي هزّت العراق بعد 2003، واحتشاد صفحات الرواية بأسماء حارات بغداد وشوارعها وأحيائها القديمة، فما كلّ ذلك إلاّ محض إيهام بسير “خان الشّابندر” على نهج سائر الروايات في مشاكلة الواقع وإيهام بعدم الإيهام.
إنّ بغداد في الرواية هي بغداد العراق، أعرق مدن العالم وأثراها وأبهاها، ولكنّها أكثر من بغداد العاصمة العراقيّة التي دمّرها الغزاة وأعظم امتدادا دلاليّا وأثرى أبعادا، وشخصيّات الرواية: الراوي الصحفي علي موحان العائد إلى العراق بعد غياب دام خمسة وعشرين عاما، ومومسات دار أم صبيح، والشيخ مجر، وسالم الصديق القديم الذي نفذ فيه حكم الإعدام منذ عقدين ونصف، ونيـﭬين الصحفية، وزينب الطفلة الصغيرة بائعة الكعك، هي شخصيات بشرية ولا شكّ أو قل هي تذكرنا بالبشر وبالعراقيين تحديدا، ولكنّها أكثر من ذلك وأبعد غورا، والطينة التي خلقت منها ليست طينة البشر.
إنّ هؤلاء البشر الذين يتحركون في الرواية هم أيضا كائنات تتوزعها الحقيقة والوهم، فننزع حينا إلى أن نعاملهم على أنّهم تجسيد للبشر، ونثوب حينا آخر إلى رشدنا فنجد دعوة في النفس إلى ألاّ نرى في تلك الشخصيّات وتلك المصائر والآلام التي ارتبطت بها غير تخاييل وأوهام.
لكنّ القارئ في كلّ الأحوال لا يملك أن يحسم أمره ويجزم إن كان ما يقرؤه ابن الحقيقة أو شقيق الوهم، ويظلّ طيلة القراءة موزعا بين هذا الحدّ وذاك، وقد تعتريه أثناء ذلك الرغبة في أن ينقطع عن القراءة وينفلت من دوائر المتاهة. ولكن أنّى له ذلك؟ فهذه الرواية تسدّ على المرء متى شرع في قراءتها كلّ المنافذ وتجبره على ألا يتركها إلاّ وقد أتمّها.
وهم أم واقع
يصرّ راوي “خان الشّابندر” طيلة الرواية من مفتتحها إلى صفحتها الأخيرة، على أن يتركنا في بهتة من أمرنا لا نتبيّن الخيط الأبيض الفاصل بين الوهم والواقع، وبين الحلم واليقظة، وكثيرا ما كنا شهودا على انبلاج الواقع من الوهم وتفتّق اليقظة على الحلم، فلا مجاز بين هذه الأضداد ولا افتراق بل بينها وحدة واتصال لا يكون به أحدها إلاّ بالآخر. أمّا القارئ فما نصيبه إلاّ الحيرة والعجز عن الإقرار برجحان مّا لهذا الجانب على حساب الجانب الآخر. فكأنّ القراءة سير فوق حقل من الألغام المخفيّة أحسن إخفاء، لا ندري أين مكمنها ولا أيّان تكلّمها.
فقد حفلت الرواية بسياقات قوليّة كثيرة أشارت فيها الشخصيّات لماحا حينا وتصريحا حينا آخر إلى ما يلتبس شخصيّة الراوي البطل وأفعاله وما حدث له في بغداد من توهّم ومفارقة للواقع. فهذه نيـﭬين صديقة الراوي وزميلته الصحفيّة التي طلب منها أصدقاء الراوي أن تعتني به طول مدّة إقامته في بغداد وهو القادم إليها من بلد أوروبيّ، لا تصدّق ما رواه لها عن لقائه في بغداد القديمة ليلا صديقا قديما لهما يدعى سالم محمّد حسين الذي أنقذه من المتاهة ووفّر له غرفة فوق السطوح بات فيها ليلته.
وما كان استبعاد نيـﭬين لصحّة هذه الرواية وطعنها فيها إلى حدّ وصف الراوي بالجنون، إلاّ لأنّ سالم محمّد حسين هذا قد مات رميا بالرصاص مند سنوات طويلة “هل تتحدّث بجدّ!… ما بك؟ هل جننت؟ سالم مات منذ أكثر من خمس وعشرين سنة ألم يعدموه بالرصاص وقتها؟ وقد سارعت بتفسير ما يتراءى للراوي من خيالات بجولاته في الأماكن القديمة الخالية: لا… وضعك ليس طبيعيّا. أنت تخيفني حقا. لقد طلبت منك الكفّ عن تجوالك الغريب في تلك الأماكن المعزولة. أخبرتك أكثر من مرّة بأنّ المدينة تغيّرت. لقد تعبت. سأخبر أصدقاءك في الجريدة ليجدوا حلاّ، وأخلي مسؤوليتي”.
وقد ظلّت نيـﭬين محافظة على هذا الموقف التشكيكي إلى آخر الرواية، ميّالة إلى إدراج كلّ ما يرويه لها الراوي في باب التخيّل. وهكذا نجدها في آخر الرواية ترسم صورة أمّ زينب المتوفاة التي رأى الراوي صورة لها على قبرها، على هدي من وصفه لها. وحين تسأله لِمَ لَمْ يأخذ لها صورة رغم أنّه كان يحمل عندما وقف على قبرها كاميرا، أجابها إجابة لم تقنعها ورجّحت أنّ المسألة كلّها خيال “هل تعرف لماذا لم تلتقط الصور؟
لماذا؟
لأنّها ببساطة غير موجودة سوى في خيالك”.
ومن هذه الأقوال ما قاله أبوحسنين المصلّح، المصريّ الذي أبى مغادرة العراق بعد الاحتلال وظلّ في دكانه الصغير في إحدى حارات بغداد يصلح الأدوات المنزليّة، فقد ودّع الراوي بقوله “- أنت ما زلت تمشي على الأرض ولم تخض التجربة بعد.
أيّة تجربة تقصد يا أبا حسنين؟
لا يهمّ.. يوما مّا ستكتشفها بنفسك. لكن احذر! فأنت رجل تقوده أحلامه.. وهذا خطر في زماننا”.
وتعرّف هند نفسها بأنّها “مجرّد حلم من تلك الأحلام المنفلتة يا عيني. ماذا تظنّ”. وكانت هند إحدى العاهرات اللاتي تؤويهن أمّ صبيح في بيتها، التقاها الراوي لدى زيارته البيت ضمن من التقى من صبايا وقد برر الزيارة برغبته في إجراء دراسة حولهنّ، ولكنّ علاقته بها توطّدت وتمتّنت ولا ندري أهيّئ له أم هيّئ لنا أنّه اقترب منها وعاشرها وكان له معها سهرة فوق سطح البيت وتحليق في عالم الخيال و”الأحلام المنفلتة” كما يقول هو نفسه؟ لكنّها شجّعته على ألاّ يصدّق إلاّ أحلامه وأن لا يسير إلاّ وراء أحلامه وأشباحه “اسمع، انتصر لأحلامك وحسب. لا تدعني أقف في طريقك. لا تعر أدنى اهتمام لغوايتي. أوقد شموعك واستحضر أشباحك واجعلها ترقص لك وحدك. اشعر بالحقيقة في عظامك. جنونك الآسر هذا، لا تدعهم يحطّموه. أعطه مداه. لا تشحّ عليه. إنّه شغفك وأنت أعلم به. فاجلس وتنفّس بعمق، ودعني في هذه اللحظة أتأمّل قلقك الطفل ونظراتك المغرقة في الرغبة”.
وممّا لا شكّ فيه أنّ المكوّن الحدثيّ هو أكثر مكوّنات العالم الروائيّ تأثّرا بهذا الارتياب. فأغلب أحداث الرواية، والأحداث المفصليّة منها خاصّة، تحيط بها هالة من الغموض والتعمية والشكّ في أن تكون وقعت فعلا كما يدّعي الراوي لصديقته نيـﭬين. وممّا يدعم هذا الشكّ في الأحداث ويدفع إلى اعتبارها أوهاما إضافة إلى أقوال الشخصيّات ممّا رأينا آنفا، الأهميّة التي اكتساها فعل النوم في الرواية.
إنّ قوّة الإيحاء بوهميّة الأحداث في الرواية جعلتها تعيش طورين متداخلين: طور أوّل يأتي فيه سرد الحدث على لسان الراوي مثبتا محقّقا متجذّرا في عالم الواقع، وطور ثان تنصبّ فيه على الحدث سهام التشكيك إمّا بربطه بالنوم والحلم أو بتسليط أقوال تشكيكيّة من الشخصيّات تخرج به سريعا من الواقع إلى الوهم لكن دون أن يُحسم في الأمر ويُجزم، فإذا بنا نرتدّ من جديد إلى الواقع دون أن نطمئنّ إلى ذلك أيضا. وعلى هذا النحو فأحداث النصّ قائمة على ثنائيّتين متجاورتين متلاحقتين وكأنّهما دولاب لا ينفكّ عن الدوران، وهاتان الثنائيتان هما الواقع وطرد الواقع من جهة، والوهم وكسر الوهم من جهة أخرى.
وفي ما عدا الأحداث التي جرت للراوي في حضرة زميلته نيـﭬين وبدرجة أقلّ حدث جولته في بغداد القديمة في رفقة زينب وهي طفلة صغيرة التقاها صدفة وهي تحمل طبق كعك تتجه إلى بيعه للعابرين، فإنّ باقي أحداث الرواية لا ينفلت من هذا التقلّب الحادّ مزدوج الاتّجاه من الواقعيّ إلى الوهميّ.
لنأخذ الحدث الأهمّ في الرواية كلّها، حدث زيارة بيت أمّ صبيح. فقد افتتحت الرواية بزيارة الراوي الصحفي علي موحان صحبة صديق له بيت أم صبيح، وهو ماخور سريّ يقع في أعماق بغداد القديمة تديره أمّ صبيح ويضمّ مجموعة من الفتيات لكلّ منهنّ قصّتها وفاجعتها، ولكلّ منهنّ طريق أوصلتها إلى بيت أمّ صبيح. هذا الحدث يسرد علينا في البداية بطريقة انسيابيّة خطيّة فتبدو لنا الوظائف الحدثيّة الفرعيّة (وصول الراوي إلى الماخور، ومجالسته العاهرات، وحديثه معهنّ لا سيما هند، وحسن معاملة أمّ صبيح له، وخروجه من الماخور وقد أخذ الغروب يدلهمّ) ممكنة الوقوع، منطقية، مترابطة، بسيطة لم ترتبط بأيّ دلالة على المغامرة أو الخطورة.
ولذلك لا يجد القارئ أيّ حاجز يحول بينه وتصديقَ مشاكلة النصّ للواقع، فكلّ ما روي له يندرج في دائرة العوالم الممكنة. ولا يتأثر هذا اليقين لدى القارئ، حتّى عندما تعترض الراوي دوريّة من الشرطة وهو يخبط خبط عشواء لا يدري أيّ الطرق يسلك للخروج من متاهة المدينة العتيقة، ويأمره أحد رجال الشرطة بأن يعود من حيث أتى حفاظا على سلامته، وهناك في قلب المتاهة تحدث المعجزة ويلتقي بصديق له قديم لم يره مند خمس وعشرين سنة، ويصحبه هذا الصديق إلى غرفة فوق السطوح فيبيت فيها ليلته وفي الصباح لا يجد لصديقه أيّ أثر. ولكن منذ الفصل الثاني وإلى آخر الرواية لا ينفكّ هذا الحدث الرئيسي عن التقلّب بين حدّيْ ثنائيّة الوهم والواقع.
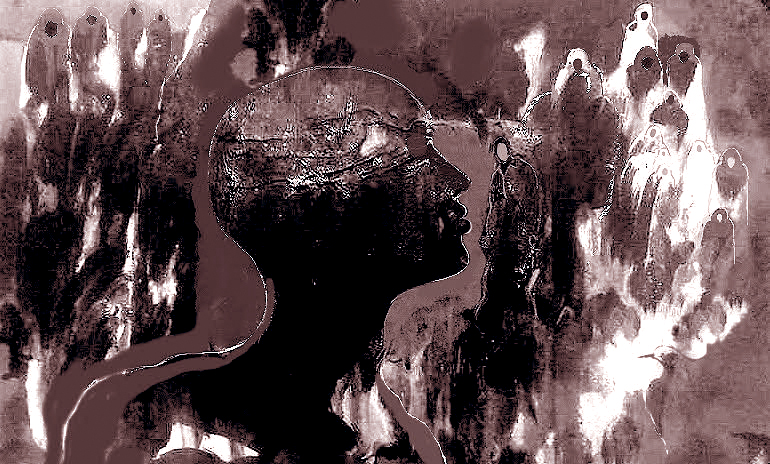
لوحة: كمال جبرالله
بدأ التشكيك في واقعيّة هذا الحدث من نفي نيـﭬين بحسم أن يكون الراوي التقى صديقه الذي آواه ليلا لأنّه قد نفذ فيه الإعدام رميا بالرصاص منذ خمسة وعشرين عاما. ووقف الراوي بنفسه على إمكان أن تكون زيارته بيت أمّ صبيح خيالا في خيال ومحض حلم، حين عاد إلى البيت ثانية محمّلا بالكتب التي طلبتها منه هند، فتاه ولم يجد سواء السبيل، وقد تطوّع الشيخ مجر ليدلّه على البيت لكنه لم يجد عندما وصلا إليه إلاّ بيتا مهدّما خربا تفوح حوله رائحة الموت والدمار.
بيد أنّنا نلتقي الراوي في الفصول اللاّحقة وقد عاد إلى بيت أمّ صبيح صحبة لوصة، إحدى عاهرات البيت، والتقى هندا ثانية وسقط عليه سقف وهو يهمّ بمغادرة البيت وسط القصف المتبادل بين جماعتين مسلّحتين، فأغمي عليه وتكفّلت الفتيات بتطبيبه والعناية به. وفي نهاية الرواية يعود الراوي من جديد إلى البيت صحبة نيـﭬين يريد أن يثبت لها أنّ روايته واقعيّة لا وهم فيها، فيتيه من جديد، ويهتدي إلى دكّان مجر فينفي هذا معرفته به ولقاءهما في بيت أمّ صبيح. وحين يصحبهما الشيخ مجر إلى البيت، يكتشفان هول ما لحقه من دمار رأياه في تراكم أكوام التراب وتهدّم الجدران وتهشّم الباب، بما ينبئ بأنّ الحياة قد فارقت هذا البيت منذ زمن طويل. ويستمع الراوي ونيـﭬين إلى حكاية أمّ صبيح وفتياتها ومقتلهنّ ذبحا على يد إحدى المجموعات المتشدّدة، وبقاء جثثهنّ مرميّة تحوم حولها القطط تريد أن تنهشها لولا أنّ مجر ظلّ مرابطا يحرسها، إلى أن جاءت أم غايب وجمعت رؤوس الفتيات في كيس.
هل كانت المدّة الزمنيّة القصيرة بين زيارة الراوي بيت أمّ صبيح في المرّة الثانية وعودته إليه مع نيـﭬين، كفيلة بأن تلحق به كلّ ذلك الخراب؟
هذا السؤال الذي خامر نيـﭬين وجعلها تسأل مجر عن التاريخ الذي وقعت فيه فاجعة الفتيات، ونيّتها أن تتثبّت في نصيب الوهم والحقيقة ممّا رواه لها علي موحان. فجاء جواب مجر ليزيد الالتباسَ التباسا والحيرةَ حيرة، إذ قال “الفتيات؟.. وما يهمّ؟… لقد حدث ذلك منذ زمن.. لا أدري.. عشر سنين ربّما؟.. ما الفرق؟”.
وبذلك ينضاف إلى الارتياب في المكان، الارتيابُ في الزمان، وإذا الوهم يشمل بعدي الوجود الأساسيين.
ذبح النساء
وتزداد حيرتنا حين نعود القهقرى بما يقارب خمسين صفحة فنستمع إلى هند تعرّف الراوي بمجر فتخبره بأنّه “عتيق جدّا، عمره أكثر من مئة عام، منذ وطأت قدماي منزل أمّ صبيح وهو يجوب الأرجاء ويعرف مفاتيح الأمور.. أسمع عنه الكثير من الحكايا الغريبة، لكنّه طيّب القلب، وفي أغلب الأحيان يبدو مثل ملاك حارس… حتّى أنّه حمى الرؤوس من القطط والطيور الجارحة مدّة طويلة قبل أن ترفعها أمّ غايب…”. فعن أيّ رؤوس تتحدّث هند والحال أنّ واقعة قتل فتيات أمّ صبيح لم تقع بعد بما أنّ هندا نفسها واحدة منهنّ؟ وأيّ رواية نصدّق إذن: رواية هند أم رواية مجر؟ أيّهما التقاه الراوي في الحلم وأيهما رآه رأي العين؟ أم لعلّ القصّة كلّها كما تؤمن بذلك نيـﭬين ليست إلاّ خيالا في خيال؟
نجد هذه الإجابة في حضّ بعض شخصيّات الرواية لا سيما أبوحسنين المصلّح ومجر بائع الأثاث العتيق، الراوي على خوض التجربة دون أن يعنى أيٌّ منهما بتحديد المقصود من كلمة “التجربة”. فأبوحسنين قال له “بصوت أقرب للهمس:
أنت ما زلت تمشي على الأرض ولم تخض التجربة بعد.
أيّة تجربة تقصد يا أبا حسنين؟
لا يهمّ.. يوما ما ستكتشفها بنفسك. لكن احذر! فأنت رجل تقوده أحلامه. وهذا خطر في زماننا”.
أمّا مجر فقال في آخر الرواية لنيـﭬين وكأنّه يوصيها خيرا بالراوي، راثيا له في الوقت نفسه “انتبهي له.. ما زال لم يخض التجربة على ما يبدو”.
أيّ تجربة هذه التي تحدّث عنها أبوحسنين ومجر متأكدين من أنّ الراوي لم يخض غمارها بعد؟ وكيف لهما أن يتحدّثا عنها مستعمليْن “الـ” التعريف الاستغراقيّة، مشيريْن بذلك ضمنيّا إلى أنّها تجربةٌ، معرِفةٌ، محدّدةٌ، مميّزةٌ لا نظير لها؟ وهل يمكن أن يحمل الرجلان وبينهما ما بينهما من الاختلافات، تصوّرا واحدا متطابقا لهذه التجربة؟
لا يسعفنا النصّ بإجابة واضحة بيّنة يمكن أن تضيء لنا بعض الخبايا، فننهي الرواية ونحن على ظمأ إلى تحديد مفهوم التجربة مثلنا في ذلك مثل الراوي علي موحان. بيد أنّه يمكننا ببعض التدقيق في السياقين اللذين نُبّه فيهما الراوي إلى عدم خوضه التجربة، أن نكتشف اقتران الحديث عن التجربة في المناسبتين بالحديث عن الموت وعن موت النساء تحديدا.
في المرّة الأولى، كان أبوحسنين يتحدّث عن حرصه كلّ ليلة على إشعال فوانيس معلّقة على جدران الحيّ. وما كان يفعل ذلك بحثا عن نور الكهرباء، بل استجلابا لأرواح الملائكة الهائمة في سماء المدينة، أرواح موتى الحرب والخراب العارم ومنها روح زوجته ريّا “لا أدري. فالمدينة تملؤها الملائكة، وأرواحهم الهائمة يجذبها النور، من يدري! ربّما أحظى ذات ليلة بروح ريّا! قالت لي مرّة، ستظلّ روحي تحوم حولك، لا تبتعد عنّا وأكثر من النور. فليس مثله ما يريح الأرواح اللاّئبة. فهو كالماء بالنسبة للأسماك والهواء للعصافير…”.
أيّ دليل أقوى على انتشار الخراب وموت الإنسان من ذبح النساء؟ لكنّ هذا الفعل الأقبح والأشرس والأغرق في الجنون فعل قديم كما بيّن مجر لنيـﭬين، يكاد لا يكون له تاريخ محدد لأنه فعل متصل لم ينقطع.
ولا يمكن أن يغيب عن القارئ الأبعاد الترميزية في صورة جثث الفتيات مرمية على الأرض مبتلة بالدم وسقوط المطر عليها يطهر شعورهن، ولعله يطهر بدمائهن المنسابة ما على الأرض من رجس. فهل يلزم أن تموت النساء ذبحا من حين إلى حين حتى تقدّم قرابين لآلهة الشر وتستعيد الحياة بعضا من رشدها؟ هل نساء بيت أم صبيح هنّ النسخة الحديثة التي ابتكرها محمد حياوي في روايته ابتعاثا للبغايا المقدسات في بابل القديمة؟
لقد قامت رواية “خان الشّابندر” على طرد الصفات الأخلاقية السلبية المسبقة العالقة بصفة آلية بالعاهرات، بانية لهنّ صفات أخرى إيجابية تتجاوز مدار الدفاع عن العاهرة بوصفها ضحية المجتمع، إلى مدار آخر مناقض تماما يتبدّى فيه ما تكتنزه العاهرة من سموّ روحي، وتطلع إلى الحياة، وقدرة على التأثير في الآخرين وقيادتهم وسط الخرائب إلى طريق السلام.
والناظر بصفة عامة في حضور النساء في الرواية، يكتشف بكل يسر تمجيد المؤلف للمرأة وانتصاره لها. فالنساء في الرواية بمختلف فئاتهن وأعمارهن هنّ الفاعلات المدافعات عن آخر آمال الحياة المتكفلات بإسعاد الآخرين وحمايتهم. فهذه نيـﭬين تعتني بالراوي وتؤازره وتحاول أن تساعده على الوصول إلى الحقيقة وتنقلب في آخر الرواية قائدة له في سيره وعينه التي يرى بها، وهذه أم صبيح تتحدى الميليشيات الدينية المسلحة وتناورهم وتحمي في بيتها بعضا من الفتيات اللاتي ظلمهن المجتمع، وهذه أم غايب ترعى بعض أطفال الشوارع وتكرم جثث الفتيات وتخاطر بأخذ رؤوسهن، وهذه زينب الطفلة اليتيمة الصغيرة تخلق من ذاتها امرأة ناضجة ترعى إخوتها الصغار وتجري كل صباح تسعى وراء رزقهم، وهذه إخلاص تنقذ الراوي من متاهته وتعلّمه أسرار خرائب بغداد، وهذه هند توقظ حواسه وتكشف له جوانب من الذات الإنسانية والوجود ما كان له بها معرفة، وهذه تعلّم الراوي طقوس التطهر في ماء النهر. أما رجال الرواية فبعضهم وحوش قتلة، وبعضهم هاجر وترك البلد هاربا، وفريق آخر ومنهم الراوي لا يدرك من أمره شيئا ولا يستطيع أن يتبين خطاه في هذا الواقع الجديد إلا بمعونة من المرأة.
الرواية خلقا للعالم

لوحة: كمال جبرالله
يشبه هذا العالم الروائي لوحة تشكيليّة ذات منزع سورياليّ تكعيبيّ متداخلة الأشكال متنافرة الألوان، تجتمع فيها عناصر لا رابط منطقيا بينها، يحسبها الناظر أوّل وهلة خالية من المعنى، ولكن في ذلك تحديدا يكمن المعنى.
ومثلما أنّ الناظر إلى اللوحة التكعيبيّة يلزمه أن يتحرّر من سجن الترابط الذهنيّ المنطقيّ بين الصُّوَري والتصوّري وأن يتخلّص من وهم إحالة الفنّ على الواقع، فكذلك على قارئ رواية “خان الشابندر” أن يتخلّص من الأفكار التي رسختها المدرسة الواقعيّة عن علاقة الرواية بالواقع مروّجة أنّ الرواية تحيل على الواقع وتُصوِّره، وأنّ الروائيّ هو عالم اجتماع مختبئ في جلباب حكّاء… “خان الشابندر” هي من سلالة الروايات التي لا تعكس الواقع بل تعيد خلقه من جديد على صورة غريبة لا تتراءى لمن يعيش ذلك الواقع قبل قراءة الرواية. ولعلّها بذلك أصدق تعبيرا عن الواقع من الرواية التي تدّعي أنها فهمت الواقع وأدّت شهادة حيّة عنه.
تقوم رواية “خان الشّابندر” مصداقا لقولة أوسكار وايلد الشهيرة حين قال في مقالته “أفول الكذب”، معارضا الواقعيّين “إنّ الفنّ لا يحاكي الطبيعة بل إنّ الطبيعة هي التي تحاكي الفنّ”. فمن كان يتخيّل قبل عقد من الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003 أن يحلّ بالعراق هذا القدر الهائل كلّه من التدمير والتخريب والتقتيل؟ من كان يظنّ أنّ المدن العريقة والنخيل الفارع والنهر الخالد يمكن أن يتلبّسها هذا الكمّ المرعب من الجنون؟ من كان يعتقد أنّ بغداد يمكن أن يستهويها إلى هذا الحدّ الرسم التكعيبيّ وسينما الرعب والروايات السوداء، فتغدو أحيانا لوحة لا سبيل إلى فهم سرّ تآلف ما حوت من متنافرات، وشريطا مرعبا لا يقوى أقسى الرجال قلبا على مشاهدته، وسلسلة من الجرائم الملغزة التي لا يمكن لأعتى علماء الجريمة فكّ غوامضها؟
لا تسعى “خان الشّابندر” إلى أن تكون وثيقة عن الواقع، ولا أن تقدّم لقارئها العراقيّ وغير العراقيّ صورة واضحة عميقة لما يجري في العراق اليوم ممّا لا يكون في أغلب الأحيان إلاّ تكرارا لما يقوله الصحفيّ والخبير وعالم الاجتماع ورجل الدين والناشط السياسيّ. بل رنت وفي ذلك سرّ نجاحها، إلى أن تصل الأقاصي وتبلغ المستحيل، إلى أن يكون السرد لا إطارا تودَع فيه الحياةُ وتحصر، بل منبع خلق تنبثق منه الحياة وتنتشر في العالم. ليست صفحات الرواية مرايا ترجّع أمام قارئها صورا ممّا يعرف، بل هي التماعات وضاءة لمّاحة -وما أكثر حضور الضوء في الرواية- تكشف له ما لا يعرف عن واقعه ونفسه وما يجري أمامه كلّ يوم.
لقد اقتنصت الرواية اللحظة الفارقة الغريبة التي يمرّ بها العراق، لحظة تلبّس الجنون بكلّ شيء، بالكائنات والجوامد، بالإنس والحيوان والنبات وبالجنّ أيضا، لحظة انهيار العقل والمنطق وامّحاء الفوارق بين المنظورات والمتصوّرات، واتّصال العلائق بين الأجساد والأشباح، والأحياء والأموات.
إنّها رواية تتجاوز الرؤية إلى الرؤيا، والإخبار إلى الكشف. وهي لذلك تقتضي من قارئها طرائق جديدة في النظر إلى الواقع تشترط بدورها امتلاك أدوات نظر جديدة، والقدرة على الاهتداء بما يلتمع في الكون وحول النساء الأحياء منهن والأموات، من نور وضوء، والتخلّي عن ملكة البصر الماديّة الإنسانيّة العاديّة.
إنّ هذه الفقرة التي تنغلق عليها الرواية تنبئ عن عمق التحوّل الذي أصاب الراوي ومسّ كلّ ملكاته الحسيّة إلى الحدّ الذي جعله ينسلخ من خصائصه البشريّة ويضحّي كائنا جديدا يسير دون أقدام، وينظر بلا عينين ويتكلّم بلا صوت ويسمع الأصوات وإن كان السكون حوله مطبقا كالموت، لا قائد له في رحلته القادمة إلاّ يد زميلته الصحفيّة نيـﭬين التي أصبحت هي الأخرى كائنا نورانيا يسبح في الفضاء.
لقد انتهت رواية “خان الشابندر” وضمّتها دفّتا كتاب صدر عن دار الآداب، ولكنّ النصّ لم ينته ولم ينغلق، بل لعلّه لم يبتدئ إلاّ عندما خلد الراوي للصمت وغرق في لجج النسيان. فببصمته تناءى الحكّاء ونطقت الكتابة، وتعطّل التلقي السطحيّ الحسيّ الأحاديّ للعالم، وبان أنّ الواقع في النصّ أصدق لأنّه أثرى وأشدّ تعقّدا وتعدّدا من الواقع الذي نبصر في وهمنا منه تخاييل ولكننا لا نراه. وحين تبتدئ الكتابة ويأخذ النصّ في التجلّي والإشراق، نكتشف سخف تقسيمنا إدراكنا العالم من حولنا إلى وهم وواقع.
ولعلّنا نحن العرب وفي هذه اللحظة التاريخيّة بالذات، أَوْلى البشر بالتخلّي عن هذا التقسيم العقلاني المنطقيّ المجدب والبحث عن إدراك آخر يمتزج فيه الشعريّ بالجماليّ بالحدسيّ بالصوفيّ. فمدننا العربيّة المتناثرة كأوراق الخريف، تلك التي نصرّ تأثّرا بإليوت في ما يبدو، أن تكون مدن وهم ويباب، هي اليوم مواكب من الثنائيات والجدليات والتناقضات، ففيها يتعايش في كلّ لحظة الموت مع الحياة، وتتمازج الآلام بالآمال، ويصنع البشر الحبّ والحياة في أحضان الخرائب، وتينع من أغوار الجدران المهدّمة الأعشابُ والأزهار… إنّ الشمس ما تزال تشرق على هذه المدن وينزل فيها المطر مدرارا ليطهّر أجساد النساء المقتولات ويغسل شعورهنّ من آثار الدماء ويبعد ما يتصيّد جثثهنّ من قطط وجرذان. إنّها مدن ما تزال ويا للمفارقة، مدنا عامرة بالاستعارة، وقودِ الكتابة الذي لا ينضب وبوّابةِ التخييل الرحبة.




