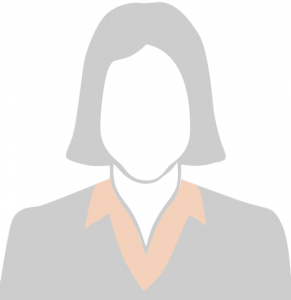أين البرتقالة: ست قصص موريتانية

مسرحيّة بالمجّان
لا أعرف إن كانوا يدركون حقيقتهم بشكل تام أو لا، إذ يبدو ارتباطهم مع هذا العالم موؤودًا، مثل حبال مهترئة، ولا أعرف أيضًا متى سينظرون إلى الأعلى ليعوا حقيقة ما تبقّى لهم من وقت.
سرياليّون إلى أبعد حد، أرقبهم في الصّباح الباكر من شرفتي حين يمشون، يبدو بعضهم كمن سُرقت أقدامه، بعضهم الآخر فُقدت آذانه، في حين يملك آخرون بدلًا من الأذن الواحدة والقدمين الاثنتين، ثلاثًا وأربعًا وخمسًا.
البعض رأسه يتخذ شكلًا مخيفًا كما أفكاره، آخرون تعوزهم الملامح أو تتضاعف فيهم، دواخلهم تسيل.. تتجاوزهم وتتجاوز الواقع كلّه معهم. قد لا أملك تفسيرًا لكنّي مع ذلك أستلطف الأمر حين أفكر في أنّه لا يجاوز مسرحيّةً أحضرها دون أن أدفع ولا حتّى قرشًا واحدًا.
أجلس هنا في هذا الركن منذ سنين، بينما ينبح كلب غريب في الجوار؛ لا يلبث أن يرد عليه آخر في الركن المقابل، ليستمرا بشكل أبدي.
في الآن ذاته تمر جماعة من ذلك الصّنف الأوّل، مآقيهم تملؤها الشمس حرارةً، خطواتهم دافئة وأيديهم ترتعد، بوجوههم النحيلة يلوّحون للريح كمن يأبى أو يرفض، لكنه يخشى شبحًا سيخرج من العدم في كلِّ لحظة، عيونهم باردة مملوءة بشظايا ندمٍ يلتمع، يسابقون بعضهم بانتظام لا يلبث أن يتزعزع لأنّ يدًا ما تمطّ ثياب أحدهم، وهذا الأخير يلتفت نحو المسكين وراءه.. أراه إذ يلكمه، إنّه لا يبدي أيّ ردةِ فعل، لا يعلّق، بل يستمر في مشيته الموبوءة، كما يفعل الكلبان اللّذان يتبعانهم.
في لحظات غير معلنة، تظهر الشمس مجدّدًا، ليخترق شعاعها أبصار الجميع سواي، فما زلت هنا، في ركني البعيد، أطالعهم.. بينما أقشّر برتقالةً وأبتسم، لكنّه الصوت ذاته، يأتي مجدّدًا، يزمجر خلفنا، بيد أنّي لا أبالي، ثمة ما يعنيني أمره أكثر؛ البرتقالة.
ينطلق ذوو الوجوه النحيلة بسرعة أكبر، يحجّون لا يقصدون سوى الفرار، (أينُهم) هارب.. ويسيل لعابهم، يسيل.. ها قد بلغت البرتقالة فمي، لكنّ يدًا أخرى تمتدُّ. إصبع رخوة دبقة تدقُّ كتفي اليسرى لتخبرني أنها اللحظة: لالتقاط هذه الاستعارة.
أين البرتقالة؟
***
محاولة
أصابتنا السيول، اقتلعت قطعَ الصفيح والكرتون التي يسميها بيتًا ولم يبرح مكانه، جاء الصيف، ولم يتحرك شبرًا، الجراد اكتسح الأرض وما زال ساكنًا متخشبًا حيث هو، ريح هوجاء، عواصف وبرد قارس، كل ذلك لم يدفعه للتّحرك ولو شبرًا واحدًا.
غيث، الذي لم يجد أحدًا يغيثه، مغترب بين أهله، انقسم ساكنو البلدة بين مدّع أنه مجنون فاقد لصوابه، ومؤمن أنه نصاب محتال يبحث عن طريقة لتأمين قوته.
لم أكن مؤمنًا بأيّ من تفسيراتهم، وما كان من شأني أن أؤمن، وما كان إيماني هذا ليشكل أيّ فرق في حياة غيث، أنا فقط كنت موقنًا أن له قصته وتفسيره، له دوافعه التي ليس من شأن أيّ كان سؤاله عنها، وليس هو بمطالب أن يثبتها.
قبل أسبوع مررت به كما في كل يوم، كان جالسًا في زقاقه قرب الرصيف المجاور لبيتنا، صحنٌ وبعض القطع النقدية على جانبه، لم يكن غيث ذاك الذي عرفته، كان غيثًا جديدًا، وكأن الكون محشور في عينيه. عينان شاخصتان تسعان كل ضالة، كان وجهه رهابًا يستفرغ الحشود. وقفت وخيّل إليَّ في لحظة أن عزرائيل كان فوق رأسه، غادرني الصمت، ولأول مرة أشعر بأن الكلمات تغريني، فقلت له بتوجُّس مر:
– هل أنت بخير؟
– من أنت ومن خير!
– أعني أتحتاج شيئًا؟
– وهل للميت حاجة!
– طبعًا!
– وما حاجته؟
– أن يدفن مثلًا.
– إذن افعلها.
الحق أني لا أعرف ما كان القصد من أسئلته، ولا حتى ما كان معنى أجوبتي، كنت أبتذلها، محاولًا حثه على استكمال الحديث، فقد بدت لي طريقة كلامه ميتة غريبة، ولا أنكر أني أصبت بالفضول.
أكملت طريقي وصدى كلماته يتعاقب مترددًا ألوف المرات في جمجمتي، وطوال أربعة أيام متتالية وأنا أكرر السؤال نفسه ضمنيًّا كل صباح “هل تحتاج شيئًا؟ بمَ أساعدك! هل يسعني أن أخدمك؟ أمن شيءٍ تحتاجه؟” ويأتيني الرد نفسه، “وهل للميت حاجة! وهل للميت حاجة! وهل للميت حاجة! وهل للميت حاجة!”
فكرت طويلًا وأيقنت، غيث إنسان ملَّ من حياته، يريد الموت ولا يجرؤ عليه، وأنا إنسان يتمنى أن ينجز شيئًا في مسيرته، أعني أننا نكمل بعضنا، ولم لا؟ أحقق له حلمه، أريحه من عيشه الذي صار ثقيلًا عليه، وأريح فكري من منظر عينيه الشاخصتين كل صباح، أقتل حشدًا كاملًا بقتل فرد، وبهذا أنقذه وأنقذ الحشد.
في اليوم السادس وبعد أن أنهيت عملي توجهت عصرًا إلى محل الأثاث الخاص بجاري، اشتريت منه قطعة خشب ومطرقةً ومفكًا، على اتفاق أن أدفع له الشهر المقبل – والحق أني لن أفعل – كان عندي المال، لكني لم أشأ أن أدفع له، فالخشبة ليست لي.
استعرت مجرفة من عند جاري الثاني – لا بد أن أستغل هذا الجوار – عندما انتصف الليل كنت قد أنهيت حفر القبر، وبالمطرقة والمفك نحتُّ على الخشبة “وهل للميت حاجة؟” وضعتها هناك عند مقدم القبر لتكون شاهدًا، ثم نقلت غيثًا إلى قبره، كان الأمر أيسر مما ظننت، وقد ساعدني هيكله الضئيل في تلك المهمة.
الآن غيث في قبره، بدأت أهيل التراب عليه، لم يرف له جفن، ألقيت بها بيديَّ، كتجربة، حفنة، حفنتان، ثلاث، ثم أمسكت بالمجرفة وبدأت مواراته في التراب، كنت أحسب عدد المرات التي أرمي فيها بالتراب عليه، في المرة الرابعة التي حركت فيها المجرفة سمعته يعطس، ثم يكح، تابعت إلقاء التراب، وفي لحظة أحسست أن وجهي مُسَّ بسقر، كانت كفه قد انطبعت على وجهي، ثم بدأ يركض متخبطًا بعد أن قفز خارجًا من قبره، أكمل يركض، يعطس ويكح، يكح ويعطس، ثم اختفى في آخر الزقاق. ناديته فلم يجب، كرّرت ندائي مرّاتٍ ومرّات، دون جدوى، بينما ظلَّ القبر أمامي مرحِّبًا.. فاغرًا فاه مثل حوتٍ.
***
ما زال يركض
لم يكن عاديًا كان مختلفًا جدًا؛ إذ لم يسبق أن مشى في الطريق، الطريق كان يمشي به، يأخذه حيث يريد أو يرغب. ظله كان دائمًا سابقًا له بخطوة، وقد كان هذا أمرًا جيدًا، فهو درعه الحافظة الأمينة، يحميه من فاجعة الأوان، أو الوقوع في هوة المستقبل.
كان حذرًا جدًا، وهو أمر لم يكن ليفيده أبدًا، فقد استيقظ اليوم ليجد المأساة ملتصقةً بوجهه، صرخ، لكنه لم يسمع لصراخه أيّ صوت، صرخ مرارًا لكنْ دون صوت ودون فائدة.
تساءل كثيرًا في نفسه عن الذي يحدث؟ رغب في أن يشارك الأمر مع أحد، أمسك بالهاتف، ضغط الأرقام، وأرسل الخط، رن مرتين، فقطعه! استدرك أن أحدًا لا يفهمه.
أحدٌ لم يفهمه عندما كان طبيعيًا ويشتكي أمورًا تحدث مع الجميع، فكيف إذا اشتكى مما يصنف خارجًا عن العادة والمألوف!
تساءل في نفسه، هل ضاقت الأرض بالمأساة لتلتصق بوجهه؟ لماذا لم تختبئ في داخله، قد يبدو الأمر منطقيًا نوعًا ما، لكن ليس بوجهه!
كان متوجسًا، وبدأ دفق الأسئلة يزلزل ما بقي ساكنًا من ذهن يفترض أن جمجمته تحتويه:
– ما به وجهك؟
– تبدو غريبًا جدًا اليوم!
– هل نمت البارحة؟
– أنت لم تتناول إفطارك؟
– هل حرارتك مرتفعة!
– من ضربك؟
لم يرغب في سماع أسئلتهم، لقد ملَّ الكذب، بودِّه لو يخبرهم أنها المأساة جاثمة تسكن وجهه، لكنه موقن أنهم سيجتمعون على جنونه.
استخدم الماء البارد ثم الساخن، أضاف الملح فرك وجهه بالمنشفة، حاول أن يجتثها بيديه. كلّ ذلك دون جدوى.. وهكذا قرر نسيان الأمر، بل والتعامل معه كأن لم يكن، ارتدى ثيابه، وانطلق خارجًا لا يعلم إلى أين، إنما إلى الخارج، أليس هو الذي يمشي به الطريق؟
وقف عند باب المنزل لكنَّ الطريق لم يتحرك به، مشى خطوتين ليصبح في منتصف الشارع ولم يحدث شيء، غير أن سيارةً كادت تدهسه، أيعقل أنه صار عاديًا؟ نظر نحو ظله فوجد أنه منه بمسافة عادية كالمسافة التي يظهر عندها الظل في تمام السابعة صباحًا، والشمس لتوّها منذ دقائق قد أشرقت، أي أن ظله لم يعد سابقًا له “يا للخيبة” قال في نفسه، امتلأت عيانه ألمًا، ومضى ماشيًا نحو اللّااتّجاه، كم كانت روحه موجوعةً حينها، حاول مرة ثانية أن يصرخ لكن مجددًا دون فائدة.
سمع صوتًا أشبه بالركض، اتجه بوجهه نحو مصدر الصوت، كان عند ظهره، هناك رأى ظله يركض بعيدًا، ولا إراديًا بدأ بالركض خلفه والصراخ، لكنَّ ذلك ما كان ليجدي!
حين يتركك ظلك لا تفكر في أنه سيعود، وحين ينساك صوتك لا تحاول استعادته، هي الأشياء هكذا تحدث. في لحظةٍ ما تستقلّ، وهو أمر يجعلها ليست من شأنك، وإن كان قد حدث أن كانت كذلك.
إنه يركض.. ما زال يركض.
***
وداعًــا
لقد قتلوني منذ يومين، لكن ما زال بوسعي أن أتحدث.
قبل شهر بالتمام جاء مالك البناية التي أسكن فيها، طرق الباب مرتين، وحين نظرت من العين الصغيرة علمت أنه هو، لم أشأ أن أفتح له؛ لعلمي المسبق بالنهيق الذي سيتفضَّل به، لكن شاء الجدار أن أفعل، فحين أقفلتُ راجعًا إلى الأريكة التي كنت مستلقيًا عليها، تعمَّدَتْ حاشية الجدار أن تصطدم بقدمي، سَقَطْتُ جراء ذلك وبات واضحًا جدًا وجود شخص ما في الداخل، ومن غيري سيكون! فالكل يعرف، مورينو لا أصحاب له، ولا أهل، ولا حتى كلب.
“افتح الباب يا مورينو، لا يجب أن تضطرني لفعلٍ تندم عليه.”
كنت مجبرًا كعادتي طبعًا، فمنذ ولدت وأنا مجبر، مجبر على وجودي، على عائلتي الفقيرة القبيحة، مجبر على بيت الصفيح في حي الخدم – سابقًا – مجبر على العمل مع تاجر المخدرات برونتو، مجبر على خيانة الإنسانية، وكسر القوانين، والأسوأ من هذا كلِّه أني مجبر على فتح الباب لهذا الطويل الأصلع، ذي الكرش المترهل، حتى أذناي لم تسلما، فهما أول المجبرين.
فتحت الباب.
وبدأ هو:
“مورينو لقد طال الانتظار، أنت تسرقني كل يوم، وكل ساعة، منذ ثلاثة أسابيع وأنا أنتظر تسديد المبلغ المُستحق عليك، وهذه أطول مدة صبرتها على أحدهم من قبل، لديك مهلة أربع وعشرين ساعة، بعدها لا تسأل عن رأسك أين هو. أربع وعشرون ساعة فقط، ولا حتى ثانية إضافية.”
أشاح بوجهه ثم كنت أرى ظهره، اختفى إلى اليسار، ثم سمعت صوت المصعد.
فورًا اتجهت نحو الحمام وغسلت أذنيَّ، رنَّ هاتفي، كان برونتو يتحدث:
“صفقة كبيرة تعال إلى الزقاق خلف المدرسة الابتدائية.”
بسرعة شهاب ساقط – وأنا ساقط بطبعي – ارتديت سترتي البنية، أخرجت مسدسي من تحت الغسالة في المطبخ، دسسته في طرف بنطالي، صببت لي كوبًا من عصير البرتقال، الوصية الوحيدة من وصايا أمي التي التزمت بها، فقد كانت تقول إنّه مفيد جدًا ويُكسب الطاقة.
فور وصولي للزقاق كانت الأصفاد تجمع يديَّ لتعانقا بعضهما، المسدس الذي دسسته في طرف بنطالي هو الآخر صار في منتصف رأسي، على الأقل ما زال هناك شيء ممتع في الأمر، تحقق حلم طفولتي، أن تطاردني الشرطة وتمسك بي.
تسعةٌ وعشرون يومًا وأنا بين أربعة جدران، ثلاثة من طين، أما الرابع فمجموعة من القضبان، المكان مضاء بإنارة بيضاء تجعل الوقت كله واحدًا، لا نهار ولا ليل، بين فينة وأخرى أسمع ضحكات السقف، تذمر فتحة التهوية، صراخ حواشي البلاط، بكاء السرير، وشخير رخام المغسلة.
لم يتطلب الأمر كثيرًا، أيامٌ إضافيَّة أخرى وكنت مورينو مختلفًا وجديدًا، أقسمت على نفسي أن أسدد الدَّين لصاحب الشقة الذي أستأجر منه، أقسمت ألَّا أبيع المخدرات مجددًا أو أشتريها، أقسمت ألَّا أدخن، وألَّا أهزأ بالمتشردين الذين يقطنون الأزقة والأرصفة، عاهدت نفسي أن أصبح إنسانًا، أن أزرع شتلةً كل يوم، أن أزور قبر أمي شهريًا، وأن أبحث عن عمل شرعي.
لكن فات كل شيء، إنها اللحظة التي تسلك فيها الطريق الصحيح، بعد أن أصلحت فكرك، ورتبت هندامك، لكنَّ قطارًا من غمٍّ ينحرف عن مساره، فيدخل في طريقك الصحيح، متجهًا عكس سيرك ليصطدم بأمنياتك التي تركض قبلك، بأحلامك التي تتبعها، ثم بك أنت، تاركًا إياها وأنت في حالة من سكْرٍ فاتن، لا أنت ميت فتنعدم آلامك، ولا حتى حيٌّ فتعي واقعك.
بعد عشرين يومًا جاءني رجل ضخم الجثة، وجهه أحمر كمن صُفع لتوه، قال إن أمامي عشرة أيام، أكتب فيها وصيتي لأن حكم الشنق كُتب بحقي.
لم أعرف ما أصنع وإذ تخشبت لم يكن بوسع الأيام أن تفعل، لم أشعر بالزمان ومضيِّه لكنه كان يمضي.. تسعة أيامٍ من التجمد، يحضرون لي شيئًا يسمونه طعامًا فإذا عادوا وجدوه كما هو، يكلمونني فألتفت أنظر إلى رقابهم، لا أنظر في وجوههم، بعينين ذاهلتين أنظر! وصورة رأسي زائغًا، وعيناي معصوبتان، وجسدي المتدلي من أعلى تحكم كل تفكيري، أهز رأسي يسارًا، يمينًا، يسارًا يمينًا، ثم أصرخ، استمررت على هذه الحال حتى اليوم الثامن.
قبل موتي دخل أحدهم الزنزانة التي كنت فيها، تحدَّث تحدَّث، وتحدَّث، كنت ما زلت أهز رأسي، أهزه، أهزه، يسارًا، يمينًا، يسارًا، يمينًا، ثم وجدت يدي ملتصقة بصدغه، ويدي الأخرى تضغط على رقبته.
ضجة مرعبة! فُتحت الزنزانة، وضعوا أصفادًا في يديَّ، وقدميَّ، واقتادوني نحو الظلام.
ساحة كبيرة في صمت الليل، وهمس النجوم كنا نسمع أصوات صهيل الخيول تأتي متهدِّجةً من البعيد.. رأيت رافعة تهبط يدُها، فيها حبل يشبه حبل الغسيل في بيتنا القديم، رُبط مثل سلسلة.. فُكَّت أصفادي، ثم بلا وعي كان الحبل ملتصقًا برقبتي، وقد صار إدراكي متقطِّعًا.. ابتسمت حينها، وإذ نظرت للأعلى رأيت الحياة.
تجرّدتُ منهم.
***
صوتي

استيقظت اليوم ولم أجد صوتي، ولأنني إنسان متسامحٌ، ناهيك عن كوني مللت الركض خلف الأشياء، قررت أنَّ من لا يريدني لا أريده، وقد وجدت هذا أمرًا منطقيًا بما يكفي.
أن لا يريدني صوتي هو أمر طبيعي، وحق مكفول له، كل شيء يقرر مصيره، وصوتي شيءٌ في حد ذاته له مشيئته الخاصة، أضف إلى ما سبق، أن صوتي أجش، قبيح جدًا، ولن يستقبله أحد مهما حدث، باستثناء حنجرتي الدخانية ولذا فحتمًا سيعود.
قضيت نصف ساعة بعد استيقاظي جالسًا على حافة السرير، أنهيت فيها علبة سجائر كاملة، افتتاحية جيدة لصباح مبشر.
أنا إنسان إيجابي، ما زال هناك شيء جيد في غياب صوتي، أن أدخن علبةً كاملة قبل عودته – إن قرر العودة طبعًا – لا علاقة حقيقية بين الأمرين، لكن عليّ أن أذكر هذا.
أنا شخص لا يحب الاعتياد، ويفضل الاستمرار في عدم استيعابه، وأحيانًا أفضل الهذيان على جميع الخيارات، تلك المحدودة طول الوقت. في اللحظة التي هممت فيها بالقيام من على السرير طرق أحدهم الباب، اتجهت نحوه، ودون تردد أو تفكير فتحته، كان رئيسي في العمل، مدّ يده لمصافحتي، لكنني استمررت مذهولًا، كنت أنظر إليه بدهشة مزجت بين رعب ساذج وبرود غير مسبوق:
منذ أسبوع لم تأتِ، ولست تجيب لا على هاتفك ولا حتى بريدك الإلكتروني.
أدخل يده في جيبه، ثم مدّ لي ظرفًا مطويًا أربع مرات.
مفصول من العمل، أمر من الإدارة العليا، بذلت ما باستطاعتي لكن لم أنجح في تلافي هذه النتيجة.
كنت أرغب بشدة أن أجيبه، لكني لم أتمكّن، والذي زاد ذهولي وصدمتي هو أنه كان يتحدث بصوتي.
أعندك ما تقوله؟ حسنًا تبدو مصدومًا وفزعًا، أنا آسف جدًا لأجلك، لكن عليّ المغادرة، بالتأكيد سنلتقي، أنت ستمر لتستلم أوراقك سأراك فيما بعد، إلى اللقاء، خالص مواساتي.
تركت الباب مفتوحًا وأقفلت راجعًا، جلست على حافة السرير مرة أخرى، واستلمت علبة سجائر ثانية.
إذن منذ أسبوع لم أفق، صوتي ليس هنا، رئيسي في العمل سرقه، ووظيفتي أُعفيت منها، ربَّتُّ على كتفي بيدي وقلت – في محاولة فاشلة للتخفيف عني – لا بأس.
أنهيت علبة السجائر، أي أنه بإمكاني أن أباشر فعاليات يومي، استنزفت ساعةً كاملة في الاستحمام، ارتداء ملابسي، وترتيب أوراقي، ثم خرجت دون أن آخذها، فقد تذكَّرت أني قد أُعفيت من عملي ولا حاجة لي بها، وحرصت على ترك الباب مفتوحًا، فقد يعود صوتي.
اتجهت إلى يمين البناية، قاصدًا موقف الحافلات، لكن الطريق استمر في الاعوجاج، كنت أمشي في رصيف مستقيم، لكنه استمر في الميلان مشكلًا طريقًا أعوج، ثم بدأ بالانحدار، وأصبحت أمضي بسرعة رهيبة، حاولت أن أصرخ، مع علمي المسبق بأن صوتي ليس متوفرًا لكنني حاولت – يقولون أن المحاولة أمر جيد – كان الفراغ في حنجرتي يأكلني، شعرت به يبتلع روحي، الأرض كانت تجذبني، كنت أنحرف، والطريق يزيد في ميلانه، فجأةً ما عدت أرى سوى نقاط مبعثرة، الأشياء أصبحت نقاطًا، وقد سمعت صوتي يصرخ، يستغيث يطلب النجدة، لم أعره أي اهتمام، بدا لي الأمر ضربًا من دناءة فذة، سلمت نفسي للانحدار والاعوجاج.
أرى النقاط بشرًا الآن..
كلهم أصبحوا من الماضي..
وأنا أهوي في داخلي، روحي تأكلني، وروحي تأكلها الهوة.
***
عِداء
بحلول الليل يبدأ بتفقد كل شيء، يرفع الأغطية – ربما يجد الحنين أسفلها – يتفقد الخزائن، ربما تسلل أحدهم عبر ذاكرته فاختبأ هناك، يصعد إلى العلية يبحث بين الفراغات عن أجزاء جديدة ربما تكون للتوّ ظهرت لتنبئ بشيء عن أيامه المقبلة – ولو أنه يعرف قلة جدوى الأنباء كلها – ينظر نحو المدى فلا يرى غير الغول الذي خبره منذ طفولته، ما زال يخطو مقبلًا لا يصل.
يهبط نازلًا نحو القبو، يتفقد الماضي، صورة صورة، يمسح الغبار عن الرسائل، يحرق بعضها – تلك التي لم تعد تعنيه – أو يلغي بعض الكلمات – المزعجة منها، أو التي صارت حميمية حتى لم تعد تطاق – يعود إلى غرفة نومه، وقبل أن ينام، يُخرج قلبه ليتفقده؛ يتأمله، ثم يبدأ العمل: ينتشل كل الأجزاء الميتة، يضبط عواطفه مثلما يضبط ساعة المنبه، يرمي ببعض الشظايا – حدث انفجار هنا – يفتش عن أشخاص لا يعنيهم أمره يلتقطهم بإصبعيه ملقيًا بهم نحو الخارج، ينظر إليهم بنصف عين وكأنهم خطيئته الأكثر خصوصية، وحالما يرى ظهورهم تتضاءل تسكنه الطمأنينة.
يقلِّبه… يتأمله مجددًا ثم يقرر أن عليه تحديد وقتٍ يوقف بعده عمل ذلك الجزء الذي طالما كان مفرطًا في حساسيته، منحازًا إلى القلق، يتأكد من وجود ما يكفيه من ساعات، وقد يحدث أن يتبرع ببعضها.. هكذا ببساطة “الدنيا صعبة” يقول، “وهذه فائضة عن حاجتي” يفتح النافذة.. يخطو خطوتين إلى الأمام يتوقَّف، ثم يمدُّ يديه ليكبَّها نحو بيت جاره، حتى إنه لفرط بهجته يلقي بالبرميل الذي وضعها فيه، وينشقُّ فمه عن ابتسامة توحي بارتباك واهٍ، إذا سمعه وقد اصطدم بالبراميل الأخرى في الأسفل، تلك التي يضعها جاره لالتقاط هذه الساعات التي لا يعرف كم كارثةً تحمل، “غبي!” يقول، ثم يصوِّب عينيه مثل أيّ مسدس آخر ليراها؛ ساعات عمره تتلوّى! الآن فقط يعرف من أين كان يأتيه كل ذلك الخوف.
يقفل عائدًا إلى الفراش، وقبل أن يتمدَّد، تدقُّ الساعة، اللعنة التي يفترض أنها لم تعد تعنيه، يلتفت نحوها ثم يلتفت إلى نفسه، وهكذا.. حتى ينقضي الليل.