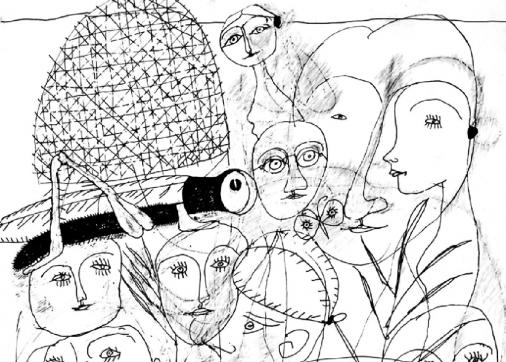الأنساق المضمرة

تنهض السيرة الذاتية، أساساً، على عناصر سردية مستمدة من التاريخ الشخصي للفرد فضلاً عن التاريخ العام للمجتمع، وبخاصة المرحلة التي تزدهر فيها شخصية البطل، كما أنها تنطوي على عناصر ثقافية، بعضها صريح وبعضها مضمر تمثل موجهات سلوكية وعقدية للأفراد والجماعات.
لذلك فإن السيرة الذاتية تشير، بقوة، إلى السياقات الاجتماعية والتاريخية من دون أن تفقد حيازة المقدرة على التوهج المستمد من الطاقة الفنية الداخلية ومن الإضافات التخييلية التي لا يخلو منها أيّ عمل أدبي أو فني راقٍ. وهذه الحقيقة تفرض على النقد أن يتحرر من فرضية موت المؤلف، وأن يستعيد كثيراً من وقائع السياقات الخارجية المتمثلة بالصيرورة الذاتية والاجتماعية والسياسية ليقارنها مع ما ورد من وقائع السياق الداخلي النصي من أجل رسم صورة الحاضنة التي أنتجت خطاب السيرة الذاتية وتحديد عناصر الاتفاق والاختلاف بين الوقائع التاريخية والوقائع النصية من جهة، ولبيان آليات اشتغال الأنساق المضمرة في رسم ملامح النص الفنية والفكرية.
من الناحية الفنية، يجب أن تستوفي السيرة الذاتية شرطاً مهماً هو التطابق بين المؤلف والسارد والشخصية، أو المكونات الثلاث المنتجة لعملية السرد، كما يرى فيليب لوجون (“تحليل النص السردي: تقنيات ومفاهيم” محمد بوعزة، ط1، منشورات الاختلاف/ الدار العربية للعلوم، الرباط – الجزائر، ص 32)، وهو شرط متحقق على نحو صريح في السيرة الذاتية التي حملت عنواناً موحياً هو “أمواج” للناقد الدكتور عبدالله إبراهيم، الصادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة في الدوحة عام 2017، فكيف اضطربت “أمواج” عبدالله إبراهيم لتؤسس قيمتها الثقافية والجمالية؟
السيرة.. أهميتها ومرتكزاتها
بداية نقول إن كتَّاب السيرة الذاتية يهدفون إلى تقديم إجاباتهم على جملة من الأسئلة الفكرية ذات الأبعاد الذاتية والاجتماعية والسياسية والثقافية والوجودية التي واجهها البطل في حياته الشخصية. وتبدو هذه الإجابات كما لو كانت نوعاً من الشهادة أو كلمة الختام بخصوص ما جرى، وكيف جرى، والأسباب التي دفعت الشخصية المحورية إلى اتخاذ مواقف معينة، أو الصمت عن مواقف أخرى قد تكون مطلوبة لهذا السبب أو ذاك. ولهذا فإن خطاب السيرة الذاتية ذو جوهر حجاجي في المقام الأول لأنه ينطوي على دفاع ذاتي عن التحولات التي شهدتها سيرة المؤلف وتسويغ ضمني أو صريح لما قام به من أفعال. إنها تقدم رؤية فيها شيء من الدفاع والدفوع بلغة القانون. وهذا يعني، بالضرورة، وجود خطاب ثاوٍ في العمق يتعارض مع المنطق المباشر للمدونة السيرية. إن رواية السيرة الذاتية تفترض وجود ميثاق بين الكاتب والقارئ بفض حجاب الخصوصية وكشف بعض الجوانب المعتمة في سيرة المرء، وفضلاً عن ذلك فهي تفترض وجود خطاب مواز وغير مصرّح به قد يكون مضاداً لما سيقوم به النقد أو القراء أو المعارف. وفي حالات معينة قد يكون هذا الخطاب الموازي مدوناً على نحو صريح وقد يكون ضمنياً. بيد أنه ليس للنقد أن ينصرف كلياً إلى اقتفاء مسار الحجة والحجة المقابلة وفحص كل واقعة نصية ومطابقتها عن مرجعياتها التاريخية والاجتماعية؛ فالسيرة الذاتية تختص بمعالجة تستند إلى رؤية ظاهراتية وذاتية لأنها تركز على الصيرورة والوعي من خلال الظواهر الملموسة التي عاشها البطل وكيف تعامل معها، وأيضاً من خلال وعي التحولات المعقدة الناشبة في النفس في علاقاتها مع الآخر؛ بمعنى أنها تنحو إلى أن تكون نوعاً من صيغة الدفاع التاريخي والتأملي عن حياة البطل وتجاربه الشخصية وتحولاته الفكرية والسياسية. ويمكن القول إنه، وفي أثناء انشغال المؤلف بتدوين سيرته الذاتية، تترك الأنساق الثقافية والاجتماعية آثارها هنا وهناك من دون أن يتنبه المؤلف إلى ذلك، فهذه الأنساق جزء تكويني من لاوعي النص.
تتجلى الأهمية الأدبية للسيرة الذاتية في ثلاثة جوانب: الأول يتمثل في الصيغة الفنية التي يختارها الكاتب لصوغ نصه السيري، وكيف يبدأ السرد ليتحرك في التجربة الزمكانية استعادةً أو استباقاً، وأيضاً اختيار اللحظة المناسبة لاختيار مغادرة السرد التاريخي لأحداث حياته ومجتمعه ليدخل في التأملات الفكرية والفلسفية، والثاني يتمثل في التزام أكبر قدر ممكن من الموضوعية في سرد الأحداث التاريخية وإظهار طبيعة العلاقة المعقدة بين التصورات الذاتية من جهة وسياقات الصيرورة الاجتماعية والتاريخية من جهة أخرى، والثالث يتمثل في اختيار الصوغ اللغوي/الكلامي المعبر عن الصيرورة الرؤيوية للنص السيري. ومما لا شك فيه أن هناك ضرورة أخلاقية في أن يوازن الكاتب بين ما يودّ الكشف عنه والبوح به من حقائقه الذاتية من جانب، وما يورده من كلام يخص الذوات الأخرى من أفراد أسرته، أو من محيطه الاجتماعي أو الفكري أو الثقافي من جانب آخر؛ وهو محيط شهد، وما زال، صراعات سياسية وفكرية وثقافية محتدمة، وقد احتلت شخصية البطل موقعاً مركزياً في دائرة الصراعات هذه بسبب من كونها بطلة الخطاب السيري، لذلك فهي الوحيدة التي تدلي برأيها هنا. وفي هذا الصدد، يصرّح عبدالله إبراهيم، أنه أراد لسيرته هذه أن تكون مدونة اعتراف لا تبريراً، وأنه ليس في ذكره لأعراق أصدقائه وخلفياتهم المذهبية أيّ حمولة أيديولوجية (ص 18)، فهل كانت مدونته كما أراد؟
من الناحية الفنية، تنهض رواية عبدالله إبراهيم على ما يوحي به العنوان “أمواج” من استعارة أو صورة كنائية كلية حركية متمثلة في فكرة الأمواج التي تواجه القارئ في العنوان وفي فصول السيرة التي استحالت إلى إحدى عشرة موجة متتابعة؛ ولكل موجة تسلسل ذو عدد ترتيبي (أولى، ثانية، ثالثة، … إلخ)، فضلاً عن عدد من التقسيمات الفرعية ذات العنوانات المستقلة. وتوحي استعارة الموجة، دلالياً، بحركية المياه في المحيطات والبحار والأنهار لتولد مماثلة كنائية مع المحيط الاجتماعي وحركته الدائبة. وقد توحي، أيضاً، بأمواج التسونامي المدمرة نظراً لما ترتب على الأمواج الاجتماعية من تدمير جسيم في بنية المجتمع والفرد. ولأن حركة الأمواج تعاقبية، فهي تستحضر فكرتي الزمان والإيقاع. فالعنوان، هنا، ليس محض وسيلة مبتكرة لتقسيم فصول السيرة التبادلية الذاتية فحسب، وإنما هو في الوقت نفسه صورة لحركة الحياة والنفس في علاقاتهما الجدلية مع الصيرورة الاجتماعية والسياسية والثقافية، صعوداً وهبوطاً، تقدماً وتراجعاً. وهذه الصورة الكنائية يمكن أن تفهم على وجهين؛ فهي قد تكون دفاعاً حجاجياً ضمنياً عن النفس؛ ففي نهاية المطاف، ليست شخصية البطل (عبدالله إبراهيم) سوى كيان إنساني طافٍ تتحكم به حركة أمواج الحياة والمجتمع؛ وفي حال اختلاف القارئ مع هذا الكيان الإنساني، فلا سبيل لتوجيه اللوم له على ما أتى من أفعال أو ما اختار من مواقف، إنما يجب أن يفهم سلوكه ومواقفه في سياقاتها النفسية الاجتماعية والسياسية الأكبر. كما يمكن أن تفهم الصورة الكنائية الكلية، أيضاً، على أنها محاولة للتعبير عن القدرات الشخصية لهذه الذات وتمكنها من شق سبيلها الخاص بقوة وعزيمة وتحقيق قدر معين من النجاح في تحديد المصير في مواجهة مصاعب الحياة على الرغم من عتوّ الأمواج وهيمنتها شبه المطلقة، بهذه الدرجة أو تلك، على مصائر جميع من/ما يطفو عليها؛ وبذلك فهي تعبير ضمني عن مناقبية البطل، وتنويهٌ وفخرٌ بنسق التوثين الذاتي الكامن في نفس البطل الذي يشكل نسقاً مضمراً من جملة من الأنساق المتحكمة في استراتيجيات كتابة هذه السيرة.
وانطلاقاً من استعادة تجربة الطفولة المحرومة من الأبوة والأمومة، يقدم الكاتب نوعاً من الاستبطان الذاتي في صورة تفصح عن العناصر المأساوية والصراعية التي اكتنفت حياته على المستويين الشخصي والعام، فنقراً “كانت حياتي، منذ الطفولة، مزيجاً من أحداث وأفكار وأهواء. لم يجهّز لي أحد مسارها: لا أسرة، ولا قبيلة، ولا مدرسة، ولا مجتمع، ولا دولة؛ فوجدتني أصنع مساراً لها يقوم على التواطؤ بين رغباتي الشخصية، وتطلعاتي الثقافية، وأنماط الحياة العامة، وأتوغل فيه، فبدوت لنفسي وللآخرين ناجحاً. لكنّ تنازعاً عميقاً ظلَّ يشطرني جراء سعيي للتكيف مع العالم، فلم أنتمِ بصورة قاطعة لا إلى ذاتي برغباتها المفعمة بالطموح والفوضى، ولا إلى عالم الجماعة الممتثلة لمنظومة من القِيَم، والعقائد والعادات؛ فكنت أمزج بين هذا وذاك مُعرِضاً عما لا أراه يناسبني، ومُلتذاً بخرق إجماع الآخرين،…” (ص 11)، وهذا المقتبس يجعلنا على بصيرة بأن هذه الـ”أمواج” تروي حكاية السعي الحثيث للتكيف مع العالم والتغلب على صعابه؛ وكيف واجه المؤلف لحظات الأزمة والصدام مع الآخرين؛ وهل نجح الكاتب في مسعاه هذا؟
ويكشف المؤلف عن أن تحديد مسار الحياة اللاحقة قد مثل تحدياً وجودياً ترك أثراً عميقاً في مراحل حياته الشخصية حين صار أباً ورب أسرة. فهو يقرر أن الأمر “يعود ذلك إلى غياب التنميط الأُسري، فلم أعهد بناءً عائليّاً متواصلاً بسبب اختفاء الأب ثم الأم في وقت مبكر من حياتي، فدُفعت إلى ممارسة دور أكبر من أن يقوم به طفل، وأصغر من أن يلبِّي خيالاته، فتنامت فيَّ درجة عالية من الصرامة الذاتية، حتى إن أُبوَّتي أمستْ ثقيلة، إذ شرعتُ أرسم لأبنائي قِيَمًا لدور الأبوَّة المفقود في حياتي، ودفعهم للأخذ به، وضمرتْ في أعماقي عاطفة الأبوَّة الليِّنة، والحنان الشفَّاف، وأرجِّح أنهم خاضوا صعابًا في الاقتناع بدوري كأبٍ كرَّس لهم حياته، وأظنهم مثلي، وإنْ بطريقة مضادة، صاروا ضحية الأمر الذي طالما افتقدته أنا. ففيما لم يمهِّد لي أحد مسار الحياة، كبروا هم بين أسوار حياةٍ ارتأيتها أنا لهم. وخلق هذا انطباعًا بأنني حرٌّ فيما أريد، متشدِّد فيما يريدونه، …” التوكيد للناقد (ص ص 11 – 12)، فنلاحظ هنا أن الكاتب يشير إلى موت الأب والأم وفقدانهما الأبدي بكلمة “اختفاء” مما قد يشي بانعدام البعد العاطفي لواقعة اليتم المبكر. مع ذلك فإن أثر الموت المبكر للأب على البطل قد امتد ليسم دوره الأبوي والاجتماعي بنوع من الأداء الذي لا يجده البطل صحيحاً تماماً على الرغم من محاولته التماس العذر لنفسه فيما يفعل لأن أبناءه قد نشأوا في “أسوار حياة” ارتآها هو لهم كناية عن تغلغل النسق المضمر للأبوة الشرقية الكامن في نفس البطل، نسق السيد أحمد عبدالجواد في ثلاثية نجيب محفوظ؛ وهو النسق الذي ظهر من خلال كتم حرية الزوجة والأبناء. ويوحي الكاتب بهذا المعنى حين يقرر في مستهل الموجة الأولى “كانت حياتي، منذ الطفولة، مزيجاً من أحداث، وأفكار، وأهواء. لم يجهِّز لي أحد مسارها: لا أسرة، ولا مدرسة، ولا قبيلة، ولا مجتمع، لا دولة؛ فوجدتني أصنع مسارًا لها يقوم على التواطؤ بين رغباتي الشخصية، وتطلُّعاتي الثقافية، وأنماط الحياة العامة، وأتوغَّل فيه، فبدوتُ لنفسي وللآخرين ناجحًا. لكنّ تنازعًا عميقًا ظل يشطرني جرَّاء سَعْيي للتكيُّف مع العالم، فلم أنتمِ بصورة قاطعة لا إلى ذاتي برغباتها المفعمة بالطموح والفوضى، ولا إلى عالم الجماعة الممتثلة لمنظومة من القِيَم، والعقائد، والعادات؛ فكنت أمزج بين هذا وذاك، مُعْرضًا عمَّا لا أراه يناسبني، وملتذًّا بخرق إجماع الآخرين، …” (ص 11). ونقع في هذا الاستهلال على العناصر الصراعية الأساسية المحركة للأمواج، فنجدها ماثلة في التعارض بين تحقيق الرغبات الشخصية والتطلعات الثقافية، من جهة، والتمرد على أنماط الحياة العامة كافة، بما فيها من قيمٍ وعقائدَ وعاداتٍ وانتماءاتٍ، من جهة أخرى.
وتفصح تجليات الكلام/اللغة في “أمواج” عبدالله إبراهيم عن قدر عظيم من التميز إلى ثلاثة ضروب أسلوبية أساسية: الأول، ويتمثل في اللغة الإخبارية التي تتحدث عن وقائع تخص حياة البطل الأولى وما اكتنفها من تطورات، وأيضاً تتحدث عن حركة المجتمع التي تبدو شاحبة في القسم الأول من السيرة نظراً لغياب الوعي الاجتماعي للبطل حينذاك ويعقب هذا الضرب شيء من الاستدراك المتأخر لتفسير ما جرى وربطه بما سيحدث للبطل كما هو واضح فيما أوردناه من اقتباسات سابقة. والثاني يأتي في صيغة كلام/لغة فكرية وتحليلية تعالج الظواهر الذاتية والاجتماعية والسياسية؛ وهنا يبرز دور معطيات التجربة الثقافية الذاتية في فهم الأحداث الاجتماعية والسياسية، وتفاعلها مع الطاقة الثقافية والعقلية للمؤلف في جعل الكلام ذا أرجحية لدى القارئ الذي قد لا يتفق مع الكاتب في ما يذهب إليه من تقويم للأحداث الخاصة والعامة في العراق والبلاد العربية والعالم. وهذا الكلام/اللغة ذو أهداف حجاجية على درجة عالية من الصراحة والمباشرة، وهو يحتل جزءاً كبيراً من الرواية وينهض بمهمة التوثيق لأحداث جسيمة مرّت بمدينة كركوك التي ولد فيها المؤلف، وأيضاً في وطنه العراق والبلاد العربية والعالم. وفيه يلتمس المؤلف مناسبة تاريخية أو سياسية ما لينهض بمهمة تفسير الأحداث على نحو يدخل في باب الأدبيات السياسية المعبرة عن وعي المؤلف لما يواجه من أحداث كبرى مثل قضية فلسطين والتحولات الاجتماعية والسياسية في البلاد، والحرب العراقية – الإيرانية واحتلال العراق للكويت وانهيار منظومة الدول الاشتراكية ثم احتلال العراق ثم نشوب الصراع الطائفي فيه؛ فتتحول السيرة الذاتية إلى الجانب العقلي من حياة المؤلف فنجده قد تحول إلى محلل سياسي واقتصادي واجتماعي لما شهده من أحداث مما يتسبب في ظهور الجوانب الخبرية التاريخية وضمور الصيغة السردية والسيرية في هذه الرواية. ونلاحظ هنا أن الكلام يكتسب سمة مجازية حين يكون الكلام عن الغربة، فنقرأ “مع ذلك لم يتخفف إحساسي بالغربة كأني نبتة انتزعت من أرض واستنبتت في أخرى” (ص 101)، أو قد يكون الكلام ذا صيغة خبرية، فنقرأ عن حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل “عبر المصريون القناة ظهيرة السبت 6 تشرين الأول/أكتوبر، وتوقف هجومهم خوفا من الخروج عن نطاق الحماية الجوية. لكن الرئيس السادات أمر بتطوير الهجوم يوم الـ14 منه، فاندفعت القوات المصرية في سيناء، وانكشفت للإسرائيليين، وخسرت 250 دبابة من الدبابات الأربعمئة للهجوم. وفي هجوم معاكس قاده آرييل شارون، الذي أصبح رئيساً لوزراء إسرائيل بعد ثلاثة عقود، شُقتْ القوات المصرية إلى نصفين، وعبر الإسرائيليون القناة إلى الغرب يوم الـ16، وخلال يومين نجحوا في دفع خمسة ألوية مدرعة إلى غرب القناة، وبعد أسبوع قطعوا طريق السويس، فانفتح العمق المصري أمامهم باتجاه القاهرة” (ص 73)، ومن الواضح أن المقام قد استلزم استخدام لغة خبرية.
المرأة.. صورة ووجود

ولأن الرواية السيرية رواية تعلم (bildungsroman) في الجوهر، فإن بدء وعي البطل لكيانه الفردي واكتشاف العلاقة الحسية بالمرأة والجوانب السياسية والاجتماعية تحتل فيه أهمية خاصة فيها وتشكل محاور أساسية في سيرورة السرد. إذ أن اكتشاف البطل للحياة الجنسية قد حدث حين كان في أول الصبا، ومن خلال مواقف معينة أسهمت في نضجه الجنسي قبل الأوان. وتفصح بعض إشارات النص إلى ذلك، فنقرأ “في أوقات وجود أمي في القرية بين علاج وعلاج من السرطان، وبين رحلة وأخرى، وفيما هي تذوي، بدأت أتفتح أنا: غزتني الرغبات السرية بالنساء، والمرأة الأولى صبية حسناء. أحسبُنا ولدنا في السنة نفسها بالنساء، لكنها شبت قبلي، وامتلأ جسدها برحيق الأنوثة، ودوخني أريجُها الطبيعي، أثمن ما أورثته الطبيعة للمرأة. تجرأتُ في مساءٍ شتائي بارد وداعبت جسدها، فوضعت يدها على يدي برفق، ونعومة، وقبول، وتلطُّف، وطوال الليل كنت أرتعش. جافاني النوم، ودوَّمتْ عاصفةٌ من الحُمى في رأسي، كأنني دفعت من سفح جبل إلى هاوية. وتقلَّبتُ، وشحبت ْأجفاني، والتَهب َ فمي، وثَخنَ لساني، وكأن طفح الرجولة اخترق جسدي، فقد التهبتْ جذوتي الأولى، وبقيتُ ممسكاً كفي أتشممها، فبها لمستُ لحماً أنثوياً أول مرة في حياتي، وكأنَ عالماً مجهولاً تفتّحَ أمامي أمضينا أيام الشتاء في مداعبات مماثلة، وأنا مستغرق في أحلام اللذة” (ص 42). وإذ نلاحظ الصيغة المجازية الشعرية الكثيفة لحكاية الاكتشاف الأول للجوانب الحسية في العلاقة مع المرأة، فإننا نكتشف أن حضور المرأة في الأمواج الأخرى سيكون مرتبطاً على الدوام بالطبيعة الحسية للعلاقة مع المرأة، ولكن هذا الأمر يغيب تماماً عن تصوير علاقته بالمرأة الزوجة التي كان حضورها شديد الشحوب والاقتضاب. وتكشف حركة أمواج عبدالله إبراهيم، أيضاً، أنه حين كان يتحدث عن جوانب من عمله في التدريس الجامعي، فإنه يركز على الطالبات اللائي احتللن واجهة المشهد، واللائي لا يخلو سلوكهن إزاءه وما يثرنه من أسئلة من دلالات انجذاب حسي، وفي المقابل فإن الكاتب لا يكاد يورد ذكراً للطلبة الذكور حتى لكأن الفصول الدراسية التي تولّى تدريسها تبدو كما لو كانت خاصة بالطالبات فقط. وهذا مما يكشف عمق تأثير نسق الرؤية الذكورية الثاوية في عمق اللاوعي لدى الكاتب.
ويتردد حديث الكاتب/البطل عن تطور وعيه السياسي والاجتماعي في أغلب أمواجه. على سبيل المثال، في مقتبل شبابه، وحين كان المؤلف يغادر القاهرة عائداً إلى بغداد، يلتقي باثنين من المسافرين اللبنانيين. فتحدث واقعة حوارية بين المؤلف واللبنانيين تؤدي إلى رفع الغشاوة عن عينيه ليكتشف شيئاً من جرائم النظام السياسي السابق (ص 102). وحين يتحدث عن موقفه إزاء الدين والتحولات الفكرية التي شهدها نتيجة الدرس الجامعي والتحصيل الثقافي يظهر الميل إلى البعد الدنيوي للتجربة الذاتية، فنقرأ “فتح لي علم الكلام باباً نحو الثقافة الإسلامية وسجالاتها اللاهوتية. من قبل كنت معجباً بالمعتزلة، والقرامطة، والزنج؛ وهي فرق فُسِّرتْ على أنها عقلانية، قامت بثورات طبقية، بحسب التحليل الماركسي، لكن نافذة فُتحت لي نحو الكتلة الأكثر صلابة وسعة: الفكر الديني بأبعاده اللاهوتية. حسي الديني مغمور بالعقلانية، وما أفلحت كل التأثيرات في زيادة موارده الضئيلة. كنت آخذ بالقيم الدينية الكبرى، لكن قطيعة واضحة بيني وبين الطقوس والنصوص التي وجدتها موجهة لسواي، وخرجت كل نزواتي على أنها من حقوقي الدنيوية، ولم أعنَ بالتضارب بين سلوكي العام والأعراف الدينية، فكانت ذاتي منسجمة مع نفسها، تمضي في الطريق الذي عرفته منذ الصغر” (ص ص 111 – 112). وهذا المقتطف ينطوي على اعتراف يكشف عن الفهم الذرائعي للدين عند المؤلف/البطل؛ إذ بدلاً من الحديث عن غلبة الحس الدنيوي، نجد الكاتب يتحدث عن انغمار الحس الديني لديه بالعقلانية. لذلك فلا غرابة أن نجد لدى المؤلف خرقاً صريحاً لإحدى قيم الدين الأخلاقية الكبرى فيما يخص العلاقات العاطفية المتحررة من أيّ قيود ممارسة العشق واللذة الحسية. وفضلاً عن ذلك فإن نسق الرجل الشرقي، في علاقاته بالنساء، الذي يبيح لنفسه الحرية المطلقة ويتخذ في السرد صيغة شخصية شهريارية، فتقدم لنا الرواية مظاهر مختلفة عن تمركزها الذاتي كاشفة عن أن البطل يرى نفسه مركزاً جاذباً للنساء، وفي الوقت نفسه فإنه يغفل تماماً تقديم صورة مناسبة للزوجة التي تظل محض اسم ملحق بياء النسب (زوجتي)، فلا حضور ولا حديث ولا إرادة لها، ناهيك عن الخوض في طبيعة العلاقة العاطفية التي كانت بينهما. وقد انعكس هذا الموقف في الرواية، فظهر في صيغة كلام/لغة على درجة عالية من الكثافة الشعرية، وهي صيغة تتناول الجوانب العاطفية في حياة عبدالله إبراهيم، سواء أكانت تتحدث عن علاقاته العاطفية مع النساء، وبحسب الـ”أمواج” فقد كانت له معهن جولات وجولات، أو في علاقته بالوطن من حيث هي علاقة حميمة وتستنهض في المرء حالة انفعالية خاصة تنعكس في طبيعة الكلام/اللغة نفسها. فحين يلتقي بمن سيعشقها من الوهلة الأولى فتسحره وتفرض وجودها على كثير الأمواج، نقرأ “وفيما توزعتُ بين العزلة، والقراءة، وإثبات الذات في بغداد، غَزتني امرأة هيفاء. كربلائية، رشيقة، وناضجة، كأنها نخلة مجللة بالحزن. تعلق قرطين ذهبيين كبيرين في أذنيها. رقبتها رخام صقيل، وترتدي فستاناً يكشف منبت نهديها، ومعطفا أسود من الفرو الفاخر، وقبعة مضيفة، كأنها عارضة أزياء. بدأنا ننفرد في نادي الكلية حيث يضيع همسنا وسط الموسيقى الصاخبة، ثم نجلس متشابكين بأنفاسنا، وأيدينا، في مقهى ‘الزيتونة’ قبالة المكتبة المركزية، ونتجول في الوزيرية تحت الأشجار العالية ونتخيل مُحالات المستقبل. اصطحبتها إلى مدينة الملاهي، فمخرنا الأنفاق المظلمة. وفي لعبة “الأخطبوط” ارتمت على صدري، وانتثر شعرُها على وجهي شلالاً من الألق، وغبنا عن الوعي دقائق خمساً، هي في هلع وأنا في ارتخاء، وقد مزجَنا الدوارُ معاً، فوددت لو ألقتنا كف الأخطبوط إلى الهواء لنبقى بعيدين عن أرض غدوت أفقد صلتي بها. تشابكنا في زحام التاريخ، وكجنة مثمرة وشهية بدت لي، أطوف بها عالماً اهتز خموله تحت وهج رغباتنا. نجمة مرَّت في سمائي بسرعة البرق، فتركت ومضاً أعشى بصري زمناً طويلاً. جاءت من أرض الحزن الأولى، من أرض السواد، فكانت تشهق كصدع جبال متكسرةً، وتتأوه كنسائم بحر لا قرار له”. ونلاحظ هنا أن هذه اللغة الشعرية قد ارتبطت على نحو لا فكاك منه مع الأداء الإيروسي الذي سيواكب حضور هذه الهيفاء المعشوقة مراراً وفي مواضع، أو أمواج، أخرى من الرواية. وإذا ما أعدنا التفكير في دلالة انصراف المؤلف عن ذكر أيّ تفاصيل عن زوجته، فإن ذلك يكشف عن تمكن النسق المضمر للثقافة الذكورية الشرقية لدى المؤلف. ربما كان ذلك لأن العلاقات الزوجية يشوبها الفتور والتراجع بعد حين، ففي لقاء صحفي منشور قبل صدور “أمواج” يتحدث عبدالله إبراهيم عن صورة الزواج والعلاقات الأسرية في السرد النسوي قائلاً “رسم السرد النسوي صورة قاتمة للعلاقات الزوجية، فليس ثمة تفاعل بين الرجل والمرأة في بيت الزوجية الذي تحول إلى معقل للاثنين يتواجدان [كذا] فيه مجبرين [من] دون أن يتشاركا في أي شيء، فالزوجات يتماثلن في أنهن مررن بأزمة كاملة في حياتهن داخل بيوت تصطفق فيها أبواب الكراهية والحقد بين الزوجين إلى درجة تمنّي الموت” (“سرد النساء وسرد الرجال”، حوار أجراه إياد الدليمي مع عبدالله إبراهيم ونشره في مجلة “علامات” المغربية، العدد 34، ص 53). ونتساءل هنا إن كان هذا الكلام عن كيفية تصوير السرد النسوي للعلاقة الزوجية ينطبق أيضاً على طبيعة تجربة الشخصية لصاحب الأمواج في مجال الزواج وتكوين العائلة؟ وإذا كان الجواب إيجاباً، فهل يصدر الكاتب عبدالله إبراهيم في سيرته هذه عن تجربة منصفة للمرأة أم أنه كان خاضعاً لمؤثرات الأنساق المضمرة للرؤيا الذكورية الكامنة في عمق اللاوعي عند الرجل الشرقي؟
هكذا يمكننا القول إن لغة الأمواج تصطخب بعنف وتتصاعد إلى أعلى مستويات التألق البلاغي حين يكون الحديث عن تجربته في مجال العلاقة الشخصية الحميمية الخاصة خارج مؤسسة الزواج، لكنها تكون هادئة وذات جوهر خبري وتتسم بنزعة عقلية مهيمنة حين يأتي ذكر الزوجة/اللفظ. وإذا كان هذا الفرق في الحديث عن العلاقة مع النساء نوعياً، فإن الفرق الكمي يظهر أيضاً في هيمنة الحديث عن التجربة العاطفية خارج مؤسسة الزواج، بشكل مطلق، بالقياس على الذكر الشحيح لعلاقته بالزوجة؛ فلا ذكر لأيّ عواطف عنها، ولا عن كيفية الزواج بها، أو حتى الفترة الأولى من الزواج. ونعتقد أن الإشارة للزوجة ضرورية بوصف أنها تمثلاً جزءاً مهماً من تجربة المؤلف سواء أكانت هذه التجربة سلبية أم إيجابية. وفي الوقت نفسه، تحظى العشيقة بعشرات الصفحات من الكلام التفصيلي المتدفق بالعاطفة والمشاعر الحميمة. وإذا كان يمكن لقارئ “أمواج” أن يكوّن صورة واضحة ودقيقة لشخصية العشيقة من النواحي النفسية والجسمية والاجتماعية لكونها قد حظيت بحضور واسع ومتكرر في عدة مواضع من الرواية، فإن الزوجة لا تحضر إلا لماماً وبلفظ “زوجتي” فقط!
علاقة الذات بنفسها والآخرين
لقد كان لتطور الوعي بالنفس وبالآخرين حضور مهم في أغلب أمواج الرواية؛ فكثيراً ما يتحدث عبدالله إبراهيم، من خلال مواقف حياتية مستعادة، عن حياته وعن مثقفين وأشخاص عاديين وزملاء عمل، فتتشكل شخصية المؤلف في النص بوصفها نتاج تفاعل بينه ومحيطه الثقافي والإنساني. وإذا كان موقفه من المرأة، كما رأينا، ذا جوهر يكشف عن هيمنة نسق ذكوري مضمر، فإن علاقته بالآخرين قد تمثلت في الحوارات الذاتية الداخلية التي عاشتها شخصية المؤلف وشكلت جزءاً مهماً من تجربته ووعيه الذاتي. فمثلاً، في فصل ثانوي له عنوان دالٌ، هو (افتراض المعرفة: تشريح مبكر لجهلي) يتحدث المؤلف عن الكاتب الراحل جليل القيسي وعن علاقته به. لكن الإشارة الأهم ترد على النحو الآتي “… دعاني جليل القيسي إلى بيته. تحدثنا عن أسمهان وعبدالوهاب وسيد درويش، وسلفادور دالي وشولوخوف، وانزلقنا إلى الحديث عن الأوضاع العامة، فلمست لديه تصوراً رومانسياً لأحوال البلاد، فقد تعلق بأوهام أيديولوجية. ولم ينظر إلى ما يجري في العراق إلا عبر منظور ضيق. وفي حياته، وأفكاره، وأدبه، وقع القيسي أسيراً لمقولات تجريدية أسرف في ترديدها، وكان يدرجها في قصصه، ومسرحياته. ووجدت فهمه للحرب ناقصاً، ونظرته نتاج قراءاته وليس تفكيره فيما نحن فيه، وكان يلزم نفسه بخليط من الشعارات الماركسية، والوجودية، ويسقط في التعميم غالباً” (ص 179). قد تنطوي هذه الصورة القلمية لشخصية جليل القيسي على الكثير من الوقائع المعروفة عنه، ولكنها ليست بالضرورة صحيحة، فضلاً عن أنها جاءت بصيغة كلامية قاطعة. ونلاحظ هنا أن المؤلف، وبدلاً من أن يقول “بدا لي جليل القيسي…” فيحيل إلى تصوره الشخصي الخاص للجوانب الفكرية من شخصية القيسي، فقد استخدم المؤلف، في تصويره لتلك الجوانب، الفعل “لمست…” ناقلاً تصوره من مجال الإدراك والتقويم العقليين لمجريات حديثه مع القيسي إلى مجال “اللمس” الذي هو من أفعال الحواس المتصلة بما هو مادي وملموس حتى يمنح حكمه على الشخصية الأخرى شيئاً من الموضوعية!
وحين ينتقل المؤلف للحديث عن رأي جليل القيسي فيه، يقول “كثيراً ما أكد القيسي أنني إنسان البعد الواحد الذي خلقته السلطة, مردداً عنوان كتاب هربرت ماركوز. وعزوت ذلك إلى أنه يفسر مواقفي وآرائي طبقاً لما تقوله الكتب. وبدا لي، وهو الكهل الذي يكبرني بعشرين عاماً، معزولاً عن إيقاع الحياة” (ص 179). وهذا الكلام عن انشداد القيسي إلى عالم الكتب والعزلة عن الحياة يضع شخصية القيسي في صورة سلبية تماماً. وبعد أن يؤكد الكاتب على حرصه على علاقاته مع القيسي، ينقل رأي القيسي فيه على النحو الآتي “لم يدَّخر [جليل القيسي] وسعاً في تذكيري بأنني أحد مسوخ النظام. ولم يكن أيّ منا مخطئاً في حكمه على الآخر، فقد اقتنعت بأمرين أصبحا جزءاً من ماضٍ مثل بطانة لمشاعري وذاكرتي: معظم ما قاله القيسي عني كان صائباً، فقد كنت أعدُّ نفسي فوضوياً، ولا حدود لحريتي و آرائي، لكن ذلك كان من الوهم الفردي، فقد كنت ضابطاً في جيش نظام مستبد” (ص 180). ولعلنا نلاحظ هنا أن الكلام يدور حول عملية تشكل الوعي الذاتي في عملية جدلية مع الآخرين. ونجد أن عبارة “لم يدَّخر وسعاً في تذكيري بأنني أحد مسوخ النظام. ولم يكن أيّ منا مخطئاً في حكمه على الآخر، …” تفصح عن إقرار على شيء من الصراحة بأن المؤلف يقرُّ أنه كان أحد مسوخ النظام في تلك المرحلة. ونلاحظ أيضاً أن ما قاله المؤلف في تقويمه لرأي جليل القيسي فيه إذ يقرر أن “معظم ما قاله القيسي عني كان صائباً” يمكن أن يقال أيضاً عما قاله المؤلف نفسه بحق جليل القيسي؛ فنقول “إن معظم ما قاله المؤلف بحق جليل القيسي كان صائباً.” وليس كل ما قاله، وذلك انسجاماً مع مبدأ نسبية الثقافة التي يصدر عنها كل متحدث في الشأن الثقافي الذي هو شأن خلافي بامتياز.
الغيمة المأساوية في “أمواج“

في عنوان ثانوي ذي دلالة “مات ولم يُقبِلني، فيا له من أبٍ استثنائي” يعود المؤلف إلى ذكرياته عن أبيه، وإلى تجارب نشأته الأولى في بيت يفتقر إلى الحياة المدينية. فهو نتاج زواج الشغار لأب مزواج، ونعرف هذه الحقيقة عن تكرار زواج الأب من خلال قول المؤلف عن نفسه أنه قد جاء من أم تصغر الأب كثيراً لأنها “أصغر” من بعض أخوة المؤلف نفسه. بيد أن المؤلف لا يعلمنا كم هو عدد زوجات الأب ولا عمّن كانت في عصمته حين تزوج والدة البطل، ولا عن عدد إخوته وأخواته غير الأشقاء. أما زواج الشغار فهو السائد في المناطق الريفية (“زواج الشغار”، أو نكاح الشغار نوع من الزواج كان منتشرا في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل وليته (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر وليته، وليس بينهما صَدَاق ولا مهر). ولكن الرغبة في تبرئة الأب من تهمة الانصراف إلى الجنس (أهو أمر أورثه الأب للابن؟) في قول المؤلف “وأينما بحثنا في تواريخ الشعوب نجد رغبة عارمة في السناء الصغيرات” (ص 20) وهو تعميم ثقافي لا نجد له سنداً ولا مسوّغاً غير ما ذكرناه من رغبة كامنة في الدفاع عن الأب. وهذا التعلق بصورة الأب ليس بالمستغرب، لذلك فهو يقرر “لم يشعرني أبي بالدفء والسكينة، فورثت صفاته، وتقمصت دوره مع أولادي” (ص 20)، فنكتشف أن المؤلف يكرر جوانب سيرة الأب على الرغم من أنه لم يلمس منه شيئاً من الحنان ومما يؤكد هذا الاستنتاج، قول المؤلف “لم يلمس أبي خدي بتحنان، وما ضمني إليه، وما تسرَّب إليَّ منه أيّ عطف، فلربما أكون ظلَّاً له، بل أنا كذلك”. وهنا يثور سؤال آخر عن دور الوعي في التخفيف من وطأة بعض الملامح السلبية للنشأة الأولى وأثرها على البطل حين صار رجلاً ذا ثقافة واسعة، وله أسرة وأطفال! أيجوز لنا هنا عدَّ التجارب الأولى سجناً للذات يمنعها من أن تفعل ما يناقض تلك التجارب أو يعمل على الخروج عليها؟ أم أن ذلك جزء من مظاهر انشطار ذات البطل وحيرتها بين مواقف مختلفة؟ وفضلاً عن ذلك، فقد شكلت مأساة فقد هذا الأب على نحو مفاجئ، ثم بعد ذلك فقد الأم عبر معاناة طويلة ومريرة مع مرض خطير التهم وجهها شيئاً فشيئاً، في وقت مبكر، جانباً مهماً من الوعي المأساوي للبطل/المؤلف. فموت الأب يمثل حالة مأساوية من القسوة والعبثية في انتزاع الحياة من شخص كان يفترض أن يواكب حياة البطل ويحيطه بشيء من الرعاية منذ طفولته الأولى وإلى حين بلوغه مرحلة الصبا والشباب. هكذا، تأتي وفاة الأب لتشكل الصدمة الأولى في الوعي المبكر من حياة البطل حين كان طفلاً. أما موت الأم فهو يمثل تجربة أكثر إيلاماً وقسوة لأنها أصيبت بمرض عضال في وجهها نتيجة رفسة على فمها، أعقب ذلك علاجها على يد رجل لا يفقه في الطب شيئاً مما يؤدي إلى إصابتها بمرض يذكر المؤلف أنه السرطان ولكننا نرجّح أنه الغنغرينا لعدم تطابق وصف المؤلف لما أصاب وجه الأم من تآكل أتى، ببطء وثبات، على أجزاء من وجهها مع وصف أعراض مرض السرطان. وقد دامت حالة الأم المرضية الميؤوس منها لأكثر من عام. وقد تولى الكاتب، حين كان صبياً، مصاحبة الأم في دورانها على الأطباء والأولياء بحثاً عن فرصة للشفاء. وبعد فقد الأم المأساوي ببضعة عقود، سوف تكتمل حلقة الفجائع حين يذهب المؤلف بصحبة أخيه وعائلته في سفرة للترفيه وزيارة الأولياء، وحين العودة، يقرر الرجال المكوث عند ساحل نهر دجلة، وهناك يبدأ أبناء الأخ بالسباحة، وينتهي الأمر بغرق اثنين منهم! وكأن القدر يهزأ بالإنسان فيهدم ملذاته ويحيل أفراحه أتراحاً.
إن الحديث في القضايا العرقية الحساسة وعمليات التغيير الديموغرافي من أكثر المشكلات المعقدة التي يواجهها من يكتب سيرته الذاتية. وهذا هو ما واجهه عبدالله إبراهيم حين تحدث في مسألة تعريب كركوك. يقول الكاتب “بدأت سياسة تعريب كركوك في سبعينات القرن العشرين، فزرعت الخوف بين الأكراد والتركمان، وأثارت استياء العرب الأصليين فيها، فقد جيئ بأعداد من عرب وسط العراق وجنوبه، وأسكنوا في المدينة، أو في ضواحيها، وفي بعض حلّوا محل أهلها. وحينما استبدَّت بالأكراد الأفكار القومية اعتبروا المدينة كردية، وقد أثار سعيهم إلى تكريدها، بدفع أعداد كبيرة من الكرد إليها بعد الاحتلال الأميركي في عام 2003، مخاوف التركمان من طمس ما يذهبون إلى أنه هوية تركمانية للمدينة؛ كونهم يمثلون الكتلة الصلبة في قلبها من وقت بعيد، ورفض العرب عملية التكريد مع أنهم لم يقولوا بعروبة المدينة” (ص 17). وإذا كان ما دونه المؤلف يمثل شهادة مهمة بخصوص عملية التعريب فالتكريد، فإننا نلاحظ هنا أن السرد التاريخي لعمليتي التعريب ثم التكريد لم يتوخ الدقة فيما أورده من وقائع. فمحاولات تعريب كركوك تعود إلى مرحلة الحكم الملكي. ففي وثيقة من محاضر مجلس البلاط في العام 1929، نقرأ المقتطف الآتي “… إن هؤلاء العرب بعيدون بدرجة أنهم لا يمكن أن يعبأ بهم من الوجهة السياسية في التأثير على رأي اللواء، وفي لواء كركوك، كما في لواء أربيل، لا يوجد عنصر راق من العرب ينتمي الى المدينة لكي يمكن الاستناد إليه في تعريب اللواء”، وهذا النص منقول بتوثيق دقيق ومذكور في كتاب د. كمال مظهر أحمد “كركوك وتوابعها: حكم التاريخ والضمير” (ص 78). وما يهمنا هنا هو أن محاولات تعريب كركوك أقدم بكثير من التاريخ الذي أورده الكاتب. وهو أمر ارتبط بنشوء الدولة العراقية واكتشاف النفط في كركوك في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين. أما بخصوص أعداد السكان في مدينة كركوك، وهل كان الأشقاء التركمان يشكلون العنصر السائد فيها، وهو ما رجحه بطل “أمواج”، فقد كان بإمكان الكاتب أن يعود إلى معطيات الإحصاء السكاني الذي أجري في العام 1957 حتى يكون كلامه أكثر دقة ومدعماً بالأرقام.
ختاماً أقول إن رواية “أمواج” لم تستوفِ سيرة كاتبها بالكامل؛ ذلك أن بطلها ما زال حياً ماثلاً بيننا، وما زال كثير من الأمواج في طور التشكل والظهور الآن وفي المستقبل.