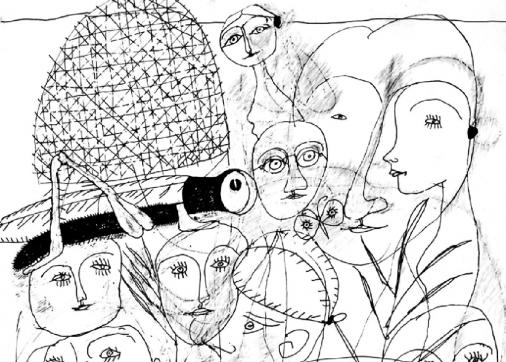الإصلاح التربوي والتردي اللغوي

شهد الأصدقاء والأعداء المختصّون بتعثّر مدارسنا العربية؛ وهذا عبر تلك الإصلاحات التي لم تقم على استراتيجية ناجعة، ولا على مفهوم عملي وواقعي، ولا على نظريات مبنية على الشمول، ولا على الامتداد في الزمان، ولا على الامتداد في المكان، ولا على الاستناد على نظرية علمية، ولا قبول للتكيّف، ولا استطاع المُريدون إنتاجَ الأفكار التي تقدّم لصاحب الحلّ والعقد استصدار القرار، ويضاف إلى ذلك أنّ الإصلاحات التربوية في معظمها لم تعتمد على الثّقافة الوطنية المبنية على سيادة الثّقافة العلمية، ولا على نظريات من واقع حال البلاد العربية، فاعتمدت نظريات مستوردة من واقع لا يعاني أزمات، إلى واقع مُتهرئ موبوء بالصعوبات، ولم تنظر الإصلاحات للمدرسة على أنّ لها مسؤوليةً تحرريةً تجاه القيود والجهل والفقر والأميّة، باعتبار المدرسة تُعطي الحدّ الأدنى من التّفكير والنقد والاختيار الحرّ، وتربّي في المواطن روح التّواجد والمواطنة وقول (لا) في حال الخطأ، ولم تعمل المدارس العربية على صيغة التّواصل بين الأجيال، ولا غذّت في المتمدرسين قبول الرأي الناقد، وما يتبع ذلك من روح التّواصل مع الآخرين بالاستماع للرأي المخالف… ولذلك يمكن أن نقول: إنّ المدارس العربية تكون قد أعطت العلم إلى حدّ ما، دون أن تعطي/تعلّم الأدب، وبذا تعثّرت الإصلاحات التّربوية، ومسّت كلّ القطاعات، فشلّت مفاصل الدول العربية في مناحي الحياة؛ فتراها تجري وراء التّجارب والإصلاح، ولم تستطيع أكثر الدول العربية الوصول إلى بناء منظومة تربوية معاصرة، تجمع بين الأصالة والحداثة في منظومة متوازنة تعطي العلم والأدب، ولذا آن الأوان لمراجعة تلك الإصلاحات، والنظر في التّفريطات، التي مسّت كلّ الهُويات، ومنها الهُوية اللّغوية التي هي أمن عام فلا أمن مائيا دون أمن لغوي، ولا أمن عسكريا دون أمن لغوي.
تقول الدراسات الجادة بضرورة إعادة النظر في ما رسّخته المنظومات التربوية العربية من طغيان الفكر الغيبي، ووهم التّنظير، وعبادة الخطاب الماضوي، واعتماد ما يشلّ الفكر.. وحصل هذا بفعل تلك الإصلاحات التي تنظر للتّربية والتّعليم على أنّه قطاع غير خدماتي وغير منتج وعقيم، فلا ترى الفائدة من تغييره، فهو خارج الأطر والمضامين. ونحن نجهل بأنّ تقدّم الأمم يُقاس بمقدار ما تنتجه المدرسة من معارف؛ وما تتّسم به تلك المعارف من أصالة وجدّة وابتكار، وما تحمله من فكر يعمل على انسجام تربوي ولغوي يعمل على لحمة مجتمعية تَسُود فيها المواطنة قبل المذهبية.
يجب العلم بأنّ المدرسة سفينة المجتمع نحو برّ الأمان، فكيف حصلت فنلندا على الرتبة الأولى في التقدّم؟ لم يكن ليحصل لها ذلك، لو لم تهتمّ بالمدرسة، وبالعدالة الاجتماعية، وهو بلد امّحت فيها الأميّة وانعدم فيه المرضُ، فلم يكن ذلك ليحصل في بلد الماء والأشجار، وفي بلد لا يملك البترول والغاز، ولكنّه حصل بفضل الاستثمار في التّنمية البشرية، فأضحت فنلندا رقماً راقياً تُضرب به الأمثال في التّرقية البشرية. وما يقال عن فنلندا يقال عن أيسلندا، ويمكن أن نعطي مثلاً لبلد آخر وهي جزيرة منعزلة (كوبا)؛ كان الجهل والمرض والفقر يفتك بأهلها، ولكنّها تجاوزت كلّ هذا بالاستثمار في التنمية البشرية، وبذا حصّلت الرتبة الأولى عالمياً في مجال الطبّ، فأصبحت كوبا الآن تصدّر الأطباء المتخصّصين وكبار الجرّاحين إلى البلاد الراقية، ولم يكن يحصل ذلك لو لم تستثمر في التّربية والتّعليم، دون الحديث عن العملاق ماليزيا وبلد اليابان والنّمر الآسيوي كوريا الجنوبية؛ وهذه الأخيرة ترتّب تاسعة في الاقتصاد العالمي، وتنافس الآن الولايات المتّحدة في صناعة النانوتكنولوجي. دول قديمة وعريقة في الحضارة، استثمرت في البشر، فلم تعرف التخلّف وأخرى حديثة كانت متخلّفة، فخرجت من التخلّف بفعل استثمارها في المدرسة، وحصل لها التقدّم والرقي. إذن يقع الرهان حالياً على الاهتمام بالتّربية والتّعليم، رهان تتسابق الأمم فيه بغية الوصول إلى الجودة والفعالية لرجال القرن الحادي والعشرين، دولٌ تعمل على صنع مدرسة مواطنة تؤمن بالعلم، وتعمل من أجله، دولٌ تقيم مدرسة تقضي على التعصّب والأمراض والانحرافات والعنف وكلّ ما يجعل البلد تنهكه الأزمات، فهل يمكن أن يحصل في واقعنا العربي؟
من المعلوم أنّ الحراك العربي في اتّجاه إحداث التّغيير في المنظومات التّربوية مطلب جماهيري جديد يعمل على التثوير، وعلى بناء مدرسة معاصرة تعمل على التّغيير في الذهنيات؛ بحيث أنّ صيرورة كلّ تنمية قوية مُستدامة تتطلّب تعبئة الرأسمال البشري الذي يجب أن يكون متعلّماً وصحياً ويقبل الدخول في مجتمع المعرفة، وهذا لا يكون خارج المدرسة، ولكنّها مدرسة معاصرة، ولهذا بدأت الدولُ العربية الآن تعي الدور الجديد للمدرسة وهو إنتاج المعرفة، وإعداد النشء للقرن الحادي والعشرين؛ قرن التّفاعل الذاتي، قرن المقاربات التّربوية العاملة على التعلّم الذاتي وعلى مدى الحياة. ولكن مع رفع مطالب الإصلاح التربوي، والدعوة إلى مدرسة عربية حديثة، هناك عقبات كثيرة في الأخذ بأسباب نجاح الإصلاحات التربوية، التي تتوزّعها أطراف متنافرة في الرأي والتوجّهات، أطراف مُتخمة نائمة لا تريد الإصلاح، وأطراف تابعة تعتمد على استيراد المنظومات التربوية، ففي ظلّ هذا الوضع هل يمكن أن تنجح الإصلاحات أو مطالب التّغيير لدى شعوب الدول العربية التي دبّت فيها الهزيمة من شحوم الرّيع والخزينة، وممّن هم في مراكز الديمومة، وسفينة العرب توقّفت عن الإبداع في محطّة الإقلاع، ولم تعد تجدي نفعاً في تغيير السائد، وفتح مغاليق الحاضر المارد، وآسف أن أقول: لا تنفع إصلاحات تربوية تتناول وصفاتها بالتّفسير، دون أن يطرأ عليها التّطوّير والتّغيير، ولا يرصد مسارها التّقرير، ولا يتتبّع عوامل سيادتها التّبرير، لأنّه لا يتلمّس الواقع المرير، ولذا قد يعدم التّغيير.
مدارسنا بحاجة إلى إصلاح جوهري يعمل على تطوير الرأسمال البشري، وهذا هو الناقص فيها فلم تعد مدارسُنا سوى بؤرٍ لإشاعة إعاقاتِ وتناسلِ حلقات الإخفاق، وهذا ما جعل تقارير التّنمية البشرية تُشير على العرب بضرورة إعادة النظر في منظوماتها التربوية
إنّ القرن الحادي والعشرين يسعى للجودة في التّربية والتّعليم لنقل المجتمع من مجتمع القبيلة إلى مجتمع المعلومات؛ مجتمع تكون فيه المدرسة عاملة على مواطنة إيجابية تنحو في اتّجاه بناء التلاحم الإنساني وتستوعب اللحظةَ الكونية التي نعيشها، والاعتراف بجميع الرموز اللّغوية والثّقافية والتاريخية والوطنية والمساواة بينها، والاتّجاه إلى مستقبل يُغذّي مواطنةً لغويةً تُؤمن بالأبعاد المحلية، وتنفتح على المعارف والقيَم العالمية. ومن هنا فالشرعية والديمومة والبقاء أن تكون للإنسان بما هو إنسان من حيث ما يكتنزه من معارف، لا إلى الإنسان باعتباره صاحب الأصول والفضول وأصحاب النفوذ، فهل يمكن أن نعي هذا قبل خوض ميادين الإصلاح التّربوي، وأنّ أهل الميدان قبل أهل الثقّة، وهل يمكن لمدارسنا أن تربّي مفاهيم التّسابق للأفضل؟ وبذا تأتي مهمّة مدرسة الإصلاح في الوقت المعاصر للرفع من مستوى المعارف وربطها بقيم الانفتاح، وتحديث المجتمع بما يستجيب لكلّ المرجعيات الرسمية. فالمدرسة العربية الآن بحاجة إلى تدبير جديد؛ يبدأ من إعادة النّظر في الرؤية التي تنظر بها إلى المعارف والقيَم المحلية والوطنية والكلية، والتفتّح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإنسانية، وتكريس حبّ المعرفة، وطلب البحث والمساهمة في تطوير العلوم، وتنمية الوعي بالواجبات والحقوق والتربية على المواطنة، وممارسة الديمقراطية، والتشبّع بروح الحوار، وقبول الاختلاف، وترسيخ قيم الأصالة والحداثة، والتفتّح على التّكوين المِهْني المستمرّ.. فهل تُحقّق هذا مدارسُنا العربية، أو تعمل الإصلاحات التربوية على تحقيق هذا في برامجها؟
إنّ مدارسنا بحاجة إلى إصلاح جوهري يعمل على تطوير الرأسمال البشري، وهذا هو الناقص فيها فلم تعد مدارسُنا سوى بؤرٍ لإشاعة إعاقاتِ وتناسلِ حلقات الإخفاق، وهذا ما جعل تقارير التّنمية البشرية تُشير على العرب بضرورة إعادة النظر في منظوماتها التربوية “إنّ ثمّة اتّفاقاً واسع النطاق على أنّ النظم التربوية في العالم العربي بحاجة إلى تحسين، إذ يذكر تقرير البنك الدولي الصادر في العام 2008 أنّ هناك فجوة بين ما تقدّمه أنظمة التّربية في البلدان العربية وحاجات التّنمية وأهدافها. كذلك فإنّ تقرير التنمية البشرية العربية الصادر عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي للعام 2002 يشدّد على أنّ هناك أدلّة على تدهور نوعية التّعليم في المنطقة.. ويحثّ بلدان العالم العربي على التّفكير المعمّق في كيفية تنظيم التعليم على نحو أفضل لضمان التطوّر المستدام للقدرة على المنافسة في اقتصاد عالمي مُتغيّر ومُتطوّر[1]“. فإذا كان الحال هكذا، فهل من المأمول أن يحدث التّغيير والتّفعيل داخل هذه المنظومة، وفي ظلّ الوضع المجتمعي الذي لا يعطي ربع الميزانية التي يعطيها للكرة؟
ومنظومتنا التّربوية في الجزائر واحدة من تلك المنظومات العربية التي عرفت الشّلل والانحدار والهزال في المُخرجات منذ الإصلاحات التي بدأت في أواخر التّسعينات حتى تكريس الإصلاحات الجذرية في عامي 2003/2004 م، والخطرُ يكبرُ سنةً بعد سنة، ويظهر الفسادُ في شريان المجتمع بفعل عدمِ الاهتمام بالتنمية البشرية التي عمادُها المدرسة؛ فالمدرسة عندنا لم تعدْ جاذبة، ولم تفلح في تربية الطفل: عنفٌ في المدارس، عنفٌ في الملاعب، غشٌّ في الامتحانات، فقدانُ الاحترام للمعلّمين والأولياء، شللٌ في الإرادات، البحث عن الربح السريع، فقدان المناعة في التأثير، الانقياد لمن غلب، وفي تنفّس شبابنا التّعب، حلم المعلّم الإضراب، واختزال عمله في رفع الأجور.. بَلْهَ الحديث عن جودة التعليم التي لا وجودَ لها. فالمدرسة أصبحت لا تلقّن التلميذ إلاّ الكميّة القليلة من المعلومات، بفعل تزايد العطل والراحات؟ فتلميذنا لا يقرأ إلاّ 18 أسبوعاً في السنة، في الوقت الذي يقرأ التلميذ في العالم بين 34 و36 أسبوعاً في السنة وعتبتهم البرنامج الكامل، لا عتبة الثلاثي الأول والثاني[2] كما هو عندنا، ويتوقّف تلاميذنا عن التّدريس في نهاية أبريل من كلّ سنة. فإذا وقفنا في رقم 18 أسبوعاً نستخلص ما يلي:
18 أسبوعاً = من أصل 51 أسبوعاً = ثلث السنة للتدريس.
18 أسبوعاً = يساوي 3 أشهر وزيادة زمن التدريس = 16 درساً في كلّ حصة.
18 أسبوعاً – 51 = 33 أسبوعاً للراحة = 33 درساً ضائعاً.
33 أسبوعاً = 8 أشهر راحة.
18 أسبوعاً ليست كاملة، وينقص منها: التّخفيض في حصص رمضان+ غيابات المعلّم+ أيام الامتحانات+ إضرابات.. فماذا يدرس التلميذ؟ ودون تعليق كبير، فإنّ منظومتنا القديمة يكون التلميذ في المدرسة من سبتمبر إلى نهاية جوان، ومع هذه الإصلاحات التّربوية دامت العطل فعاشت، فهل هذا هو المطلوب من الإصلاح؛ تكريس العُطَل في العُطَل؟ ويضاف إلى هذا الهزال، ذلك الضغطُ الذي يمارسه التلاميذ على الإدارة، وتلك الإضرابات التي يقوم بها المعلّمون لنيل حقوقهم، ونقص أستاذ مواد أساسية وعدم وجود مدرّسي اللغة الفرنسية في الجنوب.. إصلاح في هدر اللّغات، والتقليل من الواجبات، وكثرة الطلبيات. إنّها فوضى حاصلة في إصلاح مُتعثّر، إصلاح أتى بالفشل الذريع، فتعطّل الجهدُ في صورة عكسية، إصلاح تربوي مصدر كلّ الخسائر؛ لأنّ التّعليم في الأساس هو التّدبير الجيّد في كلّ دواليب الدولة فاختلطت الأزمنة في هذه الإصلاحات التي لم تربِ التلميذ على الأدب، ولا على اغتنام الوقت فأين الوقت من ذهب. وإذا كانت المدرسة ترخّص هدر الوقت وتمدّد العطل، فأين ذلك المعلّم أو المسيّر الذي يكون أحرص على الوقت واستدراك التّأخير. وإنّه لم يعدّ معلّم الإصلاحات ذلك المعلّم القنوع الذي يعمل في الظلام دون كلام، فمعلّم الإصلاحات لا يُسبّق الشأنَ العامّ على الخاص وكلامه لا يخرج عن المطالبة بالحقوق قبل الواجبات، وتفكيره في الراتب والمردوديات، فلم تحصل المواطنة للطرفين، فضعف الطالبُ والمطلوب، وتدهورَ المستوى، وزاد الضعف على الضعف، واشتعلَ الفسادُ، والفساد في المنظومة التربوية أشدّ فتكاً.
ويظهر الفسادُ في الكتاب المدرسي؛ ومدوّنتي في هذا القول كتاب اللّغة العربية وكتاب التّاريخ، كتابان يجعلان المتعلّم شبه ببغاوي لا يفهم أيّ لغة، ولا يدرك تاريخ بلاده، ولا يستطيع أن يكون مثل الشامبانزي في التقليد، كتابان مليئان بالشوائب؛ يقدّمان مادة النّصوص الأدبية والتاريخ بخيستين، والحضارة العربية الإسلامية رخيصة، والسّكوت عن تاريخنا القديم، وفعل الحركات الوطنية، ويقفان عند حدود ضيّقة، وكأنّ الجزائر حديثة العهد في امتلاك العربية، وأنّ تاريخها ليس من الماضي، أو أنّ الماضي من سقط المتاع، وهذا بخس للثقافة الوطنية، ولتلك الانتفاضات النضالية، وما عرفته الدول الأمازيغية الثلاث عشرة (13) من تطوّر وحضارة. وأضيف إليهما كتاب التّربية الإسلامية الذي لا يمجّد الدين، ولا يجلّ الحديث الشريف، ويُسقط كلّ مفردات يرى فيها الإرهاب، وكأنّ الدين الإسلامي إرهاب، وهل نحن في دولة لائكية مِتعاب. كتاب سطحي بسيط لا يعمل على تحريك التّفكير، ولا يحمل قارئه على التّدبير، ومفرداته من كلام العامة وخطب الجمعة، وبه أخطاء ظاهرة. كُتبنا المدرسية بها مجموعة من التبخيسات؛ نالت أعراض المنظومة التربوية، فلم تعطِ المتعلّمين حقّهم من أن يعرفوا بأنّهم أمازيغيون عرب مسلمون، ولهم تاريخهم الحافل القديم، فأين مستوى تقوية الوعي بالذات الجزائرية؟ وأين المواطنة في صورتها العامّة؟ ومن ذلك فإنّ آليات الإفساد تكبر بإتقان، وتقدّم آليات الانتصار التي تُعمي صاحب القرار. كُتبنا التربوية كسولة تعتمدها الدولة دون منافسة، وليس لها حقّ إبداء الرأي في صنّاع الكتب، ولا في أشخاص عيّنتهم، أو في لجان نصّبتها، وكلّ لجنة لا تسير وفق رغبات المسؤول تُستبدل بلجنة موالية، فهذه هي الخرافة والسراب في أرض بقيعة لا تمطر إلاّ الأتعاب.
ضعفٌ لغوي في اللّغات الثلاث، لا يستطيع الطالبُ كتابةَ جملة صحيحة، دون الحديث عن الفرق بين العدد والمعدود، والأمر أدهى عندما تطالبه بكتابة عريضة ما، فلا يدري كيف يكتب حتى البداية.. كوارث لغوية لا يمكن تعدادها
وإذا أتينا إلى التّسيير فنجد حذف التّعليم التّقني الذي هو عماد التّصنيع، بدعوى أنّ هناك وزارة التّعليم والتكوين المِهنيين، وهذا غرور في غرور، أليس كلّ دول العالم فيها التّعليم التقني في المرحلة المتوسطة وفي الثانوية، ويوجّه له أفضل التلاميذ، والأدهى من هذا أنّ الطلبة الذين يوجّهون إلى التّكوين المهني عندنا من المطرودين، ومن ضعاف التلاميذ، والذين لا مستقبل لهم لأنّهم فاشلون في التعليم العام فهل يفلحون في التّمهين. دون الحديث عن تلك الآلات المستوردة بالعملة الصعبة، ويأكلها الصدأ قبل الاستعمال، بل ترمى في مقبرة القصدير، فلا محلّ لها في التّعليم العامّ. وسوء التوجيه يظهر في أنّ كلّ التلاميذ يذهبون إلى العلوم، كأنّنا نعدّ لمعركة التّطبيب أو لخوض البيولوجيا النّووية التي تحتاج إلى جيوش من الطلبة، أليس هذا انتحارا مُعلنا لمنظومتنا. وإذا تحدّثنا عن المناهج التربوية فنجدها عروشاً مسندة؛ تجسّد التخلّف في البرامج المدرسية بمفردات لا علاقةَ لها بالواقع، وبنصوص مصطنعة منسوخة من الشابكة، فغاب النصّ الأصيل، وحضر النصّ الهزيل، نصوص لا تترك للتلميذ حرية القرار أو التفكير، فقد أبعدتْه عن الأصالة، ولم تمكّنه المعاصرة؛ فبقي التلميذُ تائهاً وَلْهَاناً، لا يعرف مقامَه فأصبحَ حَيْراناً.
إصلاح لم يرقَ للمستوى الشكلي، بلهَ الحديثَ عن مستوى المضمون، ولَمِسْنا بِدامغ البرهان مدى المفارقات الكبيرة بيننا وبين جيراننا في بناء المناهج وفي ما يحمله من مواد، وما يعطيه للمتعلّم من معارف. أليس من العيب على امتداد أربعة عقود، تمّ اقتراح إصلاحات كانت في مجملها صالحة، وعادت على أجيالنا بالفلاح، ولم تؤدِّ إلى الكارثة رغم ما فيها من مشاكل تربوية، ونقص في الوسائل المطلوبة، وكان ذلك في ظروف التهيئة والبداية، فما أصعبَ البداية، ولكن في لحظات التقدّم المعاصر، وفي الألفية الثالثة التي نجد فيها إمكانات هائلة وأجهزة متطوّرة، نعود القهقرى بسرعة عجيبة، ونتراجع عن المكتسبات القبلية، فأين الخلل يا تُرى؟
وإنّي لست بصدد تسويد وضعية الإصلاحات التّربوية في مجال الهدر العامّ، بل إنّ عدم التّحكّم اللغوي أسوأ، فإذا نظرنا إلى الواقع اللّغوي فنراه مراً، وأنقل للقارئ بعض المشاهد الحزينة لا من النظريات لأنّ النّظرية في أصلها تحمل النقيض والشكّ، بقدر ما أعتمد الواقع والثابت علمياً، وبعض ما أقول مستخلص من دراسات ميدانية، ومن خلال كوني مدرساً للغة العربية منذ سنة 1984، وَوَلِي تلميذ كذلك؛ فلم أشهد ذلك الانحدار اللّغوي إلاّ مع دفعة الإصلاحات التي عتبت الجامعة سنة 2011 م، وهذا في ولاية تُعدّ الأولى في مستوى النّجاح في الباكالوريا، ويعني أنّ ولايات أخرى تسونامي لغوي حقيقي.
ضعفٌ لغوي في اللّغات الثلاث، لا يستطيع الطالبُ كتابةَ جملة صحيحة، دون الحديث عن الفرق بين العدد والمعدود، والأمر أدهى عندما تطالبه بكتابة عريضة ما، فلا يدري كيف يكتب حتى البداية.. كوارث لغوية لا يمكن تعدادها، ونحن نقول: إنّ نسبة النجاح في الباكالوريا 70 بالمئة وأنّ عدد الحاصلين على درجة امتياز تجاوز خمسة آلاف، أليس هذا تضليلا وخرافة، أو هذا هو نجاح الإصلاحات. كان عليّ كباحث أن أقول الحقيقة التي هي مُرّة، ولكن عسى أنّ النقد البنّاء يعمل على التّغيير، وأنّ الأمم التي تقبل النّقد هي التي تنجح في الإصلاحات. وفي ذات الوقت لا يجب تعليق فشل الإصلاحات التّربوية على مشجب وزارة التّربية، رغم أنّها تتحمّل النسبة الكبيرة من الفشل، ولكن إذا كانت وزارة التربية تملأ القربة من فوق ووزارات أخرى تثقبها من تحت، فأنّى للقربة أن تُملأ! إذن كان يجب أن تكون الإصلاحات شأن كلّ الوزارات والمجتمع المدني بكلّ فئاته، لأنّ المرضَ الذي سرى في المدرسة كانت مصادرُه متعدّدةً، دون الحديث عن تلك المتطلّبات الشرسة للعولمة المتأسّسة على تنافسية قوية إلغائية، وهناك الرأسمال البشري غير مؤهّل وغير قادر على الخلق، فالمجتمع بكلّ مؤسّساته في وضع غير مريح، وبذا كانت التّربية في وضع متدهور، بل في مرحلة تنذر بالخطر، ولا يمكن أن ننكر أنّ التّدهور الذي ينخر هذه المنظومة بدا شرساً منذ تعدّد النقابات، التي اختزلت مطالب المعلّم في رفع الأجور دون توقّف، نقابات تشعل التمرّد، ولا تطالب بتحسين الفعل التربوي ولا رفع المستوى العلمي، ولا الاهتمام بالتلميذ من الناحية الصحية والعلمية والثقافية، فنجد بعض النقابات ترهن أولادنا لمستقبل مجهول، باغتنام الأوقات العصيبة للإضراب، وتُساوم على رفع الأجور؛ باتّخاذ التلميذ رهينة.. فالوضع التربوي عندنا يعيش الخطر، فما العمل؟
وإزاء الوضع الخطير لا بدّ من منطق مغاير أو جديد؛ حيث نبدأ الحديث عن مهمّة الإصلاح التربوي التي هي مهمّة الجميع، وذلك يتطلّب تضافر جهود الجميع، فالإنسان لا يكون إلاّ بالتربية كما قال كانط Emmanuel Kant “إنّ الإنسان لا يمكن أن يصبح إنساناً إلاّ بواسطة التربية، إنّه ليس سوى ما تجعل منه التربية” فالوضع المعاصر يقتضي إصلاح الإصلاح La réforme de la réforme إن لم نقل إصلاح يقتضي عقلنة المدرسة Repenser l’école وإنّه ينبغي ألاّ يكون الإصلاح من أجل الإصلاح وخاصة أنّ قطاعَ التّربية والتّعليم قطاع مركزي؛ يمتاحُ منه كلّ المواطنين؛ فنجاحه إصلاح لكلّ المجتمع.
ـ مواطن الخلل في الإصلاحات: ينصّ بند الإصلاحات في ميدان لغات المدرسة الجزائرية على: ترقية اللّغة العربية/ الرفع من مستوى أداء الفرنسية/ الاهتمام بالأمازيغية. وسأقف وقفات نقدية في هذه اللّغات، وكيف حصل الانتكاسُ اللغوي في إصلاحات 2003/2004. ومهما قلتُ فإنّه لا يمكن الحديثُ عن مقام اللّغات الوطنية في مدرسة تُعاني أزماتٍ متلاحقةً في تدهوُرِها؛ تدهوُر أدّى إلى اليأس داخل منظومة مريضة بعد ما يقرب من عقدين من التجارب الفاشلة، فطالتها يدُّ العبث والتّجارب المستوردة، وبعضها كانت قديمة، وبعضها وقع التراجع عنها في بلاد المنشأ، ونحن لا نزال نطبّل لها بالمزمار، ونرقص على انهزامنا المُنهار، وفي عدم تمكّننا بناء نظرية للإصلاح التّربوي المِسوار. ولهذا وقع التراجعُ عن مكتسبات قديمة فأُعيبت العربيةُ، وسكتَ عن الأمازيغية، وقويَ نفوذُ الفرنسية. فلم يتمكّن الإصلاحُ من إعطاء الوضع المريح للعربية ولا للأمازيغية، بل أولاهُ لتعليم الفرنسية التي تنال مساحاتٍ يوميةً على حساب العربية والأمازيغية، ومع كلّ ذلك فإنّ الفرنسيةَ بقيت مركزيةً لا تغادر مدارس المدن، وبقي تلاميذُ الجبال والجنوب دون معرفة الفرنسية التي هي قدرهم رغماً عنهم.
1ـ الّلغة العربية: هي اللّغة الأمّ/ لغة الأمّة/ لغةُ الانسجام المجتمعي، واللّغة الرسمية دستورياً، لغةٌ عملت الدولة على إقامة المؤسّسات التي تعمل على ترقيتها، فهي رأسمال الجزائريين، فلا تأهيلَ لهم دون تأهيلها والنهوض بها وبمكانة ألسن الهُوية الوطنية والأجنبية. وكان علينا العمل على تجديد متنها وتطوير أدوات البحث والتعليم والنهوض بمكوّناتها، وتثمين الذات العاملة على المتون اللغوية، والعمل على الترجمة منها وإليها، والعمل على استصدار الدعم السّياسي؛ لأنّ الدعمَ المجتمعي ثابتٌ ولا مناقشة في خصوص العربية في المجتمع الجزائري. إنّ إصلاح 2003/2004 يقتضي ردّ الاعتبار إلى العربية، والرفع من مردوديتها، وجعلها لغةَ الجودة، لكن نرى الكفايةَ اللغوية عادت للغة الأجنبية التي أُنزلت من السنة الرابعة ابتدائي إلى السنة الثانية، ويَسْتَبْدِل الإصلاحُ الرموزَ العربية باللاتينية، ويعدمُ الإشارةَ إلى تعريب العلوم في الجامعة، ويقدّم لنا منهجيةَ العمل “بلسانية متوحشّة تنتج الأمية[3]” فهل نطلق على هذا الإصلاح إصلاحاً، وهو يفترس الّلغات الوطنية افتراساً. إصلاح يعمل على تمكين هيمنة الفرنسية كلغة عمل وتواصل ويختزل إصلاح العربية في ترقيتها؛ كأنّها لغة متخلّفة، فالتخلّف في عدم العمل فيها وبها، والتّخلّف لا يكمن في اللّغة بقدر ما يكمن في أهلها. فكيف يمكن للتلميذ التحكّم في سجليْن لغويين مختلفيْن، وهو يعتب أبواب المدرسة، وفيها منافسة غير شريفة؛ منافسة تدعو إلى تفضيل اللّغة الأجنبية على اللّغات الوطنية. وتنصّ أكثر الدراسات والبحوث الميدانية القديمة والمعاصرة بأنّ التلميذ عليه أن يحتكم إلى الصَّوْرَنة الشكلية للغته في السنوات الأربع من الدراسة بحيث: يقرأ ـ يكتب ـ يعبّر ـ يحاور ـ يعدّ، وهذا عبر إغماس لغوي في لغته الرّسمية، ثمّ يمكن أن يتعلّم أكثر من لغة. وإن لم يكن هذا، فمثالنا على ذلك الدول المتقدّمة مثل مجموعة الدول الثماني التي تعلّم اللّغات الأجنبية بعد أربع/خمس سنوات من دراسة اللّغة الأمّ، وبعضها تُؤخّرها إلى المرحلة الإعدادية، ولا نكتفي بهذا، بل تتيح الدولُ المتقدّمةُ لِوَلِي التلميذ قائمةً من اللّغات الأجنبية التي يختارها، ولا تَفْرِض عليه لغةً أجنبيةً واحدةً. ألا يكفي هذا حجّة لتأخير تدريس اللّغات الأجنبية؛ حفظاً لمتن اللّغة العربية، أم أنّ السّعودية/الأردن نماذج على هذا التّقديم، فنسأل هل السّعودية/الأردن من الدول المتقدّمة؟ وما هو التقدّم الذي أحرزتاه؟ وفي أيّ مجال؟ ألا يجوز أن نقيس على فرنسا ـ كوريا ـ اليابان ـ أميركا ـ بريطانيا ـ الفيتنام؟
لا يمكن الحديثُ عن مقام اللّغات الوطنية في مدرسة تُعاني أزماتٍ متلاحقةً في تدهوُرِها؛ تدهوُر أدّى إلى اليأس داخل منظومة مريضة بعد ما يقرب من عقدين من التجارب الفاشلة
إصلاح تربوي لم يحصل الجهر فيه باعتماد الفرنسية التي هي لغة الخفاء والقرار، والعربية لغة المظهر والشكل، فلم يحصل الحسمُ في المسألة اللغوية “.. والحسم جذرياً في التوجّه في الاختيار اللّغوي، إما اعتماد لغة أجنبية-فرنسية، وجعلها الوسيلة الأساس للتواصل الشكلي والمؤسّساتي والتّحصيل العلمي وهذا الخيار لم يعد وارداً في ظلّ ما تعانيه الفرنكفونية من تراجع، وعدم القدرة على رفع تحدّي التّنافس اللّغوي العالمي. وإما تقويم العربية وتمكينها من فرض نفسها كلغة رسمية فعلية وليست فقط شكلية للبلاد في الإدارة والتعليم، دون إهمال اللّغات العالمية طبعاً، وفي مقدّمتها من الآن فصاعداً الصينية ثمّ الهندية؛ اللتان من شأنهما أن تفتحا للمتلقّين آفاقاً واسعة في المستقبل القريب”[4].
أليس من حقّ المواطن أن تضمنَ الدولة حقوقَه اللغوية وحقوقَ لغته الأمّ؛ فتحميها وتؤهّلها، وهي مسألة ديمقراطية تعمل بها كلّ الأمم الحيّة، أليست اللغةُ الوطنيةُ استقراراً نفسياً وطمأنينة واعتزازاً بالذات. إنّه إصلاح تربوي جزائري لا يتبنّى النّظرية الأفقية للمجتمع، بل يتبنّى نظرة عمودية بغية الوصول إلى تنخيب المجتمع: نخبة مركزية وجماعة الدهماء والغوغاء، وهذا ما يعود بنا إلى سياسة الكولون، ولعهد مَضَى. واعتباراً لكلّ هذا، فالدولة الجزائرية مطالبةٌ بوضع تخطيط يُنزل اللّغاتِ الوطنيةَ المنزلةَ الأعلى، وتكون اللّغاتُ الأجنبية على الخيار، فلا تُفرض على المجتمع الجزائري لغةٌ من اللّغات هي الأولى أو الثانية، وهذا ما تفعله الأمم الحيّة.
وإنّ الدولة الجزائرية مُطالبة بحماية اللّغة الوطنية من كلّ حملة عدائية أو كلّ ما يؤدّي إلى إضعافها ونبذها، وكلّ ما يقلّص من تواجدها أو ما يجعل اللّغة الأجنبية أفضل منها، وعلينا الخروج من هذا الوضع التّربوي السلبي غير المُريح؛ الذي تُفضّل فيه الفرنسية على العربية، كما تُفضّل الفرنسية على كلّ اللّغات الأجنبية مهما كان علمُها وتقدّمُها. إصلاح رغم ما أُثير حوله من جدل وقلاقل واضطرابات واعتصامات، فالدولة عزمت على تطبيقه مهما كان، فطبّقت الإصلاح الفاشل، فمن تضرّر؟ هل تضرّرَ أولادُ النّخبة والقبيلة؟ بالطبع لا؛ لأنّ أولادهم يدرسون في الخارج، ومن بقي في الداخل يدرس منهاج فرنسا، ويُمتحن في تونس.
وأمام هذا الوضع الذي لم يُنْزِل العربيةَ منزلتَها؛ فإنّها في نزول وانحدار، وينضاف إلى ذلك بعض المنغصّات المتراكمة من مثل: الحاجة إلى معاجم عصرية ومتنوّعة المواد والأهداف والأساليب ـ الحاجة إلى كتب قواعد عصرية ـ علاج مسألة غياب التّشكيل ـ طريقة تعليم وتعلّم جذّاب ـ نقص في التّرجمة والتأليف ـ اضطراب في المصطلح ـ ضعف إدارة المسألة اللّغوية ـ ضعف المؤسّسات اللّغوية ـ عدم وجود إرادة سياسية واضحة ـ تقصير المجتمع في حماية لغته ـ العداء للعربية والتّحامل عليها ـ غياب القرار السياسي ـ ضعف الخطط التّربوية الناجعة ـ ضعف لغة الإعلام وشيوع الأخطاء اللّغوية.. وهذه النقاط التي كان يجب أن يعالجها الإصلاح، ويأخذها في باب التّخطيط، وفي هذه النّقاط الهامّة يركّز العالم الفاسي الفهري على مسألة التّخطيط اللّغوي التي هي الدواء الناجع إذا ما وقع التّخطيط الفعّال في المسألة اللّغوية، وبه يعود رونقُ العربية إلى مجده، ويتزامن ذلك بالقضاء على جملة المتاعب التي أعاقت العربية عن اللّحاق قائلاً: إنّ حصيلة المتاعب جرّاء عدم التخطيط يعود إلى:
1ـ ضعف إتقان اللّغة العربية لدى المتعلّم، وضعف نوعية تعليمها، وضعف الوسائط الموظّفة في الأنشطة التّربوية المرتبطة بها، مما يترتّب عنه ضعف اكتساب المهارات والمعارف، وضعف مردود التعليم بصفة أعمّ.
2ـ عدم توفّر لغة عربية شاملة، تغطي مختلف أسلاك التّعليم (بما فيها العالي والتقني والأولي) وتوظف في مختلف المواد والأنشطة.
3ـ تعثّر المتعلّم في المراحل الأولى من التمدرس ناجم عن صعوبة الانتقال من لغة البيت (الدارجة المغربية أو الأمازيغية) إلى لغة المدرسة (العربية الفصيحة) وعدم العناية بتطوير طرائق الدعم اللائقة تلافياً لسلبيات الازدواجية اللغوية.
4ـ عدم توفّر المدرّس اللائق للغة العربية الملمّ بالجديد من طرق التعلّم والتعليم الجذّابة.
5ـ عدم توفّر الكتاب المدرسي والوسائط التربوية الملائمة[5].
هذا برنامج تخطيطي، وكان الأجدر أن نعمل من أجل إصلاح متين يوفّر للغات المدرسة الضمان الأمثل للانتشار دون صعوبة. وأرى الإصلاح في مجال اللّغات يعني:
ـ تعزيز المواطنة اللّغوية بإيلاء اللّغات الوطنية المكانة الأولى في التّدريس.
ـ تمكين المتعلّم من القدر الكبير من الرصيد المعرفي الذي يفهم ويعدّ ويتحاور ويكتب بلغته.
ـ الإفادة من اللّغات الأجنبية على أساس أن تضيف إلى لغاتنا ولا نُضاف فيها.
ـ جعل التلميذ يتأقلم مع السّجل اللّغوي الأجنبي، واستثمار ذلك في نقل المعارف الجديدة.
ولهذا رأينا تلك المغالطات في الإصلاح التّربوي الذي لم يقم على تخطيط سياسة لغوية واضحة، ولا على تخطيط تربوي مَرِن، فيمرّ سريعاً على متون اللّغات الوطنية، ويركّز على لغة أجنبية واحدة، فطفحَ الكيلُ وفسدَ الميزانُ، وما أصبح للغة العربية مكان، أفلا يمكن استدراك ما مرّ؟ يمكن استدراك ما مرّ بالوقوف عند مكامن النّقص، الذي يكون بحسن التّدبير، ومراعاة آليات العصر، والدفع بالعربية نحو تحقيق حقول لم تصلها بعد، من مثل التّعريب الشامل. وكان يجب على الإصلاح التربوي أن يُراعي تلك المنغصّات المتوارثة، ويغفل النظر في الجانب الشكلي، ولا يعمل على إسكات المتعلّمين بدخولهم جميعاً للجامعات، ونحن نشكو فقراً في طلاب لا يتقنون كتابة طلب التّوظيف، ولا ملء الصكوك، علماً أنّ عدد طلاب فرنسا، وهي أقوى منّا علماً واقتصاداً، يبلغ الآن مليونا ونصف مليون طالب من أصل ثمانين مليون مواطن، والجزائر في جامعاتها الآن مليون وستمئة طالب من أصل ستة وثلاثين مليوناً من السكان، فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ فهل يمكن للكثرة والكمّ أن يعملا على إنتاج النّخبة التي تنتج وتصنّع وتدير البلاد، لا يمكن ذلك أبداً، فلا بدّ من مراعاة النوع والتّقليل من الكمّ لتحصل الترقية المجتمعية.

لوحة: بطرس المعري
إنّ الاتّكال على الكمّ أن يكون في المرحلة الابتدائية فقط، وهي لا بدّ من دخول كلّ طفل إلى المدرسة ليقرأ ويحسب ويحاور ويلخّص. وأما في المراحل اللاحقة أن تحصل المنافسة، وكلّما واصلنا إلى المستوى الأعلى يقلّ العدد، وهذه هي القاعدة العلمية التي تعطي النّخبة والمتعلّم الجيّد، وقائد مسيرة الغد. وهكذا فإنّ واقع الإصلاح يقول العكس، فمن الضحيّة؟ الضحيّة ليس فرداً واحداً، بل نجد أجيالاً من الضحايا الذين يصنّفون بين الأميين وأشباه المتعلمين. ورغم كلّ هذا فلا نعدم التّغيير للأفضل في الأداء، بل يمكن أن يحصل الاستدراك بتوفير إطار قانون وتنشيط مدارس تربوية فاعلة ومعلمين أكفاء، واعتماد وسائل حديثة، وبرامج نوعية، وإيجاد مراكز بحث تربوية فاعلة؛ لتحقيق الجودة في إنتاج الأبحاث التّربوية والأدوات الضرورية للتّسيير التّربوي، وقيام تخطيط لغوي هادف يحدّ من الاختلالات اللغوية الأساسية.
2ـ الأمازيغية: لا ننكر أنّ مكتسباتٍ دستوريةً تحقّقت خلال العشرية الأخيرة؛ من حيث توفير الشّروط القمينة لتحقيق القانون المؤسّساتي للأمازيغية، بإقامة محافظة سامية، فقد نُقلت الأمازيغية من التهميش إلى صلب التعليم، وكان وجودها في الإعلام السمعي والبصري فتحاً عظيماً، كما حدثت دينامية التدوين التي نقلت الصورة الشفاهية الزائلة إلى صورة البقاء والديمومة والتواصل.. وهذه خطوات هامّة كفيلة بالحفاظ على هذا الإرث المهدّد بالانقراض. ومع هذا فإنّ الإصلاح التربوي لعام 2003/2004 م همّشها؛ فلم يعمل على الانتقال بالمدرسة إلى بناء مدرسة مواطنة تعترف بكلّ المكوّنات اللّسانية والثقافية، من مدرسة في الجزائر إلى مدرسة جزائرية، ولذلك كان أداءُ الأمازيغية ضعيفاً وهزيلاً؛ كأنّها لغة أجنبية منبوذة، وتعليمها عن طريق وسيط أجنبي، وبطرائق تدريس اللّغات الأجنبية، وأنّ استعمالَها محدود، ومختصّوها معدومون، فلذا لم يتحقّق بندُ الاهتمام بالأمازيغية ولا يمكن الرفع من مردوديتها. وكان يجب أن يكون الإصلاح التّربوي منسجماً مع الخطاب الأمازيغي في إطار العمل الجمعوي الذي ينظر للمسألة اللّغوية من باب حقوق الإنسان؛ على أنّ الهُوية الأمازيغية عنصرٌ من عناصر الحقّ في تلقّي اللغة الأمّ، والبحث عن الذات وسط رياح الهيمنة الثقافية والأيديولوجية، وإعادة الاعتبار لتراثنا الذي يهدّده الانقراض، كي لا يُطرح سؤالُ من نكون كلّ مرّة.
ولطيّ ملف الأمازيغية لا بدّ من مقاربة عقلانية وتاريخية، والإقرار بتلك الأخطاء التي ارتُكبت في حقّ الأمازيغية: من منع استعمالها وتدريسها، وقمع الحركات المنادية بتدريسها. وما يُؤسف له أنّ الإصلاحاتِ التربويةَ تعاطت مع المسألة بصورة العدمية والطوباوية، فلم تفكّ مسألة الخطّ الذي تكتب به، بل تركت المجال للخيار والمفاضلة، والنّتيجة واضحة، فنرى أنّ الإصلاح في مسألة الكتابة أعطى الخطَّ الأخضرَ للفرنسية لاحتواء الأمازيغية. كما لم تشر الإصلاحات إلى تلك المزايدة التاريخية التي يتّخذها البعض على أنّها مجال للأخذ أو للابتزاز، كأنّ الأمازيغية خاصّة ومحدودة، وهي ضمن حقوق مهضومة لأقلية محقورة فنعطي لهم مطالبهم الثقافية، وعليهم السكوت.
وإنّ الإصلاح التّربوي لم يحتوِ المسألة في التعميم التدريجي، بل كرّس مبدأ التخصيص اللغوي والجهوية والتبسيط للمسألة، ولم ينظر للمسألة من بابها العريض؛ على أنّ المسألة تهمّ المجتمع الجزائري في كُليّته، فترك الفجوة الداعية بالخصوصية الثّقافية الجزئية، وهو عمل ينطوي على مخاطر الانزلاق نحو التفكّك والانغلاق، ولم يخرج الإصلاح من خطاب إحياء السلف الصالح، وإسقاط الماضي على الحاضر، واجترار بقايا القبيلة، والمغالاة في تمجيد خصوصية النموذج التاريخي واللّغوي.. وعلى ضوء هذا واصلت الإصلاحات في التّعاطي مع الأمازيغية على أنّها مسألة ثقافية بالمنظور الضيّق؛ فلا تستدعي إلاّ المنظور التّراثي أو الثّقافي أو الرّقص الشّعبي وفتل الكُسكسي، وبعضاً من التاريخ المعتمد على بقايا التخلّف، وهذا هو إحياء الأمازيغية. ويؤسفني أنّ الأمر لا يكمن في هذا الوصف؛ فالمسألة تستدعي المعالجة السياسية الجريئة والمتبصّرة والمفتوحة على المستقبل، والتوفيق بين حاجيات الوطن الشاسع والعولمة المتوحشّة وإكراهاتها، وبين مستلزمات الحفاظ على الذات والهوية الثّقافية. وكان يجب الوعي بمسألة الأمازيغية لأنّها تشكّل الإرث الكبير للدول المغاربية، والاهتمام بها اهتمام بالتاريخ والوحدة والتراث:
“1ـ إنّها مُعطى تاريخي تضرب جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغاربيين.
2ـ إنّها تشكّل عنصراً أساسياً في الثّقافة والإرث المشترك بين كلّ مكوّنات الوحدة الوطنية بلا استثناء.
3ـ إنّها تمثّل إحدى الرموز اللّغوية والثقافية والحضارية للشخصية الوطنية.
4ـ إنّ النهوض بها ركيزة في مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي تتطلّع إليه الدول المغاربية.
5ـ إنّ العناية بها مسؤولية وطنية.
6ـ وأخيراً فإنّه يتعيّن أن تنفتح الأمازيغية على العالم المعاصر لتحقيق شروط ازدهارها وديمومتها”[6].
ولذا فالمسألة الأمازيغية كان يجب أن تُعالج في إطار توافقي ننأى بها عن التّدريس لساعات قليلات وعن البحث في حِكايا الجدات، وجمع المدوّنات، وإقامة المؤسّسات، فالإصلاح اعتبرها معالجةً جزئيةً كفيلةً بتغيير النّظرة القديمة، وهذا علاج قد لا يدوم كثيراً، أو هو علاج جزئي مسكّن إلى حين، أو هو تجميل مؤقّت، وسوف يأتي وقت تزول فيه المساحيق، وتظهر الحقيقة، فماذا نحن فاعلون؟
هل يمكن للكثرة والكمّ أن يعملا على إنتاج النّخبة التي تنتج وتصنّع وتدير البلاد، لا يمكن ذلك أبداً، فلا بدّ من مراعاة النوع والتّقليل من الكمّ لتحصل الترقية المجتمعية
إنّ الأمازيغية كان يجب أن تُعالج تربوياً وسياسياً، وهذا هو البرنامج الكفيل بالعلاج الواقعي، تربوياً بتهيئة لغوية في معجمها وفي تعليمها وفي تعميمها، وسياسياً ألا تدخل في المعالجة التّجزيئية الكفيلة بتحويلها إلى بؤرة توتر اجتماعي، فلا نريد أن تحصل عندنا بلقنة وطنيةBulkanisation national، فعلّمتنا التّجارب بأنّ أمثالَ هذه المسائل تُعالج في إطار الحوار والحكمة والوَحدة والشفافية والديمقراطية، كما علّمتنا الحياة أنّ مسألة الإلغاء أو الفرض مآلها الإخفاق، وأنّ عدم نزول الملف اللّغوي للعامّة مآله الفشل، ويكفينا فشلاً من التّعريب النازل من الأعلى، والذي تمّ في ظروف مجهولة، ووقع تجميده من أعلى.
ونؤكّد بأنّ الملف اللّغوي لا تحلّه إلاّ الحكومات المنتخبة والشّرعية، فلا لتوطيد سلطة بوليسية، ولا للقمع والكبت، وتمييع المسألة إلى غد مجهول، أو إلى حاكم يأتي بعدي، أو السكوت عن قضايا عميقة إلى زمن لاحق، فالتّسويف فتيل وحرب قادمة، فلا لشراء السكوت عن المطالبة بالحقوق. وإنّي مُتحفّظ من تلك التّصرّفات المُخلّة بالوحدة التّراتبية، وهذا في ما يُطبّق في إطار مغلق مُناقض لهُويتنا الإسلامية. ولهذا إنْ عُولجت الأمازيغية في إطار شمولي؛ بالتّركيز على القواسم المشتركة التي تجمع مكوّنات الوطن؛ وباعتماد الشرعية التاريخية والجغرافية والدينية والسّياسية والإقرار بها لغة وطنية، ولمَ لا تكون لغة رسمية، يمكن أن نقول إنّنا دخلنا مرحلة الأمان، ولا يدخل البلد في حرب اللّغات، ولا في الاقتتال بيننا في مجال الّلغات، فكيف يقتتل الجزائريون بمجرّد أن يعترف بعضهم ببعض، فكيف نقتتل بعد ترسيخ المساواة اللّغوية، بل إنّ الاعتراف بالأمازيغية هو تغيير في الذهنيات؛ لأنّها ليست مجرّد لغة، بل هي قيم ثقافية تتميّز بنزعتها الإنسانية وبميلها للحرية والمساواة والكرامة، والأمازيغية منظومة ثقافية هُويّاتية مستقلّة مُتجدّدة في بلاد تامزغا، وهي المُحدّد المركزي لهُوية الجزائر ومظهر خصوصيتها الحضارية، وقد تفاعلت مع مكوّنات العربية والإسلام.
أؤكّد المسألةَ لأنّها من الخطورة بمكان، ومن الشيء الذي لا يستقرّ عليه الأوان، بأنّ الأمازيغية من الأفضل أن تُعالج في إطار احتواء ذلك الخطاب التحاملي على كلّ ما هو عربي، ذلك الخطاب الذي يقدّم صورة مُشوّهة للفتح الإسلامي؛ خطاب يسكت عن كلّ ما هو فرنسي، ويمجّد الرموزَ القديمة من مثل: ماسينيسا/ يوغرطة/ نوميديا/ يوبا/ الكاهنة/ كسيلة.. والسكوت عن طارق بن زياد/ يوسف بن تاشفين/ المهدي بن تومرت/ المختار السويسي/ الأمير عبدالقادر/ عبد الحميد بن باديس… نريد أن تُعالج المسألة في إطار ردّ الاعتبار للأمازيغية في خطّها التفيناغي، وإن لم يكن فيكون الخطّ العربي هو البديل، وتغيير ذهنية تلك الحركات الإقصائية التي تنظر إلى الحضارة المشرقية على أنّها عقيم والحضارة الغربية بديل، فتُضفي على الغرب مشروعيةَ الاحتواء، وهو نوع من التّقصير في الإصلاح التّربوي الذي لم يقدّم المناعة المطلوبة لامتصاص المفاعيل السلبية لزمن كان ذات مرّة، وأبقى على تمجيد فِعْل فرنسا اليعقوبية التي تعمل لصالح الاحتواء، وبقي المعرّبون سلبيين ينظرون للأمازيغية على أنّها العداء والتّجزئة، أليست معرفة الأمازيغية زيادة في معرفة اللّغات؟ وما دام الأمرُ في زيادة فهو جيّد؛ لأنّه لا يدخل في النّقصان. ويقول أحمد بوكوس “إذا سلّمنا بأنّ اللغة الأمازيغية لغة وطنية، وأنّها تعبّر عن مكوّن أساسي للهُوية الوطنية وأنّ تعلّمها حقّ غير قابل للتّصرّف، حينئذ يصبح إدماجها في التعليم فرضاً خاصاً على أساس الوعي والمسؤولية، وهذا الإدماج قابل لتصوّرات مختلفة، والتصوّر الذي أقترحه يرتكز على أربعة مبادئ: التعميم والإجبارية والشمولية والتوحيد[7]“. إذن فالمسألة الأمازيغية لا يكفي أن يكون التعامل معها على أنّها مُعطى مدرسي أو ثقافي، بل هي أعمق، بعيدة الأغوار، ممتدّة الجذور، وأراها تجيب عن تلك السياسة الفرنكفونية التي تسعى لاحتواء الدول المغاربية، وخلق بؤر بدعوى المحافظة على الهُوية اللّغوية، وخلق معركة بين دُعاة العربية ودُعاة الأمازيغية، لتجد اللّغة الفرنسية نفسها البديل اللّغوي المفضّل. ولهذا لا يجب التعامل مع المسألة بالحرمان اللّغوي؛ لأنّ الحرمان يولد التّطرّف، ولا بالتفاضل اللّغوي، بل بالعدل بينهما في العطاء، حتى يتبيّن الأفضل، وكذا في إنزال المقام بشرط العلمية والإنتاج، فلا يجب أن يقع تحريم لغة من باب تفضيل لغة “عندما يجد نفسه محروماً من سلطة الكلمة فإنّ نظرته إلى العالم هي التي تصبح غير مكتملة، كما أنّ السلطة التي يمكن أن يمارسها على أبناء العالم تصبح ضعيفة ومحدّدة بشكل كبير[8]“. وهكذا فرغم الصحوة اللّغوية الأمازيغية فإنّ المؤسّسات الوطنية لمّا تدخلها هذه اللّغة، وبقينا نعيش صراعاً لغوياً بفعل لغة النّخبة (الفرنسية) التي تنتج النّخب الحاكمة في بلاد المغارب، وتساعد على قمع اللّغات الوطنية، فمتى ينصفُ التاريخُ العمقَ الثقافي الجزائري المبني على الأمازيغية كتراث وطني، والعربية كلغة حضارة وعلم؟ ومتى تستفيق تلك النّخبة من وحشيتها الإقصائية؟
إنّ الاعتراف بالأمازيغية هو تغيير في الذهنيات؛ لأنّها ليست مجرّد لغة، بل هي قيم ثقافية تتميّز بنزعتها الإنسانية وبميلها للحرية والمساواة والكرامة
3ـ اللّغة الفرنسية: سيكون حديثي في هذه النّقطة عن الاستعمار اللّغوي الذي ما يزال يعشش في أذهان بعض فئات المجتمع الجزائري، وبخاصّة النّخبةَ الناطقةَ بلغة واحدة، وهي الفرنسية الساحرة؛ لأنّ (النّخبة) مُنغلقة على لغة واحدة، ولا تنظر للعالم إلاّ من زاوية هذه اللّغة، فكأنّ العالم مختصر فيها، ولا يبقى إلاّ بها. فلقد افتقدت نخبتُنا المفرنسة الهُوية اللّغوية، ولبست لباسَ الغير علّها تكون، وهو بخس ذاتي فتسعى بكلّ قواها للانفصال عن الأصالة. نخبتنا تفضّل الهجرة والاهتجار؛ لأنّ الغرب أغراها، فتركب بواخر الموت لتنقلها إلى الضفة الأخرى، والآخر يسحرها، وتستأجر لغته وتترجاه أن يقبل، فأصبح الأجنبي يُملي ما يُريد، ونقبل دون مناقشة ما يُريد، ولا نرى إلاّ بعين الآخر. لقد افرنججَ لسانُنا في المتجر والمقهى، واستُلبت نخبةُ النفوذ والقرار وأصحاب رؤوس الأموال.. فحصلت أزمةٌ في المواطنة اللّغوية فالأزمة أزمة ألسن، وأزمة الفرنسية المعبودة، فكيف نتدبّر الأمر؟
إنّ تملّكَ اللّغات الأجنبية حتميةٌ ثقافيةٌ وعالميةٌ، والوسيلةُ إلى ذلك هو تعلُّمها والتّرجمة منها وإليها، فلا مجالَ للرفض في قبول اللّغات الأجنبية، وما هو مطروح هو الاستيعاب والترجمة، وهو سبيل إلى استيعاب ثقافات أخرى خارج الفرنسية، مع فرص للتملّك أو للتّرك والتّهذيب، فأن نكونَ تُبّعاً فتلك هي المشكلة، فنحن مغلوبون على أمرنا بتغلّب لغاتِ الغير، فلغاتُنا تَسْقُط بضعفنا وانهرامنا في نِحل الأجنبي وتقليده في زيّه ومأكله ولباسه، وأما لغته فنحن لها من العابدين، وبها نعمل على سقوط لغتنا؛ لأنّنا من التابعين، وكما قال ابن حزم الأندلسي “إنّما يفيد للغة الأمّة وعلومَها وأخبارها قوّة دولها ونشاطُ أهلها. وإنّ اللّغة يسقط أكثرها بسقوط أهلها ودخول غيرهم عليهم”. وهكذا تضعف اللّغة جرّاء وضعها كلغة دونية في السوق اللّغوية، وذلك ما يُسهم في تغيير بنياتها الصِواتية والصرفية والمعجمية، فلم نعمل بصيغة النّفعية كما يعمل الآخرون، فتملّكُ اللغات عند الغربيين يغني الترجمة، وتملّكُ اللغات عندنا يعني التبعية، وتلك هي المصيبة التي لا نعلم بها.
علينا أن نتدبّر أمرَ لغاتنا بالبحث في بعث النَّفَس في برامجنا ومشاريعنا، وإدخال الحماس إلى باحثينا وطلابنا، وأن نَعِيَ بأنّ إقامةَ المعرفةِ تحتاج إلى الاستفادة من التّجارب المتراكمة، وهذه سمة الحضارة، وفي ذات الوقت يجب العلمُ بأنّ العودة إلى الأصل هي الصّواب، بل ذلك ما يحقّق الانسجام، ولذا كان السبيل الأوفى في هذا المجال التّضييق من حالاتِ عنفِ الإدارة والمؤسّسات والتي تخلق نوعاً من الدعوة إلى التخلّي عن اللّغة الأمّ/لغة الأمّة، والتّعامل التفضيلي للغات الأجنبية، بل واشتراط امتلاك الفرنسية في التوظيف وذلك عبارة عن موت غير معلن للغات الوطنية، ووضعية ناتجة عن استصغار اللّغات الوطنية بفعل سكوت الدولة عن تصرّفات ممثّليها في الإدارة، وعن تلك القرارات الرمزية باسم الدولة، وهذا ما يلمس في ممثلي دولتنا في الخارج من اشتراط إتقانهم الفرنسية، دون اشتراط التحّكم في العربية، بل واشتراط على ممثلي الدول الأجنبية إتقانهم الفرنسية، وفي التّعيينات المحلية والخارجية التي لا ينظر إلى المعرّب مهما أُوتيَ من قوّة لغوية في العربية، بل التأشيرة هي امتلاك الفرنسية دون غيرها من اللّغات الأجنبية.
وهذا عبارة عن تَلَف تدريجي للغات البلد، وهذا ما لا تقوم به الأمم الحيّة، ونحن نعلم بأنّ إتقان لغة البلد فرض عين وليس فرض كفاية، فكيف بمسيّر جزائري وفي بلد كالجزائر لا يعرف من لغته إلاّ السلام عليكم، ويتعثّر لسانه في لغته، أليست هذه هي الغربة اللّغوية أو المنفى في الوطن. وقد يسأل القارئ ما دخل هذا في الإصلاحات التّربوية؟ نجيبه بأنّ الإصلاحات التّربوية لعام 2003 م لم تعزّز لغات البلد، بل فضّلت اللغة الأجنبية، لما أعطتها من مقام وذلك ما جعل المسؤول عندنا يقع في أخطاء لغته دون اهتمام يُذكر؛ بينما يتحفّظ ويتحرّز ذلك المسؤول من الوقوع في أخطاء الفرنسية، فسوف تشنّ عليه حرب قائمة، وهذا ما يقرأه في دروس الفرنسية، بأنّ الخطأ عيب وشتيمة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ الإصلاح لم ينفتح على التعدّد اللّغوي الأجنبي، فحصر نفسه في الاهتمام بالفرنسية فقط، ونظرَ إليها على أنّها اللغة العلمية والعالمية التي يقطر منها العلم دون غيرها من اللّغات، ومن لا يعرف الفرنسية فلا يعرف العالمَ. وهذه نقطة الضّعف في الإصلاح التّربوي، الذي تناسى أنّ الفرنسيين الآن يتحوّلون إلى الإنكليزية، وأنّ الفرنسيةَ مهدّدة في الاتّحاد الأوروبي، وأنّ حدودها مستعمرات فرنسا القديمة، وفي العالم العربي لا تتعدّى بلاد المغارب دون ليبيا، والتّواصل بها شبه محدود، وهي لغة غير عولمية، فلمَ لا نخرج من شرنقة الفرنسية إلى التفتّح على لغات الأقطاب؛ وهي كثيرات، ولغات لها من العلم الكثير، ولمَ لا نخطّط لأجيال متعدّدي اللّغات الأجنبية، لا أحادي اللّغات. أليس متعباً أن نجد أقسام التّرجمة لا تخرج من لغتين أجنبيتين، أليس من العيب ألا نجد في بلادنا من لا يعرف ولا لغة شرقية؟ أليس من الهزيمة ألاّ نتواصل مع أهل الحضارة المشرقية بسبب عدم إتقاننا الإنكليزية؟
ومن هنا لو أنّ الإصلاحات أكّدت أهميةَ التّحكّم في العربية، وتكون الإشارة إلى التّحكّم في إحدى الأمازيغيات باعتبارها من لغات البلد، بل واستعمالهما من الضروري وليس من الخيار، والأجمل من هذا أن تكونا حاضرتين في كلّ المجالات، وبذلك تتعزّز صلابة الصرح الهُوياتي للوطن، وهذا ما تمثّل في تلك الثّنائية القديمة دون مشكلة تُذكر، وهو تنوّع لغوي قديم ترك مزج اللغتين وتناوبها واقتراضها وتداخل أصواتها، فكانت ظاهرة اتّصال حقيقي في المشهد اللّساني الجزائري، والآن لا مفرّ منها.
إنّ العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان مُتساكنتان ومُتصاهرتان كلّ أخذت وظيفة بما تحمله من علم ودين، فلم يحصل القهر أو الفرض، ولكن معرفتنا للغة الأمّ (العربية) ضعيفة فنتدرّج لنكون دون لغة Nilingue إذ تقلّصَ حجمُها في الاستعمال وفي الإعلام وفي الجامعة، وحصل تفضيل لغة أجنبية عليها وتقلّصت وظائفها الإدارية. ومعرفتنا بلغة أمّ (الأمازيغية) كانت أضعف أو هي معرفة سلبية بفعل عوامل نفسية في المقام الأول، وبفعل التوجيه السلبي في عدم الإقرار بثقافتنا كمُعطى احتشامي على أنّها لغة بربرية لا فائدة منها، ثمّ حصلت هيمنةُ الفرنسية على وضعنا اللّغوي، فذلك ما زاد الغُربة غربة. فلم نكن مثل الشعوب المتقدّمة التي تمتلك اللغة الكونية للوصول إلى المعارف الكونية، والتحكّم في اللغات الوطنية التداولية Lingua franca للتواصل البيني من حجم كبير؛ حجم اللّغة الأمّ أو لغة المنشأ Mother tongue فأغفلنا ما يتعلّق بالسيادة والكرامة والمواطنة، وتناسينا بأنّ توظيف اللغة الجامعة (العربية) عُملة صعبة؛ فكلّما وقع استعمالها وقع عليها الطلب، وجنى أصحابها الفوائد المادية مثل الإنكليزية التي تجني لأصحابها ما يفوق الـ12 مليار دولار سنوياً، وفوائد انتشار الإنكليزية تدرّ على معلميها أموالاً كبيرة. وهكذا ما يزال ربيعُنا فرنسياً؛ فيلقٌ من الإعلام الفرانكفوني الذي تجاوزت عدد صحفه 60 صحيفة وهو يمجد كلّ ما هو غربي، فكيف يمكن أن يقع إصلاح تربوي أمام عنف فرانكفوني يريد إخضاع كلّ الساكنة لمنطق لغته فقط، وهذا نوع من التّجريد من المواطنة، يجرّد الناس من لغتهم ويهدم ثقافتهم، فاستفحلت الفرنسية بعد استقلال الدول المغاربية، بل أصبحت عندنا أيديولوجية تسعى لتحقيق مصالح استعمارية وتوسّعية ثقافية واقتصادية بغرض الإلحاق والسيطرة، والتمكين للفرنسية في غير موطنها ومحاربة اللّغات المنافسة لها، فكأنّ الفرنكفونية عائدة بقوّة لضرب جذورها عندنا. أليس هذا نوعا من أسباب الأزمة؛ أزمة في اللّغات الوطنية، أزمة في التّعليم والإدارة والاقتصاد؛ أزمة حقوق لغوية مغيّبة، ودستور لا يُطبّق، أزمة في خطاب معلن وسياسة مخالفة مبطّنة.. فإلى أين المصير؟ بالفعل لم يحصل ما كان منتظراً من الإصلاح التّربوي، غياب الجودة والنّجاعة، تلاميذ يجهلون كلّ اللغات، فما هو الإصلاح المنشود؟

لوحة: بطرس المعري
ـ ما هو الإصلاح المنشود؟
لا نعدم أن تعود المنظومة التّربوية إلى عصرها الذهبي، وهذا لا يكون عن طريق قرارات وزارية أو أمريات، بل أن تتأسّس هيئة وطنية مشهود لها بالكفاءة العلمية، ومن الذين خدموا مراحل التّعليم إلى الجامعة، ومن الباحثين الجادين الذين لهم وزن علمي في الداخل والخارج، هيئة وطنية جزائرية الانتماء، تجمع بين الأصالة والحداثة، ولها بعد وطني تحتكم إليه. ولهذه الهيئة صلاحية اقتراح تخطيط سياسة لغوية، وتخطيط تربوي عامّ، ترفعه للقيادة السّياسية التي تقترح النّصوص الكفيلة بالتّطبيق. ويكون من مهام هذه الهيئة الحسم في وضعية اللّغات، والاستدلال بوظائفها حسب مقامها، وفيها يحصل:
تحسين تدريس اللّغة العربية.
التحكّم في الأمازيغية.
إتقان اللّغات الأجنبية.
وبهذه الخطوة الأولى يمكن أن نقول: إنّنا نعمل على ترسيخ مدرسة جزائرية تعمل على تثبيت الهُوية الجزائرية الحضارية، والوعي بتفاعل وتكامل روافدها، ومن ثمّة يحصل نقل المعرفة والقيم للأجيال. وإنّه كلّما تقدّمَ التعليمُ باللّغة الوطنية ارتقى المجتمعُ إلى سلّم المدنية وإلى مجتمع المعرفة، وكلّما تقدّمَ التعليمُ باللّغة الوطنية، حقّقَ تنميةً بشريةً جيّدةً، وكلّما وقعَ الاهتمامُ بالمدرسة تُعطينا مجتمعاً حداثياً ديمقراطياً متشبّثاً بأصالته، وهذه عهدتنا نحن الكبار، لأنّ التعليم سياسة يمارسها الكبار تجاه عقول الصغار.
ودعوني أغادر الحديث عن دور الهيئة الوطنية، لأمرّ إلى اقتراح خطّة وطنية شاملة لفعل الإصلاحات التي أراها في هذه المقترحات:
أولاً: التّخطيط اللّغوي: يمسّ التّخطيط في هذا المعطى ثلاث مراحل:
مرحلة التّخطيط الاستعجالي وهذا لوقف نزيف الانحطاط، بمراجعة عامّة للنقاط السود التي تنخر المنظومة التّربوية، بدءاً من إعادة الاعتبار للباكالوريا، وما يؤدّي إلى المستوى اللّغوي الرفيع.
مرحلة التّخطيط على الآماد الثّلاث: الآني والمتوسّط والبعيد. وفيه تتدرّج القضايا حسب أهميتها بمراجعة عميقة في: تكوين المعلّم ــ وضع منهاج تربوي متين ــ بناء كتاب مدرسي يستجيب للمعاصر ــ وضع قواميس لغوية حديثة.
مرحلة التّخطيط البعيد، وعلى مدى الجيل، وفيها يحصل استدراك النقائص، وتقويم الأخطاء وتصحيحها، بل التّراجع عن مواطن الضعف، وتقوية مواطن القوّة، وفيها أيضا يحصل الفصل بين لغات المدرسة بإنزالها تراتبياً وفق الأبعاد العلمية والحضارية والتاريخية والنفعية، وكلّ ما يتعلّق ببناء لغوي منسجم في إطار تكاملي. وفي هذه النّقطة لا نعدم التّجارب الناجحة التي قامت بها أمم قبلنا، ونجحت في تخطيط لغوي، وما عادت المشاكل تُطرح إذا وقعَ احترامٌ متبادلٌ ومتكاملٌ بين اللغات الوطنية في إطار التخصّص والوظيفة.
ثانياً: طرح ملف الإصلاح التّربوي للمناقشة العلنية: أليس من المواطنة أن يُطرح الإصلاحُ التّربوي طرحاً وظيفياً يُستحضر فيه ما هو استعجالي، وما هو على المدى المتوسّط، وما هو على المدى البعيد، طرحٌ يتناول مسألةَ توصيلِ المعرفة التي تشكّل الهدفَ المباشر والوظيفة الأولى لعملية التّعليم، طرحٌ يعمل على التّفكير في كيفية إعادة الجاذبية للتّربية والتّعليم، طرحٌ يمسّ أطرافَ عمليةِ الإصلاح = المعلم+ وَلِي التلميذ+ المنهاج. فهل نزل ملفُ الإصلاح التربوي إلى القاعدة؟ لم يحصل هذا، وكان الأمرُ من فوق بتنصيب لجنة وطنية على المقاس، بعد حلّ مجلس أعلى للتربية المنتخب في ثلثين من أعضائه، وقد عمل الكثير من مجالات الإصلاح كتنظير، فلم توضع دراساته محلّ التطبيق؛ وحُلّ قبل أن يستكمل ملف التّعليم العالي.
المطلوب إصلاح تربوي نسعى جميعنا لتحقيق الهدف المشترك منه، وهو إنزال لغاتنا منزلتها اللائقة، ولا يكون هذا إلاّ بإصلاح يعمل على تنشئة مدرسة تتحلّى بقدرات معرفية؛ تُنتج فرداً قادراً على الاختيار
والغريب أنّ اللجنة اعتمدت أعمال المجلس فما الداعي لحلّه، واعتماد النتائج التي توصّل إليها. مجلس استبدل بلجنة صاغت البرنامج الإصلاحي دون أن تقوم بتجريبه الجزئي أو إخضاعه للتقويم، فحصل التطبيق بالقوّة (طبّقْ أو طبَّگ) لجنة إصلاحات طبخت طبخة غربية في بلد عربي إسلامي دون فتح نافذة لخروج رائحة الطبيخ، فتمّ العمل في سرّية تامّة، دون معرفة أعضاء اللّجنة لنوع الإصلاح (عيونهم مفتوحة دون مشاهدات واضحة) لجنة على المقاس في إطار توجّهات عفوية من أجل مناقشة قضية مفصلية في المجتمع، وتقتضي الكثيرَ من التعمّق والتّنسيق بين كثير من الأطراف. لهذا فإصلاح اللّجنة الوطنية أضرّ بأجيال، وبقطاع التّعليم بصفة خاصّة، ويعني هذا الإصلاح التّضحية بكلّ المجتمع، فكان إصلاحاً تلفيقياً مُرتجلاً؛ يعتمد الكمّ لا الكيف، يستنزف البترول دون مردود. إصلاح تلفيقي نظراً لـ:
ـ هبوط المستوى اللّغوي إلى الأسفل.
ـ اكتظاظ في الأقسام.
ـ غلق المعاهد التّكنولوجية.
ـ نقص المؤطّرين.
ـ حرمان المتخرّجين من التّوظيف.
ـ ضآلة المناصب والتّباري عليها بالآلاف.
ـ هزالة المخرجات.
ـ ضعف البحث التّربوي.
ثالثاً: إصلاح الإصلاح: في هذه المرحلة يكون العمل بإصلاح جديد يستجيب للتحدّيات الراهنة، فنحن بحاجة إلى إصلاح تربوي يمنحُ التلميذَ سجلاتٍ لغويةً تراتبيةً: العربية في المقام الأوّل، والأمازيغية في الرتبة الثانية بتعدّد لهجاتها، واللّغات الأجنبية بتعدّدها وحسب النفعية الحاضرة والمستقبلية. الفرنسية في الحقوق/الإنكليزية في الإعلام الآلي/الإسبانية والبرتغالية في علوم البحار/اليابانية في صناعة النانوتكنولوجي/ الكورية في صناعة المحرّكات/الألمانية في الفلسفة والديداكتيك/اللّغات الشرقية في التراث/الروسية في الصناعات الثقيلة.. ولا يعني هذا وجود تعددية لغوية همجية، بل أن تكون لكلّ هذه مساقات في التّعليم الجامعي بخصوص الاستفادة من لغات الأقطاب، وفي مراكز البحوث، وبخاصّة في أقسام الترجمة التي نروم لها الخروج من تدريس: الفرنسية + الإنكليزية فقط، وهذا وصولاً إلى رفع مجموعة من التحدّيات التي أجملها في ما يلي:
ـ هل المدرسةُ تنتج المعرفةَ أم إنّها تعيد إنتاجَها عبر تحويلها أو استقطابها لمضامين في اللّغات الأخرى؟
ــ هل مدرستُنا عبر إصلاحاتها يمكن أن تثمرَ معارفَ العصر؟
ـ وفق أيّ معايير يمكن تقويم هذه المعارف؟
ـ كيف يتأتّى لبلادنا من خلال مدارسها وجامعاتها كسب رهان الانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة؟
ــ كيف لنا العملُ على جعل لغاتنا الوطنية لغات العلم، في الوقت الذي تهدّد بالانقراض خلال القرن الحالي[9]؟
ــ كيف لنا أن نؤسّس لجامعات وطنية معيارية ذات التّصنيف العالمي©، ولها براءات اختراع، وفيها أساتذة من ذوي الكفاءات المُبرّزة، ومن الحائزين على الجوائز العالمية؟
ــ كيف لنا إعداد مدارس عليا، وثانويات كفاءات، تعمل على إنتاج المبدعين والمخترعين والمسيّرين، وكبار العلماء المرجعيين؟
ــ كيف لنا أن نسترشد أمور التّخطيط الذي يعتمد المواطنة قبل الانتماء، أهل العلم والاختصاص قبل أهل الثقّة، التّباري لخدمة الشّأن العام؟
كيف لنا التحكّم في آليات العصر، وجعل لغاتنا تقف نداً للغات العولمة، والإنتاج بها وفيها؟
رابعاً: المراجعة والتّقويم: ما أحوجنا إلى سياسة الحقيقة، وإلى الصدح والجهر بقول (لا) للاعوجاج و(نعم) للمراجعة (لا) للتراجع، وإنّه لا يجوز تعميم الإصلاح التّربوي إلاّ بعد تجربته على مساحة ضيّقة والإبانَة عن نجاحه. وفي هذه النقطة يمكن أن يقعَ الخلاف بيننا في إنتاج الأفكار وفق الأرضية المعرفية لكلّ منا، ولكن يجب أن نضعَ الهدفَ واحداً، وسنتبارى في تحقيقه عبر مسارب متنوّعة، فكلّ له طريقه ومنهجه، وهذه سمة الاعتراف والتكامل البيني.
لا بدّ من هدف مشترك نعمل جميعُنا للوصول إليه (تحقيق المواطنة اللّغوية) والهدف المشترك يُستقى من الثّوابت الوطنية، ومن الدّستور الذي يكون الحكمَ والفيصلَ، وإلاّ سيتعثّر المشيُ مرة أخرى، وسنحتاج إلى إصلاح إصلاح الإصلاح.
كلّ هذه الأشياء تتكامل وظائفها من خلال تمفصلها الفعّال لضمان الشّعارِ الوطني والذي أضحى مرفوعاً نحو بناء مدرسة النّجاح والجودة؛ فنريد مدرسةً جزائريةً تعمل على تجسيد المواطنة اللّغوية التي يحسّ فيها المواطن أنّه في بلده، ويُخاطَب بلغة بلده، مدرسة تعمل على زرع الثقّة في النفس، مستقلّة في التّفكير والممارسة؛ تُعْمِل العقل، وتَعتمِد النقد، وتُثمّن الاجتهاد، وتُقيم آلياتِ التنافس، وتَعْمَل على الوعي بآلية الزمن والوقت كقيمة أساسية في اللّحاق بالرَّكب.
خاتمة: في الحقيقة إنّ إصلاح المنظومة التّربوية يرتبط بإصلاح المجتمع، فالرِّهان على التّربية رهان وطني استراتيجي؛ تنطلق منه التوجّهات الكبرى لإحداث نقلةٍ نوعيةٍ، فكان يجب أن تحظى المدرسةُ بالإجماع الوطني، وتُصبحَ مشروعاً مجتمعياً يقتضي إصلاحاً حقيقياً، وتُسهم في ذلك الإصلاح كلُّ فعاليات المجتمع، ويكون إصلاحُها التّربوي مُقدساً مثل الدستور. إصلاح لا يعبث به العابثون، بل يحرص عليه كلُّ الفاعلين، ويظلّ إصلاحاً منفتحاً يُترجم واقعَ المنظومة التّربوية وسيرورة مستمرّة للأجيال، ويحدّد قيمَ العيش المشترك والانتماءَ الجمعي بكلّ اللّغات الوطنية، وبما تحمله المواطنة من أبعاد، بالإضافة إلى تلك التوجّهات السياسية والاختلافات المنهجية، ولا تظهر فيه آثارُ الحاكم، ولا استراتيجية حزب سياسي أو اتّجاه ما، وينأى الإصلاح عن الاضطرابات والسلطة، ويحظى بتأييد المختصّين، وتوضع له قواعده ولا يحيد عنها أحد.
فالمطلوب إصلاح تربوي نسعى جميعنا لتحقيق الهدف المشترك منه، وهو إنزال لغاتنا منزلتها اللائقة، ولا يكون هذا إلاّ بإصلاح يعمل على تنشئة مدرسة تتحلّى بقدرات معرفية؛ تُنتج فرداً قادراً على الاختيار، يتكيّف مع الواقع، ينشد الحريةَ والديمقراطيةَ، ويقبل النقدَ والرأيَ الآخر، ويستوعب القيمَ الكونيةَ.
وأريد أن أختمَ دراستي هذه بالإشارة إلى سكوتِ النّخبة الوطنية عن هذا الوضع المتردّي والمُؤسف وبخاصّةِ النّخبةَ المعرّبةَ، التي عليها العِوَل والتّعويل في الكتابة والتّغيير، ولكنّ يبدو أنّها نامت على الوعود العرقوبية، والتّطمينات التّنويمية، قبل أن تتمكّن من استئناف مشروعها، وربّما دخلت محرابَ الهرْوَلة، وراء المنافع العابرة. وإنّي افتقدت سماعَ شخصيات مسكونة بِهمّ اللغة العربية، ويبدو لي أنّه دبّت فيها الهزيمة، وأفقدها الفسادُ اللّغوي المَبنى والمَعنى، وما عادت تطيقُ المَأوى، وبعضها دخلَ في بيتها لسانُ الرومان، فأوقع بينها الشنآن، فسكتتْ عن الوضع بما كان، ولم تستطع اللفّ ولا الدوران، وما حرّكت إصبعها بأضعف الإيمان. ويؤسفني كلّ هذا، فقد لمستُ بعضَ الحقائق لَمْس اليدّ، ورأيتها رأي العين، وأحسستُها إحساسَ المعاينة اليومية، فالزمانُ تغيّرَ، والوضعُ تبدّلَ، وما عاد يفيد الوعظ إذا لم يصاحبه الوعيُ. أين أنتم يا من أَفْنَوا بياضَ نهارهم في سوادِ الحرفِ المشكول، أين الأصالةُ من الزَّيف والخُلُقُ من الانحراف، فهل أغراكم الحال، على ما وصلنا إليه من المُحال؟.
إشارات
(1) ـ أحمد أوزي “المدرسة والتّكوين ومتطلّبات بنا مجتمع المعرفة” مجلة المدرسة المغربية. المغرب: 2012، المجلس الأعلى للتّعليم، العدد 4/5 ص 112.
(2) ـ ينظر جريدة الخبر ليوم: 20 أبريل 2013، ص 7 (مواضيع الباكالوريا من الفصلين الأول والثاني). العدد 7050.
(3)-MoatassimeAhmed, dialogue de sourds et communication langagière en Méditerranée. L’Harmatta: 2006، p 119.
(4) ـ أحمد الحارثي “الأمازيغية وحقوق الإنسان” مجلة نوافذ. المغرب: 2011، العدد 49-50، ص 77.
(5) ـ أزمة الّلغة العربية في المغرب، ط5. الرباط: 2010، دار الكتاب الجديد المتحدة، ص 17.
(6) ـ أحمد بوكوس، مسار اللّغة الأمازيغية، تعريب: فؤاد ساعة. الرباط: 2012، منشورات المعهد الملكي للثّقافة الأمازيغية ص 3031.
(7) ـ “الأمازيغية والمنظومة التّربوية” مجلة نوافذ. المغرب: 2002، عدد مزدوج17-18 يتناول (المسألة الأمازيغية في المغرب) ص 75.
(8) ـ مريم الدمناني “المسألة الأمازيغية، لماذا وكيف؟ مجلة نوافذ. المغرب: 2002، عدد مزدوج 17-18 يتناول (المسألة الأمازيغية في المغرب) ص 80.
(9) ـ ينص تقرير اليونسكو الصادر في ديسمبر 2012 بأنّ 300 لغة سوف تنقرض خلال القرن الحادي والعشرين وأكثرها من اللّغات الإفريقية. ونعلم بأنّ العربية + الأمازيغية من تلك اللّغات التي يهدّدها هذا الانقراض. فما هي الوصفة الإصلاحية والعلاجية التي تفنّد هذه المقولة؟
©ـ ما يؤسف له أنّ الجامعات الجزائرية تترنّح في ذيل التّرتيب العالمي. وهذا ما استقرّ عليه التّصنيف الذي أعدّته مجلة تايمز للتّعليم العالي 2013، فأحسن الجامعات الجزائرية اعتلت الرتبة 2185 وأَدْرَجَ التّصنيفُ جامعة (منتوري) بقسنطينة التي جاء ترتيبها في المرتبة 2185 عالمياً، في ما جاءت جامعة (أبو بكر بلقايد) بتلمسان في المرتبة 2273 عالمياً، واحتلت جامعةُ (العلوم والتّكنولوجيا هواري بومدين) المرتبةَ 2935، وهي الجامعة التي تحتلّ ثالث أحسن جامعة على التّراب الوطني. ع/ جريدة الخبر، العدد 7050، بتاريخ: 20 أفريل 2013، ص 5.