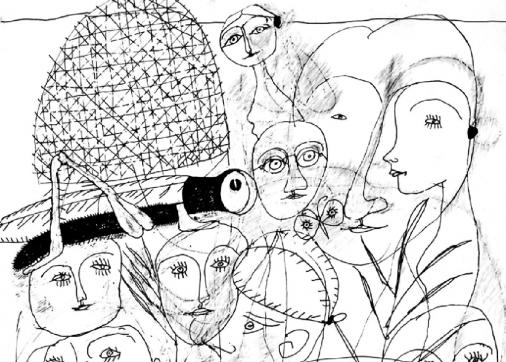\'التقدم\' و\'التخلّف\' أهما حقا خرافتان؟

يمكن تلخيص الأطروحة المركزية للمفكر المصري جلال أمين بخصوص مفهومي “التقدم” و”التخلّف” هنا في المقابلة التي أجرتها معه “مجلة الجديد”، أو في كتابه الذي يحمل عنوان “خرافة التقدم والتخلّف” على النحو التالي: إنّ مفهومي “التقدم” و”التخلف” بما هما توصيفان للحالة الاقتصادية والعلمية في كلٍّ من الغرب والشرق هما مفهومان ينتميان إلى جنس الخرافة. وقد صادف أن الحقبة الراهنة من تاريخ البشرية قد ضبطت العرب متلبّسين بداء التخلّف، بعد أن كانوا ذات يوم من صنّاع الحضارات. وعليه فما من مانع موضوعي يحول دون استردادهم لبرهة التقدم.
إذن فالشروع في “التقدم”، أو استعادته -بحسب التعبير الحرفي للكاتب -ليس أمرا متعذّرا. و”ضعف الإرادة”، والشعور بالعار الذي عشش في نفوسنا من جراء هزيمة عام 1967 هو ما يجعلنا نتوهّم استحالة تحقيقه على أرض الواقع. والمهّم في الموضوع، بحسب رأي الدكتور جلال أمين، هو أن تتوفّر لنا الشجاعة على اتخاذ قرار الفعل، وأن نطرد من أذهاننا “عقدة الخواجة”، ونتخلّص من شعور العار المصاحب لها. وعندما نحقّق ذلك نكون قد حقّقنا الخطوة الأولى الضرورية لإحداث الإصلاح الاقتصادي، الذي سيمكّننا من جَسْرِ الهوة بيننا وبين الغرب، وبالتالي علاج كافة أوجه الخلل التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية.
وفي البدء لا بد لنا أن نحسّ بالغبطة للنيّة الطيّبة القائمة من وراء مثل ذلك الطرح وما فيه من تبسيط للمشكلات، وتبسيط أكبر للحلول المريحة والقطعية لها. وعلى العموم فإن النهايات السعيدة، المفعمة بالتفاؤل، وبالثقة الكبيرة في النفس، تحمل إراحة للقارئ من التصديع الذي تسبّبه كتابات الكثير من المستشرقين الغربيّين، وأشهرهم في أيامنا هذه برنارد لويس، وهي كتابات ما انفكّت، بمناسبة ومن دون مناسبة، تذكّرنا بموقعنا الهامشي في هذا الكون، وبأن تكويننا العقلي والجيني يجعل من شبه المحال علينا الالتحاق بركب المتقدمين اقتصاديا وحضاريا. وهي بالمثل، ردّ غير مباشر على كتابات البعض من كتّابنا، ممن يعشش شعور العار في أذهانهم، على نحو يجعلهم لا يجيدون سوى تعتيم الصورة أمام أعين الناس، وجَلْدِ ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وبالتالي إغلاق أي نوافذ أمام ما كان يمكن لأحلامنا وآمالنا أن تقتات عليها. وفي الحالتين، حالتنا مع المستشرقين وحالتنا مع المتشائمين منا، لا يرتسم أمام الراغبين بالفكاك من أسر التخلّف غير الموات واللاجدوى.
بيد أنّ انتزاع مفهومي “التقدم” و”التخلّف” من تعالقاتهما الماديّة، وتحويلهما إلى حالة ذهنية، شأنهما في ذلك شأن الخرافة، التي لا وجود لها إلا في أذهان المعتقدين بها، وإن كان يقدّم عزاء وتخفيفا من حجم المشكلات، فإنه لا يحمل حلولا جذرية يمكن الركون إليها. وبالطبع لا نتأخر في اكتشاف أنّ الروح الوسطية، التصالحية، التي عالج بها الدكتور جلال أمين موضوعاته هي المسؤولة عن طرحه التبسيطي للأمور على نحو الذي لخّصناها به.
وفي البداية لا خلاف معه حول أنّ مفهومي “التقدّم” و”التخلّف”، وحقول الدلالة التي يشيران إليها هما مفهومان حديثان. وقبل عصورنا الحديثة هذه، كان البشر قد استخدموا في تحديدهم لـ”الأنا” ولـ”الآخر” توصيفات أخرى غير هذه، بدءا من القسمة التي قَرَن اليونانيون من خلالها التحضّر بـ”اليوناني” و”البربرية” بكلّ ما هو “غير يوناني”، وصولا إلى فترة العصور الوسطى التي قسّم البشر أنفسهم فيها إلى “مؤمنين” و”كُفّار”، وميّزوا في الجغرافيا التي يقطنونها بين “دار سلام” في مواجهة “دار حرب”!
والواقع أن مفهومي “التقدّم” و”التخلّف” وإن كان وقعهما يستحضر صلتهما بـ”العِلْم” وحقوله المتنوِّعة، وبمستوى الازدهار الماديّ الصناعي الذي يعيشه هذا المجتمع ولا يعيشه ذاك، إلاّ أنّ ميادين الدلالة التي صارا يشيران إليها مع مرور الأيام بدأت تتّسع، بحيث باتت تشمل جميع مناحي الحياة، وأنماط العيش، وأشكال تمثّل البشر للواقع الماديّ من حولهم. وذلك بالضبط هو ما أعطى، ولا يزال، لهذين المفهومين وَقْعُهُما المربك في النفوس. وبالتالي فالتركيز على الجانب الاقتصادي للمفهومين بمعزل عن الجوانب الأخرى، قد يعزّز الوهم بأن الاقتصاد وحده كفيلٌ بحلّ المشكلات الناجمة عن حالة التخلّف، وأن تحقيق التقدم لا يستدعي من جانبنا تقديم تنازلات موجعة تقود إلى التخلّف وتُبقي عليه. يعني أن التقدم والحداثة والانتماء إلى بُنانا الفكرية والقناعات التي اعتدنا تاريخيا العيش في كنفها.
وفي حديث جلال أمين عن التقدم الاقتصادي الذي تحقّق في مصر في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، ولنا نحن أن نضيف إلى الصورة دولا أخرى مثل سوريا والعراق لتشابه الشروط التاريخية بين جميع تلك البلدان، نراه يغفل ما حدث في تلك الدول من تدمير لم يعرف الشفقة لطبقتي البرجوازية وكبار ملاّك الأراضي، ونهب لما امتلكه أفرادهما من أموال وأطيان، وصولا إلى تلطيخ سمعة هؤلاء بالوحل وتصويرهم باعتبارهم أُجَراء للاستعمار وأذنابا له.
والاستفاضة في هذا الأمر تُخرِج مادتنا عن الوظيفة المرسومة لها، إلا أن بالإمكان استجلاء الصورة بمجملها والاطّلاع على أوجهها المتعدّدة والمتباينة، عبر العودة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى مذكّرات المفكر العربي الراحل عبدالرحمن بدوي، المتحدر من طبقة كبار مُلاّك الأراضي. ففي ما كتبه توضيحٌ صادقٌ معزّزٌ بالوثائق والأرقام لمبلغ التدمير الاقتصادي الذي شهدته مصر بعد تسلّم العسكريتاريا لمقاليد الحكم بعيد ثورة يوليو عام 1952.
وأيّا كانت حقيقة ما جرى فإنّه كان يتعذّر علينا، إلا عبر ضرب من ضروب التخمين، تصوّر ما كان سيكون عليه شكل منطقتنا العربية لو أن حُكم الطبقات الاقتصادية الكبرى كان قد تواصل، إلا أنّ لدينا أكيدة بالحصاد المرّ الذي أتت به تجربة العسكر في الحكم، وهي تجربة عيّشَتْنا في قلب هزائم متلاحقة، تآكل معها، حتى ما كان قد تحقّق من تقدم اقتصادي ضئيل في ظلّ السيطرة الاستعمارية السابقة. بل إن أخطر ما جرى تمثّل بالاستخفاف بالخطر المصيري الذي أحدثه قيام إسرائيل، بما هي واقع استعماري توسعيّ، والتعامل مع ذلك التهديد المصيري بخزائن منهوبة وشعارات جوفاء. وهكذا، ورغم الوعود التي حملها تحقيق الاستقلال عن المستعمر بإمكان الخلاص وتحقيق التنمية المنشودة إلا أن الصعوبات الجمّة، التي واجهها الحكام الوطنيون، والكثير من تلك الصعوبات من صُنع أولئك الحكام أنفسهم، قد أعادت الاستعمار والتخلّف من النافذة بعد أن جرى طردهما من الباب. وبالتالي فأيّ حديث عن “التقدّم” و”التخلّف” ينبغي أن يتخلّص أوّلا من خرافة اعتبارهما خرافتين، وأن يميّز بين الفئات صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير، والمؤهّلة أكثر من غيرها لإحداث النقلة باتجاه “التقدم” أيّاً كانت الاستحقاقات المترتبة على ذلك!
ثم إن تركيز جلال أمين على الاقتصاد وحده، بل على أوجُه محدّدة منه، قاده غير مرّة للإشارة إلى الفوارق الضئيلة التي كانت تفصل بيننا وبين الغرب أيام محمّد علي باشا. وقد نتّفق معه في إشاراته تلك لو أنها تركّزت حول أن الضآلة المزعومة لتلك الفوارق بيننا وبين الغرب، بدت ضئيلة في وعي أسلافنا، لأنهم لم يستوعبوها دفعة واحدة بل على جُرعات. فالقرنان اللذان تحدث عنهما الدكتور جلال أمين وقال إنهما كانا يفصلاننا عن الغرب، كانا في الحقيقة قرنين حاسمين في مسيرة التطور البشريّ. فقد أسهما في تغيير رؤية البشر، وربما للأبد، للكون الذي يعيشون فيه، ولموقعهم داخل ذلك الكون. والهدم الذي مورس بلا هوادة ضد العالم البطلمي (نسبة إلى بطليموس) ابتداء من القرن السادس عشر الميلادي، وما تبعه، على مستوى الفلسفة، من إحلال للكوجيتو الديكارتي كمرجعية بديلة عن مرجعية أرسطو، والثورة على الكلاسيكية وأساليبها الموروثة، كلّ ذلك وغيره كان قد مكّن مواطن الغرب من أن يبتدع علوما وأشكالا فلسفية وأدبية جديدة كلّ الجدّة بمعزل عن معارف الأقدمين، بل وفي استغناء تام عنها إنْ لزم الأمر.
على أن أخطر المشكلات التي واجهها أسلافنا عند اصطدامهم بالحداثة الغربية ممثلة بالجحافل النابليونية أوّلا، ثم بالاستعمار الذي تلاها، لم يكن هذا على أهميته القصوى، بل تمثّلت في إدراكهم المفجع أن سعيهم لبلوغ تقدم تكنولوجي مماثل لما تحقّق في الغرب أو تقليص الفارق التكنولوجي بينهم وبينه إلى الحدود الدنيا، أمرٌ لا يتوقّف على نواياهم الصادقة وحدها، ولا على امتلاكهم لإرادة التقدّم، بل على حقيقة أن استعمار الغرب لأجزاء واسعة من الكرة الأرضية، ونهب ثروات شعوب العالم التي جرى وسمها بميسم التخلُّفِ، كان شرطا ضروريّا لدوام ازدهار الغرب، تكنولوجيا وحضاريا، حتى ولو شكّل ذلك نقضا للمبادئ الإنسانية التي كان “عصر التنوير” قد بشّر بها. ورغم زوال الاستعمار بأشكاله القديمة إلاّ أنّ الاطّلاع على كتاب مثل كتاب “الاغتيال الاقتصادي للأمم” لجون بيركنز، بطبعته العربية الصادرة في مصر عام 2012، يرينا على نحو فجّ، وبلسان أحد قراصنة الاقتصاد الدوليين، حقيقة الممارسات القاتلة التي لجأت إليها، وما تزال، كبرى الشركات العابرة للقارات ومراكز البحث التابعة لها في سعيها المحموم لإرباك الدول المستقلّة حديثا عن الاستعمار، ولتوريطها بمشكلات لا فكاك للضحية منها إلا بمعودة الالتجاء إلى أحضان خانقيها!
هل عتّمنا على الصورة التي رسمها جلال أمين وحملت في طيّاتها الكثير من الأمل؟ ربما. ولكن ما العمل والصورة الحقيقية أعقد من أن يجري التعامل معها باعتبارها حديث “خرافة”!