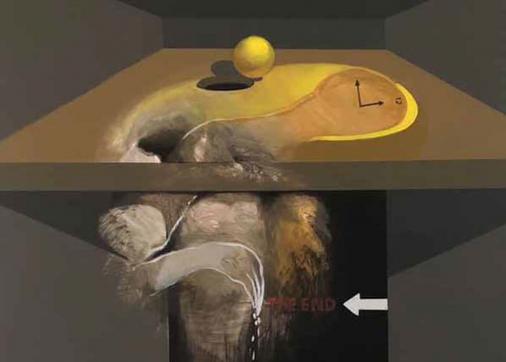الثّقة بوصفها واجبًا إنسانيًّا

دَرَجَتِ العادةُ على تكريس قِيَم الجود، والتسامح، والمحبّة، والإيثار.. إلخ، بوصفها قيمًا ضروريّة لقيام مجتمع مُتماسك قوامه الإنسانيّة المتفلِّتة من ربقة الأثرة، والحقد. لكن نادرًا ما نقع على فيلسوف يتناول مفهوم الثّقة بوصفه قيمة، في المقام الأوّل، ومن ثمّ بوصفه واجبًا ينبغي لكلّ كائنٍ عاقل أن يخضع له خضوعه للواجبات الأخلاقيّة الكانطيّة، وذلك بمحض حريّته وإرادته الواعية والمسؤولة. تلكم هي المسألة الّتي تنعقدُ مقالتنا عليها، بدءًا من تَبيّن ماهيّة الثّقة، مرورًا بتمييز الثّقة بالذّات من الثّقة بالآخر، وإلقاء الضّوء على ترابطهما، وانتهاءً باستنباط علاقة عكسيّة بين تراجع الثّقة ونموّ المفاهيم القانونيّة.
باسل بديع الزّين
1 - الثّقة مُبْصِرةٌ وليست عمياء
يطيبُ للمتحدّثين عن علاقتهم المُميَّزة بالآخر أن يصفوها بأنّها علاقةٌ مثاليّةٌ، ولا يَنون يؤكِّدونَ أنّ ثقتهم بآخرهم هذا ثقة عمياء لا ينال منها شكّ، ولا تَعتَوِرُها ريبة. بيد أنّ المشكلة تكمن هنا في التّوصيف وليس في الواقع، بمعنى أنّ العلاقة في تجلّياتها الواقعيّة قد تكون صافيةً ونقيّة لا يشوبها غدرٌ ولا خداع، لكن مع ذلك، لا يُمكن أن نُسارِع إلى نَعْت الثّقة المتولِّدة من الصّفاء والنّقاء بأنّها ثقة عمياء. فالعمى يعني فقدان البصر؛ ويقيني أنّ التجرّؤَ على استخدام هذا النّعت هو من باب تأكيد المؤكَّد، وتبيان أنّ العلاقة وصلت إلى مرحلة لا يحتاج فيها الطّرفان إلى تفحّص مضامين النّوايا، والتماس الحَذَر.
وهنا نتساءل: أَوَلَم تَتكوَّن تلك الثّقةُ نتيجةَ معاينةٍ حثيثةٍ لمجرى الوقائع الحياتيّة اليوميّة، وتفحُّص المواقف؟ الحقّ أنّ الثّقة تُبنى ولا تُعطى، تُكتَسَبُ ولا تُمنَح. بعبارة أخرى، لا يُمكن للثّقةَ أن تَلبَس لبوسَ الحبّ. لا مِراء في أنّ الحبّ يُومضُ كَبرقٍ خُلَّب، يَسلبُ إرادةَ العاشق، ويزجّ به في أتون تجربةٍ عاصفةٍ يُحجمُ عن تأمُّلِ تبعاتِها إلى حين التعثّر. عند تعثّر التجربة العاطفيّة ينبلج سؤال الثّقة: هل كانت في محلّها؟ على العكس، غالبًا ما تكون تجربةُ الحبِّ الّتي تأتي تتويجًا لمسار تكوّن الثّقة تجربةً باردةً تفتقر إلى الزّخم الانفعاليّ، ومعاينة الأحداث، ذلك بأنّها تجربة بُنيَت على حسابات دقيقة نَحَّت الجانب الانفعاليّ، وبَنت مواقفها بناءً ينسجم مع تطوّر العلاقة وتكشّفاتها.
الثّقة إذًا مُبصِرة، لأنّها تُسائِلُ وتُعلِّلُ وتَربِطُ وتُحلِّلُ. وما وصفها بالعمياء إلّا أَمارةٌ على أنّها وصلت إلى حدّ الاكتفاء، أي إلى حدّ لا تحتاج معه إلى برهان. والحقّ أنّ الثّقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالزّمن، فهذا الأخير من شأنه أن يُعزِّزها أو يحجبها. لكن عندما تصل الثّقة إلى درجة الاكتفاء المطلق، تتحرّر من البعد الزّمنيّ، وتُصبح ثقة خالصة. مع ذلك، لا يُمكننا أن نُطلق عليها صفة العمى، لأنّها تكوّنت بفعلِ إبصارٍ متنامٍ، وكشفٍ مُتلاحق؛ وما الحُكم النهائيّ إلّا حكم بالرّؤية الواضحة، والمعاينة الشفّافة.
تكلّمنا حتّى الآن عن الثّقة بإطلاق، أو أقلّه على كيفيّة انبنائها وتكوّنها. لكن هل تقتصر الثّقة على علاقتنا بالآخر؟ أو بتعبير أدقّ هل يُمكن أن نبني علاقة ثقة بالآخر ما لم نَبنِ علاقة ثقة بأنفسنا؟
2 - الثّقة بالذّات وتجربة الخيبة
ترتبط كلّ من الثّقة بالذّات والخيبة ارتباطًا وثيقًا بالتوقّع. بتعبير أوضح، إذا تطابقت الثّقة بالذّات مع موضوع انتظارها، فإنّ الخيبةَ تنتفي بانتفاء موضوعها. لكِنْ إذا جاء موضوعُ الانتظار مُخالفًا لتوقّع الذّات، عندها تنتفي الثّقة بالنّفس لتحلّ محلّها تجربة الخيبة المريرة. وعليه، نتساءل: كيف يُمكن الثّقةَ بالذّات أن تنبني؟
تنعقدُ الثّقة بالذّات في قيامها على عاملَين أساسيَّيْن: عامل ذاتيّ وآخر موضوعيّ. نقصد بالعامل الذّاتيّ استشراف القدرات، وتفحُّص الإمكانات، ومعاينة الطّاقات. واقع الأمر أنّ الذّاتَ حصيلةُ ما تجمعه وتُكوِّنه طوال سنوات تبلورها وتشكّلها. والحال أنّه ينبغي تمييز جنون العظمة من الثّقة الـمُحكَمة. فمجنون العظمة مريضٌ يخال أنّه مركز الكون، وأنّه يمتلك من القدرات ما يُخوّله أن يحصد تميُّزًا منقطع النّظير. وعند هذا الحدّ، تتساوق تجربة مجنون العظمة الّذي يمتلك قدرات بيِّنة مع الشّخص الّذي يفتقر إلى أبسط الإمكانات المعرفيّة والعلميّة والأدبيّة. فكلاهما يعزو إلى الذّات قدرات ليست فيها، وكلاهما يتوهّم أمورًا تحدث بمحض الخيال وليس الواقع. لذا، تتوقّف حِدّة الخيبة على مقدار سقف التوقّعات. فكلّما كان سقف التوقّعات غير الواقعيّة مرتفعًا، جاءت الخيبة أقسى.
بناء على ما تقدّم، ينبغي للتوقّعات أن تكون على قدر القدرات، عندئذ تنتفي الخيبة انتفاء تامًّا. صحيح أنّ التّعويل على القدرات أحيانًا لا يُفضي إلى التوقّع المنشود، لكن شتّان بين الخيبة الّتي لن تقوم لصاحبها من بعدها قائمة، والخيبة المُحفِّزة الّتي تشحذ همّة صاحبها، وتدفعه إلى المحاولة من جديد. وهنا تحديدًا يبرز الثّقة بالذّات.
لا يُمكن مريضَ جنونِ العظمةِ بِوَجْهَيه المذكورَين أعلاه أن يجمع شتات نفسه إذا ألَّمت به خيبة عظيمة. فعلاوة على أنّ الإمكانات تُعوِزه، لا يتطابق موضوع انتظاره وقدراته. حقيقة الأمر أنّ موضوع انتظاره يتجاوز بمراحل كثيرة الثّقة الّتي وهبَها وهبًا مجّانيًّا لذاته من دون أيّ تدبّرٍ أو حصافةٍ في الرصّد والتبيّن. هذه الثّقة غير مُتطلَّبة، بل إنّها تُمثِّل خطرًا جسيمًا ينبغي التلفّت إليه مُبَكِّرًا.
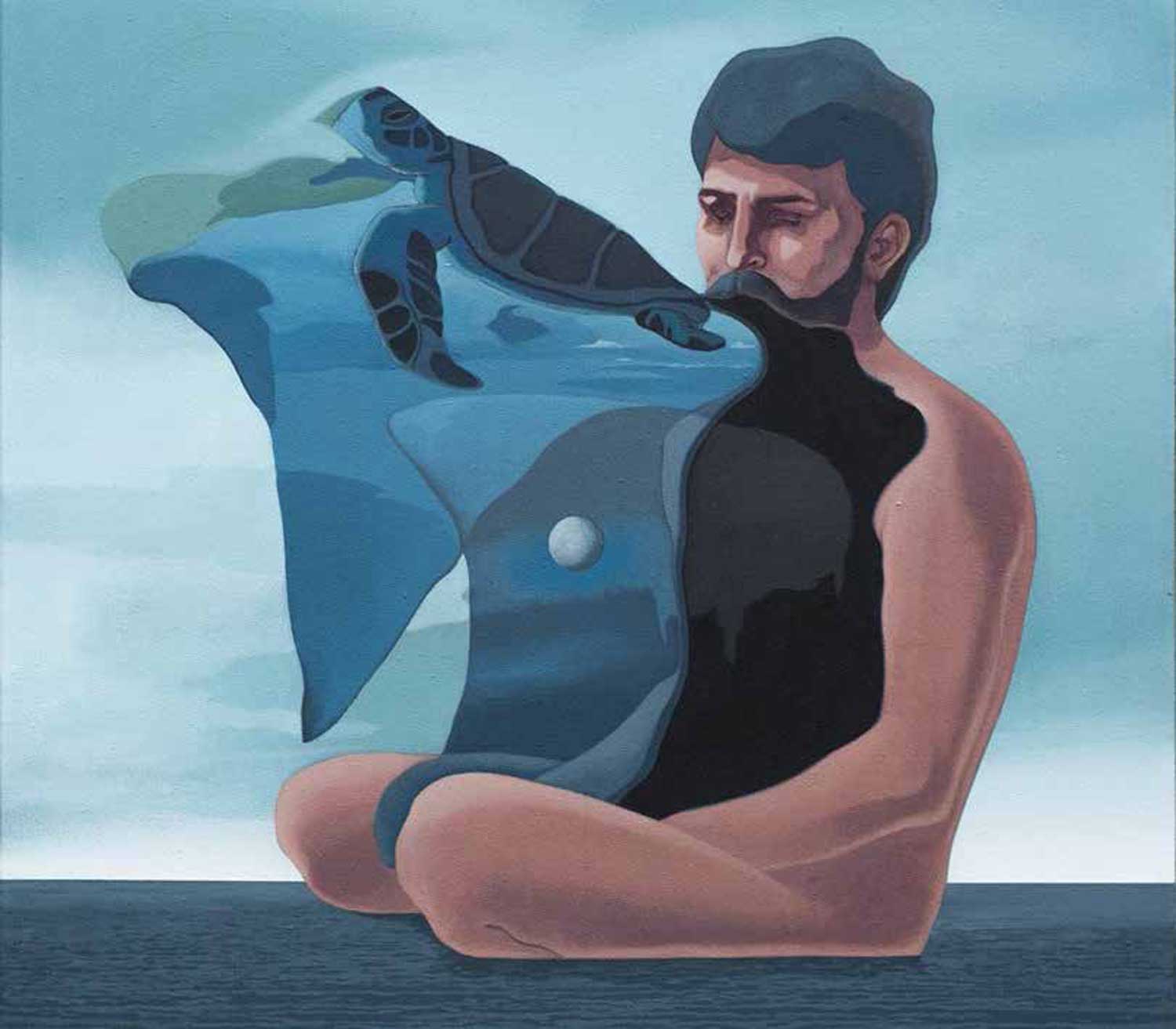
على المقلب الآخر (العامل الموضوعيّ)، قد يُمْنَى باحثٌ أو مُفَكِّرٌ أو أديبٌ أو شاعرٌ أو عالِمٌ بخيبةٍ نكراء، بحيث لا يتطابق توقّعه وموضوع انتظاره. واقع الأمر أنّنا نُطالِع هذه الخيبات يوميًّا، مع أنّنا نملك من القدرات ما يُخوّلنا أن نُمَنّي النّفس بالقبض على موضوع انتظارنا، ومع ذلك يُفاجئنا البَونُ الشّاسعُ بين الواقع والمرتجى. هنا تتجاوز الثّقة بالذّات كونها مطلبًا ضروريًّا، وتغدو واجبًا قيميًّا بكلّ ما للكلمة من معنى. إنّ اهتزاز الثّقة بالذّات من جرّاء واقع مرير لا يُفيد الخيبة بل يُفيد الاغتراب. تتأتّى الخيبة، برأينا، من جرّاء رفع سقف التوقّعات استنادًا إلى قدرات هشّة أو إمكانات ضعيفة. أمّا الاغتراب فيفيد تناقض الوقائع والظّروف مع القدرات الحقّة. الخيبة تعكس واقعًا مأمولًا وقابلًا للتحقّق في مقابل ذاتٍ لا يُمكنها أن تبلغ هذا الواقع لنقصٍ يعتورها في الإعداد والموهبة والكفاءة. أمّا الاغتراب فَيعكس ذاتًا ممتلئة بالقدرات والموهبة والكفاءة، لكنّها لا تبلغ الواقع المنشود بالنّظر إلى معطوبيّة الحدث البشريّ، والانقلاب المفهوميّ، والاهتزاز القيميّ. عندئذ، يجدر بالذّات أن تمتحن ثقتها بنفسها، ذلك بأنّ تقهقرها يعني بالضّرورة تقهقرَ قيمةٍ ساميةٍ تتجلّى في الإيمان بما نمتلكه، وبما أعددنا العدّة له. وواجب الإنصات إلى الثّقة بالذّات بمعزلٍ عن النتيجة المتوخّاة لا يُمثّل انفصالًا عن الواقع. بمعنى أوضح، تقع على الذّات المتمكِّنة مهمّة تشكيل الواقع وفق تطلّعاتها، وإمكاناتها. صحيح أنّ الاغتراب مُضنٍ، لكنّه سيكون اغترابًا مُضاعفًا إذا استنكف المغترِبُ عن المحاولة، وفقد ثقته بنفسه. وعندما أتحدّث عن الاغتراب، أعني الواقع من حولنا، والواقع من حولنا يصنعه أُناسٌ آخرون، وهنا تتجلّى بوضوح مسألة الثّقة بالذّات وعلاقتها بالآخر.
3 - الثّقة بالذّات عينُها كآخر
لا شكّ في أنّ الثّقة بالذّات تنبني في جزء كبير منها على اعتراف الآخر بها. لكن أين نستطيع أن نموضِع هذا الآخر تحديدًا؟ حقيقة الأمر أنّ الآخر يلعب دورًا مزدوجًا: فهو من جهة، قد يخون ثقتنا به، ومن جهة أخرى، قد يحجب ثقته بنا، فهل ينبغي والحال هذه أن نفقد ثقتنا بأنفسنا؟
عودٌ على بدء، يُمكن القول إنّ الثّقة بالآخر يجب أن تكون ثقة مُبصِرة وغير عمياء. مع ذلك، يحدث أن تتزلزل ثقتنا بالآخر الّتي انبنت سنوات من جرّاء موقفٍ بعينه أو مواقف بعينها. لا تعنينا هنا الإشارة إلى التحليلات البسيكولوجيّة الّتي لا تُعتِّم أن تُسائل الأسس اللاواعية لانبناء هذه الثّقة، بل نكتفي بتوضيح تبعات اختلال هذه الثّقة بالآخر. من البدهيّ القول إنّ اختلال الثّقة بالآخر يُفضي من بابٍ أَولى إلى اختلال الثّقة بالذّات. هل كنّا سُذّجًا إلى هذا الحدّ؟ تنطوي الإجابة ببساطة على شقّين اثنين: 1 – معرفة الآخر؛ 2 – تصويب الاختلال الذّاتيّ.
إذا كان الآخرُ هو الّذي يمنحني الاعتراف، فمن باب أولى أن أمنحه ثقتي، في ضربٍ من العمليّة التكامليّة التبادليّة المنشودة. لكنّ خذلان الثّقة لا يعني أن ينسحب بالضّرورة على الاعتراف، ومن ثمّ على علاقتي بالآخر بعامّة. صحيح أنّ ثقتي بنفسي تنعقد في جزء منها على اعتراف الآخر بي، بيد أنّ اختلال الثّقة بالآخر ينبغي ألّا يفيد اختلال ثقتي بنفسي أوّلًا، وبالآخر بإطلاق ثانيًا. ما دمنا نمتلك الإمكانات الوافية، والقدرات الشّافية، فلا يجدرنّ بتجارب عرضيّة، ومواقف وقتيّة، واختبارات عابرة أن تنزع عنّا ثقتنا بأنفسنا؛ والوجوب الّذي نعنيه هنا وجوب قيميّ كما سبق أن أسلفنا. لسنا نرى في القيمة الحقّة والمحقّة الّتي نعزوها إلى أنفسنا قيمة تقلّ شأنًا عن الاعتبارات الأخلاقيّة من مثل احترام الذّات، والكرامة الإنسانيّة. من ذا الّذي يستطيع أن يسلبنا قدس أقداسنا؟ من ذا الّذي بِمِكْنَتِه أن يحجب عنّا مسيرة اختتطناها لأنفسنا طوال سنوات؟ ولا نُغالي إذا قلنا إنّ ثقتنا بأنفسنا قيمة تتفوّق على سائر القيم، ومنها ينبت مفهوم الالتزام بالقواعد الآمرة الكانطيّة. بعبارة أوضح، قبل أن تُصبِح “مُسلّمة سلوكي القادة العامّة للإنسانيّة”، وقبل أن أُعامِل الإنسانيّة في شخصي بوصفها غاية في ذاتها”، عليّ أن أُخلِص لقيمة القيم، عنيتُ الثّقة بالذّات.
هذا من جهة. من جهة أخرى، إنّ اختلال الثّقة بجملة أشخاص لا يعني اختلال الثّقة بالبشريّة قاطبة. وذلكم واجب آخر، بل قُل الوجه الآخر للواجب الّذي يُحتِّم عليّ أن أثق بالآخر بوصفه جزءًا من تكوينيّ المفهوميّ والواقعيّ في آنٍ معًا. إنّ الارتداد إلى العزلة، والاعتكاف على الوحدة، ونبذ البشريّة، إنكارٌ لقيمة فضلى، واستنكاف عن أداء واجب حقّ. لذا جاء عنوان المقالة: الثّقة بوصفها إنسانيًّا. ومع ذلك، لا يني البشر يُحطّمون هذه الثّقة، وفي رأينا أنّ القوانين لم تُسَنّ إلّا نتيجة اختلال عميق في بنية الثّقة نفسها.
4 - الثّقة والقانون
هل عرف البشر الأوائل النّصوص القانونيّة؟ أَوَليسَت الأعراف والعادات مصادر تشريعٍ تتفوّق أحيانًا على القوانين المكتوبة؟ أَلَم تزلِ العلاقات التجاريّة في بعض الدّول محكومةً بالكلمة وليس بالعقود؟ ألا يتفوّق الموجب الطبيعيّ أخلاقيًّا في العالم بأسره على الموجب المدنيّ؟
واقع الأمر أنّ العقود بتعريفها وسيلة إثبات. وهنا نتساءل: ما الّذي تحتاج العقود إلى إثباته؟ الإجابة ببساطة على النّحو الآتي: ينشأ الحقّ بمجرّد انعقاد الثّقة بين الطّرفين على أداء التزاماتهما. لكَ ما لكَ، وعليَّ ما عليَّ، والعكس. لكنّ الخلل نشأ عندما استنكف أحد طرَفي الحقّ عن أداء واجبه. عندها برزت الحاجة ملحّة إلى ابتكار العقود بوصفها وسيلة إثبات ثقة نجم عنها حقّ. والحال أنّ للثقة مفاعيلَ، وإلّا لما ترتّب على الإخلال بها أيّ أثر. الثّقة اعتراف بأنّ الآخر سيحترم كلمته، ويفي بوعده. لكنّ خيانة الثّقة استوجبت إبرام العقود. لذا نقول: إنّ العقود خيانة للثّقة، وإخلال بواجب احترام الكلمة والوفاء بالعهود. والجدير بالذّكر أنّ المعاملات التجاريّة في الكثير من الدّول ما زالت محكومة بكلمة التجّار من دون الحاجة إلى إبرام عقد. والجدير بالذّكر أيضًا أنّ بعض المؤسّسات التعليميّة تحتكم إلى الكلمة في علاقتها بكادرها التعليميّ، فلا يُبرم عقد بينهما ولا يُجَدّد.
وعليه، فإنّ جُلّ ما ندعو إليه أن يُنظر في الثّقة على أنّها واجب قيميّ، عندها يُمكن للبشريّة أن تخطو خطوة جريئة باتّجاه الترسيخ الأخلاقيّ للعلاقات الإنسانيّة. لكنْ، أنّى لهذه الغاية أن تتحقّق ونحن نشهد أبسط حقوق الإنسان تُنتهَك؟ أين المواثيق الدوليّة من الحروب والقتل والدمار؟ أين الإنسانيّة الّتي ادّعت شرعة حقوق الإنسان أنّها كرّستها؟ وهل حلّت علاقات القوّة محلّ العلاقات المنبنية على الحقّ والمساواة والاحترام والثّقة؟ يبدو أنّنا أمام تجربة خيبة يعكسها العجز عن تغيير الواقع، وأمام تجربة اغتراب تُبقي على الإنسانيّة فكرة خالصة في أذهان المنظّرين والحالمين.