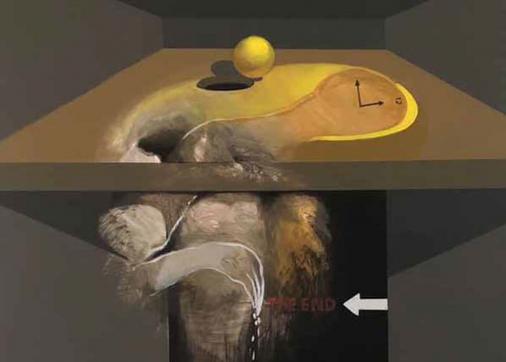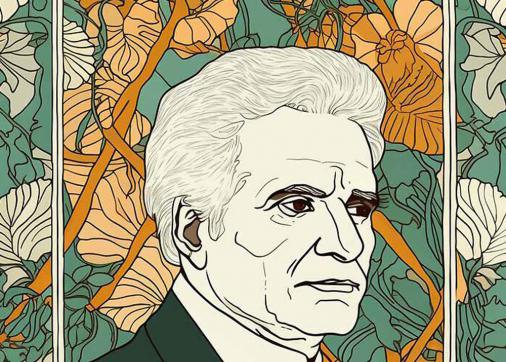الناقد الكامل

ربما كان كولردج أعظم النقاد الإنكليز، وربما كان آخرهم بمعنى من المعاني. وبعد كولردج أصبح لدينا ماثيو أرنوك، بيد أن أرنوك – وأعتقد أن هذا مسلّم به – كان داعية من دعاة النقد أكثر منه ناقدا. وكان مروجا ومبسطا للأفكار، أكثر منه خالقا لها. وطالما ظلت هذه الجزيرة جزيرة (ولسنا بأقرب إلى القارة(*) مما كان عليه معاصرو أرنولد) فإن أعمال أرنولد تظل هامة. فهي ما تزال بمثابة الجسر عبر القنال، باعتبارها تمثل حاسة جيدة دائما.
منذ أن حاول أرنولد تقويم اعوجاج مواطنيه، سار النقد الإنكليزي في اتجاهين. وعندما لاحظ ناقد متميز في مقال صحفي مؤخرا أن “الشعر أشد أشكال النشاط العقلي تنظيما”، كنا ندرك أننا لم نكن نقرأ لا لكولردج ولا لأرنولد. إذ لا يقتصر الأمر على أن كلمتي “تنظيم” و”نشاط” اللتين تقعان في مقطع واحد، لهما إيحاء غامض ومألوف في اللغة العلمية التي تتميز بها الكتابة الحديثة، وإنما أصبح المرء يسأل أسئلة لم يكن كولردج “أرنولد ليسمحا له بطرحها. فكيف يمكن أن يكون الشعر- على سبيل المثال – أشد تنظيما من عالم الفلك والفيزياء أو الرياضيات البحتة، وهي العلوم التي نتخيل أنها بالنسبة إلى العالم الذي يزاولها “نشاط عقلي” من نوع منظم تنظيما شديدا..
ويمضي ناقدنا فيقول بسلاسة وصدق:
“إن منظومات الكلمات التي تتطرطش كبقع الدهان على قماش لوحة فارغة، قد تثير الدهشة.. إلا أنها تنطوي على أيّ مغزى في تاريخ الأدب”.
“ربما كانت العبارات التي اشتهر بها أرنولد غير كافية، فقد تثير من الشكوك أكثر مما تزيله منها، إلا أنها تنطوي على شيء من المعنى”.
وإذا كانت عبارة على غرار، “أشد أشكال النشاط العقلي تنظيما” هي أفضل تنظيم للفكر يمكن أن يقدمه النقد المعاصر، ممثلا بممثل متميز، فإننا يمكن أن نستنتج أن النقد الحديث متدهور.
إن المرض اللفظي الذي لاحظناه الآن، يمكن أن ندع تشخيصه حتى وقت لاحق، إنه ليس بالمرض الذي يعاني منه السيد آرث سيمونز معاناة شديدة (فالعبارة المقتطفة أعلاه ليست للسيد سيمونز بالطبع). إن السيد سيمونز يمثل الاتجاه الآخر. فهو ممثل لما يدعي دائما بـ”النقد الجمالي” أو “النقد الانطباعي”. وهذا النوع من النقد هو الذي أودّ دراسته الآن.
إن السيد سيمونز، خليفة باتر في النقد، وخليفة سوينبرن إلى حد ما ]أشعر أن عبارة “مريض أو آسف” ملك مشترك بين هؤلاء الثلاثة[ هو “الناقد الانطباعي”. إذ يمكن القول إنه، أكثر من سواه، يكشف عن عقل حساس ومثقف – مثقف بفعل تراكم أنواع كثيرة من الانطباعات المستمدة من جميع الفنون ومن العديد من اللغات – أمام العمل الفني. فنقده يعرض أمامنا كالطبق، السجل الأمين للانطباعات التي تفوق انطباعاتنا في عددها وصفائها، لعقل أشد حساسية من عقلنا. إن هذا السجل كما نلاحظ، تأويل، بل ترجمة. ذلك أنه يتعين أن يفرض علينا انطباعات. وهذه الانطباعات إنما يخلفها النقد قدر ما يبثها. ولست أقول للتو إن هذا هو السيد سيمونز، وإنما أقول إن هذا هو الناقد “الانطباعي”، والناقد الانطباعي يفترض أن يكون السيد سيمونز بين يدي كتاب نستطيع أن نتفحصه(1).

إن عشرة مقالات من أصل ثلاثة عشر تعالج مسرحيات لشكسبير كل منها على حدة، ولهذا فمن المناسب أن نتناول واحدة منها كعينة من الكتاب:
“إن أنطونيو وكليوباترا هي في رأيي، أروح مسرحيات شكسبير كلها..”.
ومضي السيد سيمونز في تأملاته فإذا بكليوباترا أروع النساء قاطبة:
“إن الملكة التي أنهت سلالة البطالسة، كانت دائما كوكب الشعراء، كوكبا مؤذيا يلقي بأشعته الضارة، بدءا من هوراس وبروبيرنيوس حتى فيكتور هيغو… ولم تكن كذلك بالنسبة إلى الشعراء فحسب…”.
نتساءل: ما هو مبرر ذلك.
فيما تنبسط أمامنا صفحة عن كليوبترا و…
شيئا فشيئا نجد أن هذه ليست مقالة عن عمل فني أو عمل فكري. فالسيد سيمونز يعيش المسرحية كما يمكن أن يعيشها المرء في المسرح. إنه يستعيد، و……:
“في أيامها الأخيرة، تصل كليوباترا إلى درجة معينة من الرفعة والسمو، فهي تفضل الموت ألف مرة على العيش مادة للسخرية والازدراء في أفواه الرجال، إنها امرأة حتى اللحظة الأخيرة… وهكذا تموت… وتنتهي المسرحية بلمسة من حسرة بالغة…”.
إن انطباعات السيد سيمونز وقد قدمتها على نحو غير عادل، على نحو ممزق أشبه شيء بأوراق ثمرة (أرضي شوكي)، تصبح شديدة الشبه بنوع شائع من المحاضرات الأدبية المألوفة، حيث تعاد رواية قصص المسرحيات أو الروايات، وتقدم دوافع الشخصيات. وبذلك يصبح العمل الفني أسهل بالنسبة إلى المبتدئ. غير أن هذا ليس بالسبب الذي يدعو السيد سيمونز للكتابة. فالسبب الذي نجد من أجله شبها بين مقالته وبين هذا الشكل من التعليم، هو أن “أنطونيو وكليوباترا” مسرحية نحن على معرفة جيدة بها، ولدينا على ذلك، انطباعاتنا الخاصة عنها. إننا قادرون على أن نمتع أنفسها بانطباعاتنا عن الشخصيات وعواطفها. كما أننا لا نجد انطباعات شخص آخر، مهما كانت حساسة، منطوية على مغزى كبير. ولكننا إذا تمكنا من استعادة الزمن الذي كنا نجهل خلاله الرمزيين الفرنسيين، ثم طالعنا كتاب “الحركة الرمزية في الأدب” فإننا نتذكر ذاك الكتاب باعتباره مقدمة لمشاعر جديدة كليا، باعتباره كشفا. وبعد أن نكون قد قرأنا “فرلين” و”لافورغ”، و”رامبو”، وعدنا إلى كتاب السيد سيمونز، فقد نجد أن انطباعاتا تختلف عن انطباعاته. إذ يحتمل ألا تكون للكتاب قيمة دائمة بالنسبة إلى القارئ، إلا أنه قد أدى إلى نتائج ذات أهمية دائمة له.
إن التساؤل لا يتصل بما إذا كانت انطباعات السيد سيمونز “صادقة” أو “زائفة”. فإذا كنت تستطيع أن تعزل “الانطباع”، الشعور الصافي، فتجد بطبيعة الحال أنه ليس صادقا ولا هو بمزيف. والمسألة هي أنك لا تستقر إطلاقا على شعور صاف، وإنما يكون لك رد فعل بطريقة من طريقتين. أو ربما كما أرى السيد سيمونز يفعل، يكون لك رد فعل هو مزيج من الطريقتين. ففي اللحظة التي تحاول فيها أن تصوغ الانطباعات في كلمات، فإنك إما أن تبدأ بالتحليل والتركيب، من أجل أن “eriger en lois” أو تبدأ بخلق شيء آخر. ومن الخطير أن “سونيبرن” الذي تأثر السيد سيمونز بشعره في يوم من الأيام، إنسان مختلف في شعره عنه في نقده، إلى حد أنه إنما يقوم بإرضاء حافز آخر: فهو ينقد، يشرح، يرتب. وقد نقول إن هذا ليس بنقد ناقد، إنه نقد عاطفي وليس عقلانيا، هذا على الرغم من أن هناك رأيين فيما يتصل بهذا الأمر، ولكن باتجاه التحليل والتركيب، ونحو الشروع في “ériger en lois” وليس باتجاه الخلق.
وهكذا فأنا أستنتج أن “سونيبرن” قد وجد مفرغا كافيا للدافع الإبداعي في شعره. ولم يجد شيئا من ذلك في نثره النقدي. إن أسلوب هذا الأخير نثري في جوهره. ونثر السيد سيمونز هو أشد شبها بشعر “سونيبرن” منه بنثره. ويخيل لي – على الرغم من أن فكر المرء يتحرك هنا في ظلام دامس – أن السيد سيمونز هو أشد قلقا، وتأثرا، بما يقرأ، مما كان عليه “سونيبرن” الذي كان رد فعله أقرب إلى أن تجتاحه نوبة عنيفة وفورية وشاملة، من الإعجاب الذي يحتمل أن يكون قد خلفه دون أيّ تغيير من الداخل. إن القلق لدى السيد سيمونز يصل إلى درجة الخلق والإبداع تقريبا: فالقراءة أحيانا تلقح عواطفه لكي تنتج شيئا جديدا ليس هو النقد، ولكنه ليس قذفا، أو طرحا، أو ولادة القدرة على الخلق والإبداع.
إن هذا النوع ليس بالنوع غير الشائع. هذا على الرغم من أن السيد سيمونز متفوق بمراحل، على معظم الذين ينتمون إليه. فبعض الكتّاب إنما ينتمي أساسا إلى النوع الذي يمارس رد فعل على قبض المحرض، فيصنع شيئا جديدا من انطباعاته، ولكنه يعاني من نقص في الحيوية أو من معوق خفي يحول دون الطبيعة ودون أن تأخذ مجراها. إن رد فعله هو رد فعل الشخص العاطفي العادي وقد تطور إلى درجة متميزة. وبالنسبة إلى هذا الشخص العاطفي، فإن ممارسة تجربة العمل الفني، تنطوي على حياته الخاصة على نحو غامض. إن الشخص العاطفي الذي يثير فيه العمل الفني جميع أنواع العواطف التي لا علاقة لها إطلاقا بذلك العمل الفني وإنما هي حوادث طارئة من التداعيات الشخصية، هو فنان غير كامل. فبالنسبة إلى الفنان، تتلاقح الانطباعات والتداعيات التي يثيرها للعمل الفني والتي تتسم بأنها محض شخصية، مع حشد من الانطباعات والتداعيات المستمدة من التجربة متعددة الأبعاد، وينتج عن ذلك “شيء” جديد لم يعد شخصيا تماما، نظرا لأنه عمل فني بذاته.
وقد يكون من التعجل، التخمين، وربما يستحيل الجزم، بالعناصر التي تتحقق في شعر السيد سيمونز البديع والتي تفرض في نثره النقدي. فبالطبع يمكننا القول بأن دارة الانطباع والتعبير في شعر “سونيبرن” كاملة. وكان “سونيبرن” على ذلك، أن يكون ناقدا في نقده أكثر مما هو الأمر بالنسبة إلى السيد سيمونز. وهذا يمنحنا إيضاحا يشير إلى السبب الذي يجعل الفنان – ضمن حدوده الخاصة – يمكن الاعتماد عليه كناقد. إن نقده يكون نقدا وليس إشباعا لرغبة مكبوحة في الإبداع، رغبة قمينة بأن تتدخل تدخلا مميتا لدى معظم الكتاب.

وقبل أن نتداول بشأن ماهية رد الفعل النقدي المناسب للحساسية الفنية، وإلى أي حد يدخل “الشعور” و”الفكر” في النقد، وأي نوع من الفكر يُسمح به، قد يكون أمرا بنّاء أن نسبر قليلا، ذاك المزاج الآخر شديد الاختلاف عن مزاج السيد سيمونز، والذي يغرق بعموميات على غرار تلك التي اقتطفناها في مطلع المقال.
-2-
يمكن أن تؤخذ العبارة التي اقتطفتها قبل قليل، والقائلة إن “الشعر أشد أشكال النشاط العقلي تنظيما” على أنها عينة من عينات الأسلوب التجريدي في النقد. وإن التمييز غير الواضح لدى معظم الناس، بين “المجرد” وبين “المجسد” لا يعود كثيرا إلى حقيقة بينة تتمثل في وجود نمطين من العقل، نمط مجرد وآخر مجسد، قدر ما يعود إلى وجود نمط آخر من العقل، النمط اللفظي أو الفلسفي. وأنا لا أضمر بطبيعة الحال، أي تنديد عام بالفلسفة، وإنما أستخدم الآن كلمة “فلسفي” لكي أغطي العناصر غر العلمية في الفلسفة، ولكي أغطي – في الحقيقة – الشطر الأعظم من النتاج الفلسفي خلال الأعوام المئة الأخيرة.
ثمة طريقتان يمكن أن تكون فيهما كلمة ما “تجريدية”. فقد تنطوي (كلمة نشاط على سبيل المثال) على معنى لا يمكن استيعابه بالاستئناف إلى أي من الحواس. وقد يحتاج إدراكه إلى كبح متعمد لتشبيهات التجربة البصرية أو العضلية، أو على أيّ حال مجهود من مجهودات المخيلة. إن “النشاط”، إذا ما استعمل هذا المصطلح عالم متمرن، قد لا يعني شيئا على الإطلاق، أو ربما يعني شيئا أشد دقة مما يوحي لنا.
وإذا جاز لنا أن نقبل ببعض ملاحظات باسكال وبرتراند راسل عن الرياضيات، فإننا نعتقد أن عالم الرياضيات يتعامل مع “أشياء” أعتقد أنها تنطوي على نفس الدقة التي تنطوي عليها “أشياء” عالم الرياضيات، وأخيرا جاء هيغل، وربما كان الأول في هذا المضمار. لقد كان هيغل بالتأكيد، أعظم أصحاب الأنظمة العاطفية. فقد كان يعامل عواطفه وكأن هناك “أشياء” محددة استثارت هذه العواطف. واعتبر حواريوه قاعدة منها، أن الكلمات تحمل معاني محددة. فتغاضوا عن جنوح الكلمات إلى أن تصبح عواطف غير محددة. (لا يستطيع من لم يحضر ما حدث أن يتخيل لهجة الجزم في صوت البروفسور Eucken عندما ضرب على الطاولة صائحا، Was ist Geist ? Geist ist…).
لو أن اللفظية اقتصرت على الفلاسفة المحترفين لما كان من بأس في ذلك. ولكن فسادهم قد امتد إلى مدى بعيد جدا. قارن لاهوتيا أو صوفيا، قارن مبشرا من القرن السابع عشر، بأي واعظ “ليبرالي” منذ Schleiermacher وستلاحظ أن الكلمات قد تغيرت معانيها: ما خسرته محدد، وما كسبته غير محدد.
لقد كانت التراكمات الهائلة للمعرفة – أو للمعلومات على الأقل – تلك التي فاض بها القرن التاسع عشر، مسؤولة عن قدر مماثل من الجهل الهائل، فعندما يكون هناك الكثير مما يتعين أن يعرف، عندما يكون هناك العديد من حقول المعرفة التي تستخدم فيها الكلمات نفسها بمعان مختلفة، عندما يعرف الكل القليل عن العديد من الأشياء، يصبح من الصعوبة بمكان أن يعرف أحد ما إذا كان يعرف ما يتحدث عنه أو لا يعرف. وعندما لا نعرف، أو عندما لا نعرف ما فيه الكفاية، فإننا نميل دائما إلى استبدال العواطف بالأفكار.
إن الجملة التي اقتطفتها في هذا المقال مرارا، تصلح كمثال على هذه العملية، ويمكن أن يكون من المجزي مفاضلتها بالعبارات الافتتاحية من Posterior Analytics، فليست المعرفة كلها فحسب، وإنما الشعور كله أيضا، يخضع للإدراك. إن مخترع الشعر باعتباره أشد أشكال النشاط العقلي تنظيما، لم يكن مشغولا في عملية الإدراك عندما صاغ هذا التعريف. كما أنه لم يكن لديه ما يعيبه سوى عاطفته حول “الشعر”. والحال أنه كان منهكا في “نشاط” مختلف كل الاختلاف، ليس عن نشاط السيد سيمونز، وإنما عن نشاط أرسطو.
لقد كان أرسطو مفكرا عانى من ولاء أولئك الذين ينبغي اعتبارهم تلامذته أقل مما ينبغي اعتبارهم مشايعيه. إن على المرء أن يكون شديد الريبة فيما يتعلق بقبول أرسطو باعتباره قانونا. فهذا يعني أن نسقط منه الجذوة الحية كلها. لقد كان أولا إنسانا لا يمتلك ذكاء خارقا فحسب، وإنما يمتلك ذكاء شاملا. وهذا الذكاء الشامل يعني أنه كان يستطيع تطبيق ذكائه على أي شيء. إن الذكاء العادي لا يصلح إلا لأنواع معينة من “الأغراض”. فالعالم اللامع، في حال كونه مهتما بالشعر، قد يتوصل إلى أحكام غريبة وشاذة، يحب شاعرا معينا لأنه يذكّره بنفسه، أو يحبّ شاعرا آخر لأنه يعبّر عن المشاعر التي يعجب بها. وربما استخدم الفن، في الحقيقة، لكي يتنفس عن شعور الأثرة الذي كان مكبوحا في اختصاصه. إلا أن أرسطو لم يكن لديه أيّ من هذه الرغبات المشوبة التي يحتاج إلى إروائها. ففي جميع مجالات الاهتمام، كان ينظر إلى “الغرض” وحده بإصرار وهو يقدم في رسالته القصيرة مثالا خارجيا – ليس عن القوانين، أو حتى عن المنهج- إذ لا يوجد منهج آخر غير أن يكون المرء شديد الذكاء، وإنما عن الذكاء نفسه وهو يعمل بمرونة في تحليل الإحساس إلى حد التوصل إلى المبدأ والتعريف.
لقد كان أرسطو أقل مما كان عليه هوراس بكثير، النموذج للنقد حتى القرن التاسع عشر، إن التعاليم التي يتقدمها، هوراس أو “بوالو” إنما هي مجرد تحليل ناقص. إنها تبدو كقانون، أو قاعدة، لأنها لا تبدو في أشد أشكالها عمومية. إنها تجريبية، وعندما نفهم الضرورة، كما يعلم سبينوزا، فإننا نكون أحرارا لأننا نقبل بذلك.
إن الناقد الدوغمائي الذي يضع القاعدة، ويشدد التأكيد على قيمة ما، قد ترك عمله ناقصا. وإن قواعد من هذا النوع قد تكون مبررة من أجل كسب الوقت. ولكن في المسائل ذات الأهمية الكبرى، ينبغي على الناقد ألا يرغم على الطاعة، وألا يقدم أحكاما عن “الأسوأ” و”الأفضل”. عليه أن يشرح وأن يوضح، والقارئ هو الذي يبلور الحكم الصحيح بنفسه.

ومرة أخرى، فإن الناقد “التقني” البحت، الناقد الذي يكتب من أجل أن يشرح عملا ينطوي على بعض الجدة، أو يقدم درسا لممارسي فن من الفنون، يمكن أن ندعوه ناقدا بأضيق معاني الكلمة. فقد يحلل المشاعر، وأساليب إثارة هذه المشاعر، ولكن هدفه محدود. وليس هو بالتمرين العقلي المنزه. إن محدودية الهدف تجعل من الأسهل اكتشاف محاسن أو مثالب العمل الفني. وحتى هذا النوع من الكتاب عدده قليل جدا، بحيث أن “نقده ينطوي على أهمية كبرى في حدوده. هذا هو شأن كامبيون، أما درايدن فهو منزه أكثر بكثير: إنه يكشف عن القدر الكثير من العقل الحر. ومع ذلك فحتى درايدن – أو أي ناقد أدبي من القرن السابع عشر – ليس عقلا حرا تماما، بالمقارنة مع عقل روشفوكولد على سبيل المثال. فثمة ميل دائم إلى التشريع أكثر من الميل إلى الاستقصاء، إلى مراجعة القوانين المقبولة، وحتى إعادة البناء من المادة نفسها. وإن للعقل الحر هو ذاك العقل المكرّس للاستقصاء بكليته.
أما كولردج الذي تتسم قدراته للطبيعية وبعض نقوده بأنها تتميز على تلك التي يمتلكها أي نقاد معاصر، فلا يمكن اعتباره عقلا حرا كليا. فطبيعة الكوابح بالنسبة إليه تختلف اختلافا بينا عن تلك التي تسببت في محدودية نقاد القرن السابع عشر.. كما أنه أشد شخصية بكثير. لقد كانت اهتمامات كولردج الميتافيزيقية حقيقية فعلا. وكانت مثلها في ذلك مثل معظم الاهتمامات الميتافيزيقية، مسألة تتصل بعواطفه. بيد أن الناقد الأدبي ينبغي أن تكون لديه عواطف باستثناء تلك التي يثيرها عمل فني مباشرة، وهذه العواطف (كما أنحت من قبل) عندما تكون مشروعة ينبغي ألا تدعى عواطف اطلاقا. أن كولردج قمين بأن يبارح مقدمات ونظريات النقد، وإن يثير الريبة في أنه قد تحول إلى لعبة ميتافيزيقية، لعبة الأرنب البري الذي تطارده كلاب الصيد. فغرضه لا يبدو دائما أنه العودة إلى العمل الفني ومعاملته بإدراك أفضل وأشد حدة. ذلك أن مركز اهتمامه يتغير، ومشاعره غير صافية. إن كولردج أشد “فلسفية” من أرسطو بالمعنى السيء للكملة، فكل ما يقوله أرسطو يضيء الأدب الذي هو السبب الذي يجعله يقوله. أما كولردج فهو لا يفعل ذلك إلا من آن إلى آخر. وهذا مثال آخر على التأثير الضار على العاطفة.
لقد كان أرسطو يمتلك ما يسمى بالعقل العلمي. وهو عقل من الأفضل أن ندعوه بالعقل الذكي، ما دام من النادر أن يوجد لدى العلماء إلا في بعض أجزائه. ذلك أنه ليس ثمة عقل آخر غير ذلك العقل. وما دام الفنانون والكتاب أذكياء ]يمكننا أن نشك فيما إذا كان مستوى الذكاء لدى الكتاب هو في مثل حدة الذكاء لدى العلماء[ فإن ذكاءهم من هذا النوع. لقد كان سانت بوف مختصا بعلم وظائف الأعضاء، ولكن من المحتلم أن عقله، مثله في ذلك مثل العالم الاختصاصي العادي، محدودا في مدى اهتمامه، ولم يكن اهتمامه الرئيسي منصبّا على الفن. فإذا كان بوف ناقدا، فليس ثمة من شك في أنه كان ناقدا ممتازا. ولكننا يمكن أن نستنتج أنه قد اكتسب اسما آخر بالإضافة إلى ذلك. وربما كان ريمي دي غورمو من بين جميع النقاد الحديثين، لديه معظم خصائص الذكاء العامة لدى أرسطو. لقد كان هاويا، بالغ الكفاءة، في علم وظائف الأعضاء، وكان يجمع إلى ذلك درجة متميزة من الحساسية وسعة الاطلاع، والإحساس بالحقيقة والتاريخ، والقدرة على التعميم.
إننا نفترض وجود موهبة الحساسية المتفوقة. وفيما يتصل بالحساسية، لا تعني للقراءة الواسعة والمتعمقة، مجرد زيادة في حجم المرج الذي يرعى فيه، فليس ثمة مجرد زيادة في الفهم والإدراك، تدع الانطباع الأصلي الحاد دون تغيير. فالانطباعات الجديدة تعدل الانطباعات المستمدة من “الأعمال الفنية” المعروفة. إن الانطباع يحتاج إلى إعادة الصقل دائما، بواسطة الانطباعات الجديدة، وذلك من أجل أن يقيض له الاستمرار. إنه يحتاج إلى أن يأخذ مكانه في نظام من الانطباعات، وهذا النظام يجنح إلى أن يصبح متموضعا في بيان عام من الجمال الأدبي.
وعلى سبيل المثال ثمة في الكوميديا الإلهية العديد من السطور المبعثرة، والقصائد الثلاثية، القادرة على أن تنقل حتى القارئ غير المستعد، والذي لديه إلفة كافية مع جذور اللغة، إلى مرحلة استجلاء المعنى، إلى انطباع من الجمال الساحق. وقد يكون هذا الانطباع عميقا إلى حد أن دراسة لاحقة وفهما له سيجعلانه أشد حدة. ولكن الانطباع يكون عند هذا الحد عاطفيا، فالقارئ الجاهل الذي نفترضه غير قادر على التمييز بين الشعر وبين الحالة العاطفية التي أثارها الشعر في نفسه، وهي حالة ربما تكون عبارة عن مجرد انهماك في عواطفه هو، وقد يكون الشعر مجرد محرّض عارض. إن هدف الاستمتاع بالشعر هو التأمل الصافي والمعزول عن جميع حوادث العاطفة الشخصية. وهكذا فنحن نهدف إلى رؤية العمل الفني كما هو، وإلى إيجاد معنى لكلمات أرنولد، ودون عمل، يشغل معظمه العقل، فإننا غير قادرين على الوصل إلى تلك الدرجة من الرؤيا amor inelltectval is Dei.
هذه الاعتبارات، في شكلها العام هذا، قد تبدو معروفة. ولكنني أعتقد أنه من المناسب دائما جذب الانتباه إلى الخرافة المترهلة والقائلة إن التذوق شيء والنقد “العقلي” شيء آخر. التذوق في علم النفس العام تصنيف معين، وفي النقد تصنيف آخر، حذق مجدب ينصب مشانق نظرية حول استبصارات المرء أو استبصارات الآخرين، إن التعميم الصحيح هو على العكس، ليس شيئا مفروضا من أعلى، على مجموعة من الاستبصارات المتراكمة. إن الاستبصارات لدى عقل مبصر حقا، لا تتراكم في كتلة، وإنما تنظم نفسها في بنيان. والنقد هو بيان مكتوب بلغة هذا البنيان. إنه تطور الحساسية. أما النقد الرديء فهو، من جهة أخرى، النقد الذي ليس إلا التعبير عن العاطفة. وإن العاطفيين من الناس – سماسرة البورصة، والسياسيين، ورجال العلم والعديد من الناس الذي يفخرون بكونهم غير عاطفيين- يمقتون أو يحتفون بكتاب عظام من أمثال سبينوزا أو ستندال بسبب “برودتهم”.
لقد ألزم كاتب هذه المقالة نفسه مرة بالفكرة القائلة إن “الناقد الشعري ينقد الشعر لكي يخلق الشعر”. وهو الآن أقرب إلى الاعتقاد بأن من الأفضل دعوة النقاد “التاريخيين” و”الفلسفيين”، مؤرخين، وفلاسفة.
أما بالنسبة إلى البقية، فثمة درجات مختلفة من الذكاء. ومن الحمق القول إن النقد يكتب من أجل “الخلق” أو أن الخلق هو من أجل النقد. كما أن من الحمق أيضا الافتراض بأن ثمة عصورا للنقد وأخرى للخلق، وكأنما انغماسنا في ظلمة العقل، يجعلنا نملك آمالا أفضل في العثور على الضوء الروحي. إن اتجاهي الحساسية يكمل كل منهما الآخر. وبما أن الحساسية نادرة، وغير شائعة، ومرغوب فيها، فإن من المنتظر أن يكون الناقد والفنان المبدع، الشخص نفسه في كثير من الأحيان.

_______________
(*) أوروبا.
1) دراسة في “الدراما الإليزبيتية” بقلم آرث سيمونز.