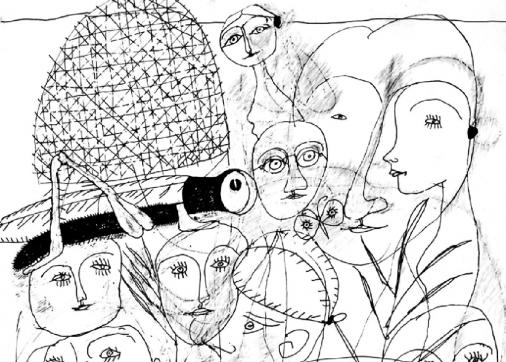الوصول إلى دمشقْ

-1-
المال. المال.
العصب القادر على بعث الصبوات، وأيّام البيادر، تحت ضوء القمر، أو في المضافات. لتعود الأصابعُ ولا همّ لها إلاّ أن تلفّ التبغ، ليأتي اللعاب؛ ذلك اللصاق البشريّ، يغلق الشفاه على ما انطوى عليه السحر من ورقٍ وعبقٍ وأبخرةٍ، يروي ظمأ ملعونا، وشغفا ما أن يرتوي حتى يضطرم.
والتبغ من أين أتى؟ ومتى حَلّت لعنتهُ على البشر؟
فانبرى محمد السليم قائلا:
- مِنْ زمان ما كانت الناس تدخِّن ولا تِعرف التدخين!
وكان قد قَرَأه لتوِّه في جريدة التقطها من الأرض. قال ذلك وهو يبصق عقب سيجارةٍ من فمه، ويسحقه بحذائه الذي خرج به من البلاد. هو الذي كان أبوالدبكات والأعراس ما عاد أحد يراه ضاحكا هذه الأيّام في “دمشق الشام”. وصار للناس مثل الدُقْرة. إن غلط أحدٌ فتحدّث عن قرب الرجعة تراه يعترض حكيه مثل حسكة في الحلق:
- الله يرحمها، ويرحمنا برحمته!
وكانت قراءتُه عن التبغ طازجة، فما أسرع ما تناول من الجيب الداخلي للساكو الذي يرتديه صفحة جريدة طواها أرباعا. ناولها لوالدنا قائلا:
- خُذ. اقرأ.
وإلى لحظتها كان والدنا يعتقد أن الإنسان وُجِدَ فوق أرض البشر ووجدت السجائر معه. وكان قد ذاق صنوفها جميعها، ولشدّة ولعه بها لم ينبذ أيّا منها، أو يمسسه بسوء. حتى “الهيشي” الذي أقحمه بدو النقب بين صنوف التبغ إقحاما، وهو منها براءٌ، جرَّبه، ولم يرَ به بأسا. وما كان يعرف وهو يُشَرِّعُ علبة تبغه الفضّية، وكانت قد أتت معه من فلسطين، فيضيّف منها الرايح والجاي، كما لو كان شيخ عرب، أنّ الأيام المكتوبة ستضعه أمام خيارين أحلاهما مرّ: السجائرُ، أو الأولاد. وكانت والدتنا أعنف مَنْ تصدّوا له في مسألة “التدخين” تلك.
دهرٌ، نُسيت سنواتُه، كان قد انقضى على وجودهما معا. بل من الذي كان يومها يُحِسّ أو يأبَه بتتابع السنين، بل وحتى القرون؟ ولكأنهما كانا وسط بساتين بلدتهما “صفورية” وحواكيرها، تجسيدٌ لوجود الحياة وتواصلها منذ بدءِ الخليقة، بآدمها وحوّائها، بين جنّاتٍ وطوبى، وروحٍ وريحان، ونعيمٍ مقيم. وتكثيرا كَثّر الله أتعاب حملها، وبالوجع وضعت ثلاثة عشر حَمْلا، نصفها للموت، ونصفٌ للحياة. وإلى رَجُلِها كان اشتياقها، فسادَ عليها. وشاركت بنات جنسها لعنة “الدورة الشهرية”، قبل أن تشاركهن أخيرا تليُّف الرحم، إلا أنها وبخلافهن، لم تأخذ سعيد المحمّد من أمه وأبيه. فظلّ والدنا طوال تلك الحقب والآماد: الأب، وربّ العائلة، وهي الأمّ: الأنثى والرحم، وذلك ما رَبَّط رجليها وكسّرها، كما يقولون، فأمضت السنين الطوال في بساتين العائلة، عند “القسطل” و”عيون صفورية”. وما عادت تنزل إلى البلد إلا في الأعياد.
ثم، من أجل أيش تنزل؟ ألكي تمضي يومين أو ثلاثة وسط الكناين، والسَلَفات المتربّصات ببعضهن البعض. أرزاق ربّنا كانت عند الناس، ومع ذلك فهذه أخذت، وهذه زادت، يظلّ صياحهنّ طوال النهار، يسمعه الرجال في المضافة، لا حياء ولا خجل، إلى أن يعود خالنا سليم، من الحقول، فيشلح لهنّ القشاط، وأين الجنب الذي يوجعهنّ، فلم يكنّ يخفن إلا منه، وتراهنّ ساعة وصوله يتقافزن إلى غرفهنّ مثل الفارات:
- يا الله وِلِهْ إنتي وإيّاها. كل واحدة تِنْضَبّ عَ أوضتها.
والوالدة، ويوم كانت تملأ سحاحير الخضرة والفاكهة، تبعث بها من البساتين إلى أهلها، وأهل زوجها فذلك جُود الوالد. قالتها هي: لو كان أبوكم بخيلا مثل يوسف العبدالله لأَكَلَتْ منه قتلات حتى فرّقت إن هي مَدّت يدها إلى حبّة حامض، حتى لو كان مما تساقط على الأرض.
على أن فلسطين زمن. وهنا في دمشق الشام زمن آخر. وذلك الرحم الذي أنجب أوّل مولودٍ في الغربة؛ أنثى عاشت لساعات وماتت، عاد فامتلأ من جديد. وما الحاجة إلى مزيدٍ من الأولاد. بل وإلى مزيدٍ من كلّ شيء. فكان أن اتّفقا. يدخّن هو آخر أوقّة تبغٍ اشتراها، وتأخذ هي شراب “الكينا” لتُسقِطَ حَمْلَها.
وصبيحة ذلك النهار الذي مضيا فيه إلى المستوصف في “سوق صاروجة”، وهو من أوّل إنجازات الأونروا، ذهبا إليه مشيا من “حيّ الميدان”:
- آمنة. آمنة. آمنة. مو هيك اسمك؟ آمنة. وأيه يا آمنة.
- نعم يا سيدي.
- شو قلتي لي بِدِّك؟
- بِدّي إبرة كينا يا سيدي.
- ومِنْ شان شو إبرة الكينا يا آمنة؟
وعندها انبرى الوالد مجيبا:
- مِنْ شان اتسقّط اللّي ببطنها.
وارتسمت ابتسامة متسامحة على وجه الطبيب، تقاسمها مع الممرضات. ثم أضاف يسأل:
- ومِن شان أيش بدكُن اتسقطوا الولد؟
وبخفوتٍ أجابه الوالد:
- في أولاد كتير!
- أيه. طيّب. يا الله اتسطّحي على الطاولة يا آمنة.
وآمنة وقد نزلت على رأسها كلمة “اتسطّحي ” مثل دبشة حجر، أكانت قبل الآن حشرة ممعوسة كالتي كانتها الآن. وأردف الطبيب مخاطبا إحدى الممرضات:
- تعي إعطيها إبرة كينا لآمنة.
- آمنة. آمنة. مو هيك قلتيلي اسمك يا آمنة؟ وهاي إبرة كينا لآمنة.
– يا الله. يا الله. يااللي بعدا. مين اللي بعدا. حقنة وهمٍ لآمنة وللتي بعدها!
-2-
ولكن،

لوحة: نوارا زنتاح
لماذا؟ ولماذا؟ لا يُدخّن، ويُدخّن، ويُدخّن؟ وهل زُرِع تبغُ العالم إلاّ كي نُدخّنه؟ ويوم أن عاد متأبّطا كيس تبغٍ حرزان. بزرة بلديّة، خمّرتها الأنسام النديّة لخريف المتوسط، كانت قدماه قد ساقتاه إلى أسواق دمشق وحاراتها يفتّش عن رزقه المختبئ له في زاوية من زوايا دمشق. البلدة. اللغز. وبدلا من أن يعود بفرصة عمل، عاد بكيس تبغٍ، يكفي لشهرٍ، بل وأزود من شهر!
وفي مغطّى “السروجيّة”، وهو آخر سوقٍ لم يسأل عن عملٍ فيه، وقبل أن يشتري أوقّة التبغ تلك، كانت قد شدته واجهات المحلاّت، وقد تدلّت منها الأردية، والأقبية، والعباءات، والحبال، والأرسنة، والسلاسل، وجُعَب الصيد.
- أيسأل هنا؟
إن أطلّ برأسه داخل المحلّ فذلك يعني أنه زبون. وتفضّل يا سيدي. المحلّ محلّك. وعَلِّق الشاي يا ولد. يا أهلا. ويا سهلا.
وتريّث لبرهة. والبرهة كانت كافية لأن يستجمع ذلك الذي قاله عشرات المرّات:
- عندكُن شُغل؟
وأوّل عن آخر فقد كان سيُخَيّب آمال صاحب المحل الذي ظنّه زبونا. وكان ينقص أن يضيف:
- مِنْ أجل هذا الخمسينيّ الذي وراءه عُرُّ أولاد. ملاّك الأراضي. والشريك السابق في حسبة حيفا: الابن الأزليّ للأرض المقدّسة.
وهنا في سوق السروجيّة وفي الأسواق التي تشبهه لا يدفعون للأُجراء أجرا. فهم يعلِّمونهم الكارات. ثم إنّ الشغل هذه الأيام ما عاد مثل أيام زمان. والسيولة معدومة… وأين… وأين حتى يأتي زبون طيّار من الأرياف أو من قلب الصحراء.
- وماذا؟ صانع سروج؟
مهنة الماضي البهيج. يوم كان البشر يتقاتلون فارسا لفارس، وحصانا لحصان. هو الملاّك. ابن الملاّك. تعزم عليه الغربة قائلة:
- تفضّل. واقعد مع الأولاد. تستطيع أن تداوم من الآن لو أحببت.
هو الرجلُ تزمع الغربةُ أن تعيده صبيّا، ابن كار، فيداوم في الورشة من مطلعها إلى مغيبها. دون أجر. وإن رَغِبَ بذلك فأهلا به. وإذا، فماذا انتظر سعيد المحمّد كي لا يقعد على واحدٍ من البُسُطِ المفروشة في خلفيّة الدكان، ويمضي نهاره وشطرا من مسائه، يهيّئ:
الأرسنة، والسيور، والحبال، وسلاسل الحديد. وينظم سموط الخرز الأزرق؛ التي تزيّن السروج، والبرادع، وأعناق الجياد، لتُبعِدَ شرّ الحاسدين، وما حسدوا، عن: فرسانٍ لم يعد لهم وجودٌ إلا في الحكايات والكُتُب. ومِن الآن لو أحبّ. فما أينع ذلك، كلّهِ مادّة لتفكّهِ مجايليه من أبناء بلدته. فإن تكوّرت المدينة على نفسها مثل قنفذ فأين يذهب أبو فتحي إنْ لم يذهب إلى السجائر؟
وكان يا ما كان. في سالف العصر والأوان. وكانت دمشق بالنسبة لأهلنا بداية جديدة، في اتجاهٍ جديد. في مكانٍ غدوا فيه صُنّاعا وأرباب صنائع. و”عمّروا أملاكا كثيرة، ودواليب، وبساتين”، وعاشوا، وزوّجوا أبناءهم وبناتهم. وبعضهم رأوا الأحفاد والحفيدات، إلى أن أتاهم أخيرا هادم اللذات، ومُفّرّق الجماعات، فأغلقوا عيونهم على أسرارٍ وحكايات، وصاروا بمرور الأيام ترابا دفنّاه في “مقبرة الميدان” و”تُربة الحقلة” و”الأربعين” و”مقبرة اليرموك القديمة”.
وكانوا ساعة أن طَبّوا في دمشق الشام قد ملأوا حاراتها، وأسواقها، وأرباضها وغوطتها، بالطرحات، والقنابيز، والأعقلة، والكوفيات، والأثواب المزركشة. حقولُ حنطةٍ وبرقوق، وبيادر ذرّتها الرياح فوق دمشق: مدينة المطاعم، وبَسطات الخُضرة، وباعة البوظة، والسحلب، والمشاوي، والفلافل، والكروش. مدينة البيع والشراء، وارتفاع التجارات.
وكان ذلك يكون مِنْ حول أهلنا أينما تطلّعوا. وهو ما سمّرهم كالأطفال وسط الساحات والأسواق: في الحميدية، والبزورية، والطويل، وسوق الهال، تائهين، مشدوهين، لا يعرفون الأين، والمتى، والكيف، في قلب ذلك البهاء كلِّه. أين، ومتى، وكيف، يحصل المرء في هذه المدينة الشريفة والنظيفة، على عملٍ شريفٍ ونظيف؟
والأين والمتى والكيف يكونون في العادة مما يَعْسُرُ على ابن البلد، من سابع جدّ، فكيف لو كان ذلك الذي يسأل فلاّحا ابن فلاّح. وأين سيجد الفلاّح؛ ابن الفلاح؛ الذي ما عادَ فلاّحا، فرصة عملٍ في هذه المدينة الطافحة بالخيرات؟ مدينة المدن، وكلّ مَن في مدينة المدن تلك يعملُ مِن مطلَعها إلى مغيبها:
الرجال في دكاكينهم ووظائفهم وورشات عملهم. والنساء وبعد أن ينهين تنظيف البيوت، وإعداد الطعام ينشغلن في فنون التطريز، وأعمال التريكو، وشكّ الخرزِ، وقصّ شراشيب العباءات، ولَفّ الأعقلة، ورتْي الجوارب، وتعبئة صُرَرِ الملبّس، وفي صنع كلّ تلك المُبهجات التي تُزَيِّنُ واجهات المحلات. وأمّا أطفال الشاميّين فيكونون في الأثناء في الورشات المتنوعة، تحت أقبية البنايات، يتعلمون الكارات، يُسَبِّعونها كما يقولون. و”وصنعةٌ في اليد أمانٌ من الفقر”. إما ذلك، وإما تراههم على بسطاتٍ عند زوايا الحارات، وأطراف الساحات، وأمام الجوامع، وعلى طول سوق الحميدية وصولا إلى الجامع الأمويّ، وفي “المسكِيّة” و”سوق الطويل”. و”اتفضّلي يا سِتّ”. يبيعون: أمشاطا، وإبَرا، وأكياس حمّام، وعلكة، وغزلة، وتمرية وكعك. و”حلّي سِنونك يا ولد”؛ وكلّ ذلك الذي لا ينْفَكُّون عنك حتى تشتريه.
وتلك الورشات المبثوثة في كلّ دخروقة من دخاريق دمشق أين هي؟ أين القلب النابض لكلّ ذلك العمران البشري البهيج؟ أين يكمن اللغز؟ وأين يكمن حلُّهُ؟ وأين؟ وأين؟ وهذه المدينة لا تلبث متى انفتحت أن تنغلق على نفسها من جديد.
-3-
وفي لحظات العيش المديد. في العيش الذي يستمرّ، ويستمرُّ، لا يفطن البشر أن لكلّ استمرارية وقتا تتوقف فيه. إنه الزمان. وسيريهم الزمان مُرّ الأيام كما أذاقهم حلوها. وسيغدون من الآن فصاعدا في قلب أيامه وشهوره وساعاته ودقائقه. في الشقاء، كما في الهناء.
ولكن ماذا سيشتغلون في هذه المدينة؟
أيّ شيء. أيّ شيء. يمكن للبشر عند الحاجة أن يشتغلوا أيّ شيء. والشغل ليس عيبا. والمطلوب أن تستمرّ الحياة. والحياة تعدّ بالأحلى.
وذلك ما أبقاهم وأبقى أسلافهم من قبلهم. وموضعهم الجديد في هذه الحقبة المريرة من تتابُع الأزمنة كان هنا في دمشق الشام. وكانت مسامّ دمشق وهي تجاهد لتقف على قدميها، بعد استعمارٍ فرنسيّ دام عقدين ثقيلين من الزمن، وهزيمةٍ مُذِلّة أمام الإسرائيليين في حرب عام 1948، وانقلابين عسكريين وهذا الثالث بزعامة الشيشكلي قبل أيام، كانت لا تزال مغلقة.
على أنّها، وبعد أن تطمئنّ، وتعود مياه كلّ شيءٍ إلى مجاريها فستمتصّهم كما امتصّت غيرهم من قبلهم:
عجينةٌ مِنْ رومٍ وفُرسٍ، ونِبطٍ وعربٍ، وأتراك وسلاجقة، وأكراد وفرنجة، وبربر وأقباط، وأرمن وشراكس، وألبان ويونايين، وينضاف إليهم الآن مئات الألوف من الفلسطينيين. أممٌ وشعوبٌ شتّى حوّلتهم دمشق، رغم أنف أروماتهم إلى دمشقيين- شاميين.
وكمثل كلّ البارعين أخذت دمشق وأعطت: أخذت الأدب، والبياض والشعر الأشقر، والعيون الملوّنة، وحذَر الملدوغين، ودَأبَ المجدّين. وأعطت: لغة، ودينا، وعاداتٍ شامية، وانتماء فضفاضا إلى مجد العرب الغابر. أعتقُ المدن المأهولة فوق ظهر هذا الكوكب كانت دوما ودوما، نزوة وممرّا للطامحين والمغامرين، وقلعة وأسوارا، وأزقة متشابكة للهاربين المذعورين. وهي لن تبخل على الفلسطينيين بفرص عمل، إن كان المطلوب مجرّد عمل. ولن تبخل عليهم ببيوت، إن كان المطلوب مجرد بيوت. دمشق التي لم تُشاهَدَ يوما إلا وهي تنهض من ركامها، كما العنقاء، كانت بحاجةٍ إليهم. تحتاجهم:
معاملُ الصابون، والجرابات، والنشاء، والطحينة، والبلاط، والأفران، وورشات الخياطة والتريكو، والمدارس والجامعات. تحتاجهم: البزورية، والحريقة، والحميدية، والسنجقدار، وبوابة الصالحية، وباب توما. تحتاجهم: الأشغال التي يتقنها كلّ أحد، والصناعات الدقيقة، والعجيبة التي لا يتقنها سوى القلّة. دمشق الدقيقة، والعجيبة كانت بحاجةٍ إليهم كلّهم. كانت بحاجةٍ إلى: الوالد، والعم رشيد، والعم سليمان، وأبوغالب، وأبوفؤاد، وأبوسميح، و. والقائمة إن واصلناها تطول.
كانت بحاجة إلى استيقاظهم المبكّر وشِّ الصُبُحْ، وبعد أن يكونوا قد صلّوا صلاة الفجر في جامع الدقّاق. وقبل شقوق الضّوء يكونون قد خرجوا من بيوتهم التي أُسْكنوا فيها، أو تلك التي استأجروها، وفي أيديهم، كما في أيدي رجالات أهلِ الشام: السفرطاسات، وزُوّادات الأكل، مما تكون الأمهات قد خبّأنه عن عيون وأيدي أطفالهن.
فما مضت أشهر إلا وصرت تراهم يغذّون السير. يزاحمون الماشين، أو الراكبين على الكارّوهات، والباصات والترامواي، صوب أشغالهم التي باتت تنتظرهم، كما لو أنهم أبناء الشام من سابع جدّ. كانت الورشات بانتظارهم. بانتظار عمّالها الجدد. وتتوقف إن هم لم يأتوا أو لو لم يكونوا هناك. فأين؟ أين كانت تختفي كل تلك الورشات التي توسّعت فلمّتهم، ومنحتهم فرصة العمل الشريف والنظيف. في المدينة الشريفة والنظيفة؟
-4-

لوحة: نوارا زنتاح
وتراكُمُ الهموم، والتفكيرُ بيومه، وبغَدِهِ، كان قد أنساه إيمانَه العتيد من أنه ما مِنْ شدّة إلاّ وبعدها فرج. وهو الأمر الذي سرعان ما قالته له الأيام. فهكذا، وبدلا من أن يواصل سعيد المحمّد اقتفاء عجلات الترامواي من “بوابة الله” إلى “مُصلّى العيدين” و”السويقة” و”باب الجابية” و”الحميدية” كالأطفال المسحورين، قرّر أن يتّخذ لتحرّكه مسارا جديدا. فالسير على الدروب ذاتها لا يؤدِّي إلى أيّ نتيجة. وذلك الذي أخَذَهُ الرحالة الأندلسي ابن جبير على أهل الشام: “صغيرهم وكبيرهم، بجميع هذه الجهات كلّها، مِنْ أنّهم يمشون، وأيديهم خَلفهم، قابضين بالواحدة على الأخرى.. قد اتّخذوا هذه المشيةَ بينهم سَنَنا” كان لا يزال هو. هو. تغيّر أهلُ دمشق مرارا وتكرارا، ولم تتغيّر عاداتها. كأنما الأمكنة هي ما يصنع البشر، لا العكس.
ولأن ذلك هو ما كان، وما اعتاده الوالد جريا على عادة أهل الشام، فقد سار، بعد يومٍ على غزوته في “سوق السروجية، ومعه أبوعدنان صاحب تنّور “ساحة عصفور”، بعد أن أدّيا صلاة الفجر في “جامع الدقّاق”، سارا وأيديهما خلف ظهريهما، يكرران سُنن الماضي الذي حكى عنه ابن جبير.
وكان والدنا قد صار في بداية أمره زبونا من زبائن تنور أبوعدنان. ثم ريّثته الأحاديث أمام بسطة بَيْعِ الخبز أمام باب التنّور. ثم على كرسيّ أمام بيت النار. وأبو عدنان يسأله وهو يجيب.
وفي مبتدئها دارت الأحاديث عن الخبز، في فلسطين. أيام زمان. وعن الطابون، وهو: “…تنُور في الأرض صغير، قد فُرِشَ بالحصى، فيوقدُ الزبل حوله وفوقه، فإذا احمرّ طُرِحَت الأرغفة على الحصى” (أحسن التقاسيم للمقدسي)، وعن الخبز الذي يخرج من الطابون، وأيّ مذاق يتحصّل للآكل لو صُنِعَ منه المُحَمّر بالدجاج، والأطيبُ لو صنعناه بالزغاليل. وكيف أن خبز حيفا يشبه خبز الشام، فكلاهما من مدن الشام، وخبز الشام واحدٌ.
ثم تشعّبت الأحاديث، فحَكَت عن البساتين والبيّارات وحسبة حيفا. وعن كلّ ما يُقضى منه العَجَبُ، ويبعثُ الحسرات في النفوس. وكانت أسئلة أبو عدنان تأتي خجولة، غير مصدقةٍ ذلك الذي تسمعه أُذناه:
- أكانت عندكم كلّ تلك الأرزاق في فلسطين؟
- نعم.
- وتركتموها وراءكم؟
- نعم.
- لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟
وذلك سؤال لا يعرف المذعورون والفارّون بأرواحهم إجابة عنه. فتراهم يوجّهونه إلى أنفسهم قبل أن يوجّهه لهم الآخرون. يسألونه لأنفسهم مع إشراقة كل صباح، وعند غروب كلّ شمس. وأبوعدنان خَدَعَهُ قمبازُ الوالد وكوفيّته، فاعتقد أنها المرّة الأولى التي يرى فيها والدُنا في حياته مدنا كبرى مثل دمشق الشام، وظنّ أنه ابن بساتين. ووالدُنا، وتأكيدا منه بأنه زار دمشق مرارا قبل اللجأة، راح يحكي لأبي عدنان كيف كانوا يأخذون في بادئ أمرهم:
الجِمالَ، والبِغالَ، والحميرَ، قبل أن تُخترَعَ الحناطيرُ والديليجانس والسيّارات. وأما إن أردنا أن نذهب من دمشق إلى حيفا بالقطار فإنّ قيامَه يكون في الثالثة صباحا. وخطُّ سيرِه كما يلي:
من محطة الحجاز إلى القدم فالكسوة ودير علي والمسميّة وجباب وخبب ومحجّة وإزرع وغزالة ودرعا؛ محطّتُه الرئسيّة. يذهب منها إلى عمّان ثم يعود ثانية إلى درعا ومنها إلى المزيريب فزيزون فالشجرة ووادي خالد والحمّة وسمخ وجسر المجامع وبيسان وشطّة وعين حارود والعفّولة وتلّ الشمّام إلى أن يصل إلى حيفا؛ محطّته الأخيرة.
فإن كان المسافر ممّن ينزلون في أوتيل فكتوريا الشام، فبإمكانه أن ينزل في أوتيل فكتوريا حيفا- فلسطين، قرب المحطّة على البحر، تليفون 108، صندوق بريد 246، راحة وإتقان ونظافة.
وإن ساقت المقاديرُ أحد المسافرين، ومرّ في حيفا، وأراد أن ينسى السفر، ويأخذ قسطا من الراحة استعدادا لمتابعته، فما عليه إلاّ أن يقصد فندق ماجستيك، حيث يكون محاطا بالخدمة اللازمة، والنظافة التامّة، فضلا عن المناظر البديعة، وكل ما ينسيه متاعبه.
أما إن لم يرغب في هذا الفندق ولا ذاك، فيمكنه أن ينزل في أوتيل نصّار، المعتبر عند شركة كوك من الطبقة الأولى، وقد أصبح محطّ أكابر القوم، والطبقة الراقية من وطنيين وأجانب: أثاثُهُ جديد وفاخر، غُرَفُهُ وسيعةٌ، طعامُه شهيٌّ، خدماتُه متقنةٌ، ويلاقيك معتمدُهُ في محطّات السكك الحديدية وعلى ظهر البواخر. العنوان التلغرافي: جراند أوتيل. مديره أنيس نصّار. صندوق البريد 61. تليفون: 54. (من نشرة سياحية عن فلسطين أوائل القرن العشرين).
فنادق، وحانات. سينمات، ومغنّون، شعراء وفقهاء، متصوّفة وأولياء. أنبياء حقيقيون، وآخرون دجّالون. وتماما كما في الشام: أحزاب موالاة، وأحزاب معارضة. وبطولات وانكسارات. وأفراح وأحزان. وكلّ ذلك كان اللحمة والسدى لأحاديث وأحاديث.
وما أحلى الأحاديث، وما أجمل الحكايات، وما أسخاها! فهي التي أرست الثقة بين الرجلين. ومع الثقة خُلِقَتْ فرصة العمل. واتّفق بالأمر المقدور يوم أن سارا، وأيديهما خلف ظهريهما، على سُنن أهل الشام، وغريب عاداتهم، وفيما الحكايات تُحكى والروايات تُروى، أنْ بَطَّلَ بُشْكار الفرن (مُرقّق العجين) من العمل. اختطفه تنّور “الزاورلي”.
ولحظتها قال أبو عدنان وهو شيخ كارٍ بين خبّازي حيّ الميدان:
- لَكْ تستلم هالبسطة عنّي لك أبوفتحي، لأرجع بُشكار؟
وظنّه الوالد، وكان لحظتها في أوجِ يأسِهِ من إمكان العثور على عملٍ، “أيّ عملٍ، في دمشق الشام” يسأل رجلا آخر. غير أن أبوعدنان لم يكن يسألُ غيرَه. يسألُ اللاجئَ اليائسَ إِنْ كان يرغب في عمل!
- أنا..؟
- ولَك أي إنت. تستلم البسطة عَنّي لأرجع بُشكار؟
وأعاد أبوعدنان سؤاله بجفاف شديد. وكانت نبرته جادّة ومتوتّرة وموجّهة بشكل غير مباشر إلى البشكار أبوتيسير، الذي كان يغيّر ملابسه، ويَضُبّ أغراضه، معلنا دون سابق إنذار أنه بطّل من الشغل.
ما كان في الأشهر الماضية ضربا من المحال أتى فجأة. بتلك البساطة. والفجاجة. بما فيهما من نَبْرٍ مؤلمٍ. كان الطلب الذي تقدّم به أبوعدنان من والدنا دعوة وترجّيا، مخلوطين بوجع أبدي لأرباب العمل من الأُجَراءِ، الذين ما أن يعلّمهم الواحدُ الكارَ حتى تروح عيونهم تحوص صوب ورشاتٍ أخرى.
وها قد جرّت الأحاديث والحكايات أمام البسطة، والعجّانة، والقِنّب، وبيت النار، خبزا وزيتا مما وُعِدَ به أهلُ الشام وساكنوه. ولم يتبق بعد ذلك سوى البيت. وكان الوالد أراده من بابه. تعبُ الجسد تقطفُ ثمارَه الروحُ المتعبة، فتطلب الغرض الأقصى فالأقصى. وإن كان قد أراد فلم لا يريد الأحسن؟
ورسمَ لموقع البيت الذي أراده دائرة كان مركزُها جامعَ الدقّاق، ثم استدارت لتشمل: القاعة، والحقلة، ومصطبة سعدالدين والجزماتيّة، والثريّا، وأبوحبل، لتعود إلى البوابة من جديد.
وكان قد تَعِبَ. بِكْرُ عائلة محمّد الإبراهيم أعياه أمر أخيه رشيد الذي بات يجاهر في الأسابيع الأخيرة بأنه سيتزوّج نجمة عبد الغني. هكذا سمّاها. باسمها الأصليّ. فما ظلّ أحد في حيّ الميدان لا من الفلسطينيين ولا من الشوام إلّا وبات يعرف الاسم الحقيقيّ لامرأة عمّنا. أي عار فعله عمُّنا؟ أهكذا؟ إن أراد الرجل أن يتخلّص من زوجته تصبح فجأة فاعلة تاركة؟ ماذا فعلت نجمة كي تترك؟
وكان صعبا على واحدٍ مثل والدنا أن يرى أخاه يوشك أن يوقع كارثة كبرى، فوق رأس العائلة فلا يحرّك ساكنا. كانت الغربة قد وحّدتهما لشهورٍ مضت. وحّدَهُما البحث عن مأوى وفرصة عملٍ في “شام شريف”، وأزفَ الوقت أخيرا كي يفترقا!
وأدرك شهر زادَ الصباحُ، فسكتت عن الكلام المُباح!