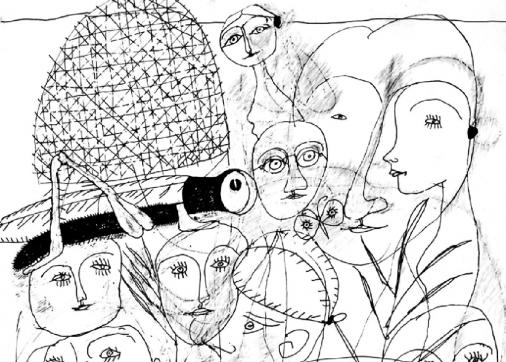تدمير الحكاية

احتوى العدد الماضي من مجلة “الجديد” (العدد 33 أكتوبر 2017) على ملف القصة القصيرة في المغرب العربيّ، ويأتي هذا الملف استكمالاً لملفات سابقة عن جنس القصة القصيرة في العراق ومصر واليمن. وبقدر ما تعكس هذه الملفات المتتالية عن القصة القصيرة الاهتمام بجنس أدبي رصين وسط موجة هجوم حاد من قبل البعض سواء بالترويج لانقراضه أو بهروب الكثير من كُتَّابه إلى جنس الرواية من ناحية، وبمقارنتها بالرواية من ناحية أخرى، وهو ما كان بمثابة ظُلم آخر للقصة لحساب الرواية، فإنها في الوقت ذاته كشفت عن تنوّع في الأساليب وممارسات تجريبية تشير إلى مواكبته للتطوير والتجديد، كما أنها كشفتْ عن أسماء جديدة استطاعت بثبات أن تثري المشهد بإبداعات متنوِّعة.
قبل الدخول في العوالم الجديدة والآفاق الرحبة التي رصدتها القصص، يجب أن نشير بقليل من الإيجاز إلى أن القصة في بلاد المغرب العربي نحت نفس المسار الذي بدأت عليه القصة في بلاد المشرق العربي (وإن كانت بدأت متأخرة عليها) خاصة في مرحلة النشأة والتكوين،(راجع هشام حرك: القصة القصيرة الواقعية في المغرب: الرواد المؤسسون). فقد بدأت القصة بالتزامن مع بداية الحركة الوطنية التي قاومت الاستعمار وبروز بوادر النهضة التعليمية والتثقيفية والأدبية، ومن ثم غلب على النتاجات الأولى الطابع الاجتماعي من خلال سعيها لشرح الظواهر الاجتماعية لتقويم السلوكيات الشائعة آنذاك، لتظهر بعد ذلك القصة التاريخيّة التي كانت تتحدث عن النضال العربي ضدّ الاستعمار.
كما انشغلت هذه القصة أيضًا بالتجريب وابتكار أدوات وتقنيات جديدة تتجاوز بها مرحلة البدايات التي كانت تتمثل في أحد اتجاهاتها الشكل القصصي في التراث العربي كما هو في الأمثال والحكايات والأخبار والمقامات. وفي الثاني كانت متأثرةً بالنتاجات الغربية بفعل حركة الترجمة التي كان لها أثرها في تخليص الكتابة من سجع المقامات ولغة النوادر، فاهتمت بالشكل على نحو كبير، وأيضًا بالاعتماد على الغرائب والعجائب، حيث اعتمد الكُتَّاب في كتاباتهم على الحُلم والتخييل واللغة الشعرية واللعب بالكلمات، ليصبح لها أسلوب فني وشكلي مختلف جذب النخبة وأبعد عنها القارئ العادي، على نحو ما يشير عبداللطيف الزكري في مقالته عن “جمالية القصة القصيرة المغربية الحديثة والمعاصرة”.
وهذا التجريب لم يتأتَ مصادفة وإنما هو نِتاج ما شهده الواقع العربي على مدار تاريخه، خاصة فترة ما بعد الاستقلال من تحولات سياسية واجتماعية وعسكرية، كان لها تأثيرها القوي على فقدان الذات بعد انهيار المشاريع الكبرى. وكان من نتيجة ذلك “الانقلاب الكامل إلى الذات وعليها، في بحث عن منطق بديل، لا يركن إلى يقين، ولا يستقر في نسق ثابت” على حدّ تعبير خيري دومة في كتابه “تداخل الأنواع في القصة القصيرة”.
بنيات ما بعد حداثية
ثمة حقيقة يُدركها المنشغلون بفن القصة القصيرة على وجه التحديد مفادها، أن الكثير من الظواهر الفنية التي اتسمت بها القصة الستينية لا تنتمي إلى الحداثة بقدر ما تنتمي إلى “مابعد الحداثة” (postmodemty)، (راجع د. عبدالنور إدريس، القصة المغربية من النشأة إلى التفرد حتى بصمة المؤنث). وعلى الرغم من أن استراتيجيات مابعد الحداثة غير مستقرة تمامًا حتى يومنا هذا، فإن العودة إلى الماضي وإلى التاريخ، والتقطيع السردي، والتغريب، والعجائبي والسحري، وتأمل النص لذاته وإقحام الهامش، وتداخل الأجناس الأدبية والفنية والاحتفال بالعلمي والمعرفي والمعرفة الملغزة، وانفتاح النص على كل ذلك من جهة، وعلى القراءة من جهة أخرى، كلها ظواهر فنية تلتقي مع استراتيجيات مابعد الحداثة، وهي بارزة بشكل أو بآخر سواء على مستوى الثيمات أو الأشكال في قصص الملف.
غابت في كثير من القصص العقدة التي كانت أحد أهم عناصر القصة في الماضي. وصارت بنية الحكاية متشظية، ولا تُقْرأ القصة بعيدة عن هذه السياقات الجديدة
لم تعد القصة، كما يتبدى من قصص هذا الملف، تنشغل بمفهوم التسلية أو الفلسفة القائمة على وعظ وتبني قِيم أخلاقية على نحو ما كان سائدًا من قبل، بل تجاوزتها إلى التجريب واللعب باللغة والمجاز إلى أقصى حدّ. ومن ثم فالتجريب الذي سَعى إليه الكُتّاب في صوغ حكاياتهم لا يكمن في كسر مفهوم القصة الكلاسيكي كما هو عند محمد يوسف نجم، أو حتى تخطّي مسألة الكم التي كانت مثار اختلافات كثيرة وانتهى الحال بها إلى قصة قصيرة جدًّا، وإنما التجريب تمثّل في تبني جماليات تنبعُ مِن حملها لطرائق تعبيرية وسردية مغايرة، قد تتآخم على حدودها وتتداخل أجناس كثيرة، فيحضر التاريخ لا بوصفه بينة زمانية وإنما كحدث يعضد من الحدث الجديد على نحو ما سنرى في قصة “اللحن”. وهو ما يُمثِّل نقلة حضارية نوعية انتقلت بها القصة من كتابة الذات إلى كتابة الوعي الثقافي. فاختلفت القصة في أشكالها عن تلك التي كانت بارزة في كتابات الأجيال التي ربطت بين مضامين قصصها والأيديولوجيات التي يتبنونها عبر أشكال قصصية كانت تميل إلى تحيزات أيديولوجية. ومن ثم غابت القداسة التي كانت بارزة في القصص؛ حيث التعبير عن قيم أخلاقية والدفاع عنها، بإظهار انحدار البطل أو البطلة بسبب تدنيسه لهذه القيم، وإن كان في الأصل لم يعد ثمة بطل يُصارع ويناضل من أجل الحياة، أو يقاوم القوى الشريرة، بل صار التوجه إلى الذات وما اعتراها من تفسخ هو الملمح البارز.
كما صار الشعار الأهم لا قداسة في الكتابة وأيضًا لا قيم يخضعون لسلطتها اللهم إلا قيمة الكتابة ذاتها التي تسعى إلى التحرّر من كافة الأنظمة البطريركية. فالُكتَّاب لديهم الوعي الكافي على مستوى التقنية وكذلك على مستوى اللغة بالإحلالات التي أحلّتها موجة الحداثة ومابعد الحداثة على الكتابة.
ومن ثم غابت في كثير من القصص العقدة التي كانت أحد أهم عناصر القصة في الماضي. وصارت بنية الحكاية متشظية، ولا تُقْرأ القصة بعيدة عن هذه السياقات الجديدة، وإلا أُصيبت القصة بالتغريب واللامعنى.
كما أن نبرة الرومانسية التي كانت غالبة في قصص البنات اختفت وحلّت محلها الذات التي لا تسعى لإظهار أنوثتها بقدر ما أصبحت تسعى لإثبات وجودها وتحقّقها، فصار حضور الجسد الأنثوي طاغيًا، وهو لا يتأتّى كمعطى حِسيّ يُثير الغرائز ويُحرِّك الرغبات، وإنما يتأتّى كحضور طبيعي مُندمج في الذات الأنثوية التي تسعى للاستقلال ولا تخشى ذاتها كأنثى بل تدافع بهذه المعطيات عن أنثوتها، كما في قصة “سرقات صغيرة” لفاطمة الزهراء الرغيوي. فما تسرقه يحقّق لها أنوثتها المجهضة وسط ذكورية أب فجّة، وأدَ طفولتها بصيحاته “أنت كبيرة الآن. لن تحتاجي لعبا لأنك كبرت” فنَمَتْ بين رجلين في الفراغ، فتحوّل جسدها إلى كابوس فتعلن “إنني خائفة من كل شيء. أمشي بجسدي الغريب. لم أتقبّله بعد، هذا الجسد الذي يمتدّ في كل الاتجاهات. لديّ الآن كرتان في الصدر، وعشب ينمو تحت إبطي وما بين ساقي. ولديّ هذا الخوف الذي يتغلغل عميقًا بداخلي…”، لكن ما يلبث أن يتبدّل هذا الخوف إلى عشق لهذا الجسد فتسرق الجوارب الشّفافة بكل أنواعها بل وتتماهى معه فتخبرنا أنها “تعودت على تلك الامتدادات التي التصقت بجسدي حتى كأنها صارت جزءًا منه”.
بل في قصة أخرى ثمّة افتخار بهذه العلامات، فنراها كاستهلال تبدأ به القاصة فريدة العاطفي قصتها “لم أعد طفلة” “كانت قطرة دم ساخنة… ومجهولة، نزلت بين فخذيّ بشكل مفاجئ، وأنا في الحادية عشرة من عمري. حين زارتني الدورة الشهرية لأول مرة”. فالسّاردة تصف لنا هذه المتغيرات التي أخرجتها من طور الطّفولة إلى طور الأنوثة والمراهقة دون خجل أو خوف من خرق المألوف فتواصل “أطلت شعيرات صغيرة كالنباتات تحت إبطي. وبدأت تكبر يومًا بعد آخر، دون أن أعرف إلى أين يمكن أن تصل”.
احتفاء المرأة بجسدها وتغنيها بتلك التغيّرات الفيزيولوجية التي تنقلها من طور إلى طور، وقد وصل الحال ببطلة “لم أعد طفلة” بعد تخطّيها حاجز الذكورية الذي كان يسبب لها إكراهًا وخوفًا بل وكرهًا لهذا الجسد لأن تقول بنبرة اعتزاز “أصبحت أزهو بنهدي، وأتعايش بألفة مع الشعيرات التي تنمو هنا وهناك على جسدي. أنزعها بحنان وبآلات وردية دائما. وفي فترات دورة الخصوبة أجدني أحيانا أضع يدي بين فخذي، أتأمّل اللون الأحمر القاني على إصبعي. وأحلم بالنرويج”؛ هو نتاج حركات النسوية التي كان تأثيرها واضحًا على الكاتبات، فصار الجسد محتفًى به بعدما كان خطيئة تستوجب المغفرة، وهذا التحوّل سبقه تحوّل أيضًا في المشاعر فنظرة المرأة للحب لم تعد تلك النظرة المثالية الرومانسية التي بدت عليها أجيال سابقة وإنما كما جاء في قصة “أحلام مؤجلة” لفدوى البشيري” الحبّ نسج خيال، وترّهات شعراء، وحكايات أفلام تبدأ بالعشق والمناجاة لتنتهي بمآسٍ تكون ضحيتها تلك الفتاة البريئة التي أعطت كل شيء للرجل، ولم تأخذ منه إلا العار والفضيحة. “فصار الشاغل الأساسي هو مُعالجة قضايا المرأة وحقوقها، لا الوقوف عند التفرقة على أساس الجندر: رجل/امرأة.
القصص كانت قادرة على استيعاب العديد من الإشكاليات التي تُعانيها هذه البقع الجغرافية، فمع أننا وفق السياق التاريخي اقتربنا من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وغياب الاستعمار المعوِّق عن التنمية والإنتاج، إلا أننا نلمح الهمّ ذاته والإشكاليات ذاتها التي كان يُعاني منهما إنسان القرن العشرين
العشق والدكتاتورية
في الحقيقة نحن أمام شريحة من كُتَّاب يعيشون في سياق ثقافي وسياسي وتاريخي واحد وإن اختلف بدرجات متفاوتة، إلا أنهم يعيشون ذات المأساة؛ فالإرهاب الأسود ينشب أظافره في كثير من البلدان، وغياب الحريات التي هي بمثابة الكابوس الجاثم والخانق للجميع، بل صارت الحرية ترفًا لا حقًّا أصيلا يجود به الحاكم لمن يشاء ومتى يشاء؟! وهو ما أوغل يد الدكتاتورية في البلاد، فصارت مصائر الكثيرين مُعلَّقة بكلمة أو مِنَّة مِن أُولي الأمر.
ومع تنوّع القصص على مستوى الجغرافيا وأيضًا على مستوى الأجيال إلا أن القصص كانت قادرة على استيعاب العديد من الإشكاليات التي تُعانيها هذه البقع الجغرافية، فمع أننا وفق السياق التاريخي اقتربنا من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وغياب الاستعمار المعوِّق عن التنمية والإنتاج، إلا أننا نلمح الهمّ ذاته والإشكاليات ذاتها التي كان يُعاني منهما إنسان القرن العشرين، فمازالت الحكومات المستبدة هي المهيمنة وإن تبدّل الاستعمار إلى حكومات وطنية خرجت الشعوب ضدّها في ثورات وانتفاضات.
وبالمثل، فمازالت التنمية غائبة عن كثير من البلاد؛ فالقرى نائية تعيش في عصور حجرية على حد وصف إبراهيم أبورية في قصته “الصعود إلى الهاوية”، بل زاد وأن سيطرت الجماعات الإرهابية وظلت هي الأخرى بمثابة سلطة أقوى من سلطة الدولة، تُسخِّر مَن تشاء وتفرض قانونها على الجميع بلا استثناء. والأهم أن في صراع الدولة مع هذه الجماعات المسلحة تخلت عن دورها التنموي والتنويري الذي كانت بواكيرهما مع إرهاصات النهضة. ومع الأسف نتج عن هذا وعي مستلب لقوى غيبية سواء كانت دينية أو أسطورية، وأصيب العقل بتصلب بنيته في ارتداد عن مسيرة التقدم التي بدأتها هذه الشعوب مع بدايات القرن العشرين.
تميل القصص في مجملها إلى التنوّع في موضوعاتها وكذلك في أشكالها، فكثير منها يأخذ منحى واقعيًا، وقليل منها ذات منحى فانتازي، وفي القصص ذات المنحى الواقعي في بعض منها تمثيلات كنائية ورمزية جميعها تبرز هوس الدكتاتورية وتسلطها كما هو ظاهر في قصص إبراهيم أبورية “جولة في البرية” وحميد ركاطة “على حافة الجحيم“. فقصة “جولة في البرية” أشبه بالأمثولة في استعارتها للشعب بالقطيع الذي ينتظر البطل كي يفيق من سباته. وبهشة واحدة منه يعود النظام إلى القطيع، في رمزية لسياسة العصا التي تحكم وتهيمن، الأغرب أن المعارضة تأتي وكأنها أشبه بأسود ارتضت أن تتكيف مع العشب تأكله بدلاً من اللحم. وفي قصة “على حافة الجحيم” لا يُفارق التمثيل الكنائي النص. فالمجاز صار طوق النجاة للكُتَّاب مِن بطش الدكتاتورية. الرَّاوي يُقدِّم صورة للدكتاتور وما يفرضه على شعبه من قهرٍ وإذلالٍ، والجميع جاثمون تحت قدميه وأجساد النِّسَاء مُباحة له.
الغريب أن المؤلف يرسم صورة ساخرة منه عبر ملابسه العسكرية الفضفاضة وأيضًا بحذائه الأسود الأكبر من مقاسه، وفي مقابل الصورة الأولى الحانقة كانت الصورة الثانية السّاخرة من هذا الزعيم الذي يتوافد الكتاب والشعراء لمدحه في عيد النصر مقابل عطاياه، وهي سخرية مريرة من واقع المثقفين الذين صاروا يقفون في طوابير المنح والعطايا، لا في جبهة المعارضة، في خرق سافر لمفهوم المثقف عند غرامشي. لكن ومع كل ما لديه من قوة يأتي اغتياله برصاصة قنّاص مجهول في يوم الاحتفال بالنصر، لينتهي المشهد بين حالتيْن حالة القوة والاستعراض وحالة السقوط بكل ما تكشفها من كراهية له.
لغة غنائية
ثمة غنائية واضحة خاصة في قصص الحب على نحو قصة “عدوى الحب” لفاتحة مرشيد، وإن كان الحب هنا يولد في غير السياقات المألوفة كما سنراه عند يوسف بوذن في قصة “طيّارة الريح” حيث الحب في الطبيعة وبين الأزهار والعصافير، أما هنا فيولد “في الظروف والأماكن الأكثر غرابة، كالجنائز مثلا” على حد قول الساردة، وقد يخلق العاشقان مكانهما الخاص على نحو ما فعل عاشقا قصة “اليوم السابع″ لعيسى بن محمود “فتقافزا كضباء شاردة في الوادي الصخري غجري وبدوية“، وحالة العشق جعلتهما يعيدان الوجود وفقًا لحالتهما فالأيام صار لها مُسمّى جديد، حتى الطبيعة البشرية تتحوّل إلى طبيعة ملائكية؛ آدم وحواء. تأتي قصة “طيّارة الريح” أشبه ببكائية حزينة لعاشق وَفِيّ لمحبوبته. وكأنّها إعادة لقصص العشق العُذري في براءتها، وفي نهاياته المفجعة أيضًا، عبر لغة تعتمد على الحواس والتشبيهات لنقل الأحاسيس المختلفة بين العاشقين. وإن كانت صورة المعشوقة تأتي دومًا وعلى لسان العاشق. حالة الولَه والجنون لا نراها في قصة “أحلام مؤجّلة” لفدوى البشيري، بل سُرعان ما تفيق الحبيبة من غشاوة الحب، وتعود إلى وعيها، أي أن الأمر لم ينتهِ بها لأن تكون ضحية، خاصة أن العاشق متزوج ولديه عائله. فالمرأة صارت أكثر تحكمًا بمشاعرها، وهي صفة من صفات المجتمع الاستهلاكي الذي نعيش فيه، فتأثيره واضح على الجميع، فالسائق في قصة “الصعود إلى الهاوية” لم ينتظر البطل فما أن وجد حمولة يعود بها، أخذها وعاد. الشيء نفسه يتكرّر في قصة “مغلق أو خارج نطاق التغطية” فصاحب كابينة الهاتف، بعد أن انتهى البطل المشوّش الفكر من اتصاله، وبينما هو يمشي “تفاجأ بصاحب الغرف الهاتفية يقول له “يا سي محمد… هل نسيت؟ أين ثمن المكالمة؟”.

لوحة: جبران هداية
أبطال مأزومون وهاربون
السِّمَةُ الغالبة لشخصيات كثير من القصص، أنّها دومًا شخصيات مأزومة تشعر بالإحباط واليأس ينتابها القلق والحيرة ويغلب عليها الشعور بالوحدة. وأزمتها في أصلها ترجع لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية، لذا تتردد نماذج البطل المهزوم أو اللابطل مع غياب اسم الشخصية، في تجهيل متعمد للذات، وإن كان ثمة حضور طاغٍ للراوي الراصد لحركة الشخصيات، سواء بالأنا أو بالضمير الثالث. تطرد حالة التوهان والهيام دون هدف حتى تغدو هي السّمة الغالبة للأبطال. فيبدو البطل أشبه بالمتخبط مشوش التفكير والرؤية، فنراه تائهًا يمشي في أماكن غير مأهولة كالغابات أو أودية صخرية أو يمشي في منحدرات ويصعد تلالا وجبالا. وإن مشى في القرية، فالقرية “يأكلها الهجير وشوارعها خالية من المارة” كما رأى بطل قصة “مغلق أو خارج نطاق التغطية” للخير شوار. أما المدينة فلا تشعر به “فالشارع مملوء بالمارة وأصوات الباعة تتعالى”، بل يشعر وكأن المدينة “لم تكترث به وبسنوات عمره” التي كرّت مسرعة، فشقّ الشيب مفرقه. حتى وإن “كانت المدينة بلهاء” على حدّ قول بطل قصة “فاكهة الممشى” لمحمد الشايب وقد تبدو المدينة وكأنها “رابضة في العياء والاجترار” كما في قصة “تهاويم ليلة باردة” لزهرة زيراوي. أو يقع فريسة للكوابيس والأحلام المفزعة، وحالات انقسام الذات التي بدت عليها الشخصية كما في قصة “الحذاء الأسود”، وأيضًا بطل “فاكهة الممشى” فالبطل في النهاية ترك المدينة بكل صخبها وتوغل هو والشيخ الذي جاء مِن حيث لا يعلم “في حقول القمح والشعير، وبين أشجار التين والزيتون” ومع ذهاب الضوضاء التي فرّ منها إلا أنه مازال حزينًا؟ فيسأل في جنون “من أين يأتي كل هذا الحزن؟” وبعد حالة السكون التي صار عليها، بعدما وصلت الذات إلى مبتغاها من اليقين يُدرك “إني أنا الشيخ، وأنه أنا، كلانا شخص واحد”.
الصورة التي لازمت الكثير من أبطال هذه القصة تجسيد فعليّ لمأساة هذا العصر، وسيطرة الروح الرأسمالية التي جعلت الإنسان أشبه بآلة يدور في فلكها ولا يستطيع الخروج من جاذبيتها، وإن خرج فهو أشبه بالعاجز أو المجنون وينتهي به الحال إلى اللامبالاة كما في بطل قصة “اللحن” الذي يصرُّ على أن ينزل في الفندق رغم تحذيرات الخادم بأنه مسكون بالعفاريت إلا أنه لا يُبالي وينام فيه.
وهناك مَن يستغويه الإنجاز السريع فيقع في المصيدة على نحو ما حدث مع أبطال قصة “على الجسر” لمصطفى لغتيري، فالبطل وأصدقاؤه ضاع منهم الطريق، ثم جاءهم المنقذ أو الملاذ دون أن يفكروا كيف في هذا المكان المجهول؟ ولماذا؟ بل استطاعوا عبره الخروج من المأزق الذي هُم فيه، وما أن وصلوا إلى الجسر الذي يقود إلى المدينة، لاحت أطماعهم في الأفق، وأرادوا استكمال الطريق بالأحصنة التي قادتهم إلى قبل الجسر بقليل، إلا أن بعضهم أراد أن يُكْملوا الرحلة إلى بيوتهم بالأحصنة، وبينما الأحصنة تعبر الجسر حتى انتفضت وكأنها رأت “أشباحًا مرعبة… انتفضت فزعة”. ورمت بهم وسقطوا في مياه النهر، ثمّ عادت.
أو يبقى أسير المادة يدور في فلكها حتى يكاد يُصاب بالجنون كما رأينا بطل قصة “علبة الرسائل الصفراء”، فقد صار مهووسًا بفتح الصندوق، في انتظار الرسالة التي ستغير مصيره وبؤسه، وعندما تأتي يقع فريسة لها، فتحرق يده التي هي مصدر رزقه في الكتابة. أو يكون مصير الشخصية الاختفاء كما تجسّد في شخصية المواطن أحمد البهجة، في قصة “الوقائع الغامضة لاختفاء المواطن أحمد البهجة” للحسن باكور، ففي” ذات صباح خريفي شديد البرودة اختفى أحمد البهجة -فجأة- من الوجود!” وقد تنتهي به إلى أن يقع فريسة أحلامه كما في بطل قصة مثل “تفاحة مهضومة” فينتهي به الحال إلى تلبس شخصية كافكاوية بعد أن يحلم بأنه صار فريسة للنمل الذي يفتح فمه، وما أن يستيقظ في الصباح على صوت أمّه حتى تُفاجأ وهي تكشف الغطاء عنه بأن جسده صار “مثل تفاحة مقضومة. قطع كثيرة من اللحم مبتورة ولا قطرة دم تنزّ منك”.
وثمة أزمات إنسانية تعتري الشخصيات وتكاد تفتك بها على نحو ما تعرّض له عباس بطل قصة “مينوش” لأنيس الرافعي، الذي كاد يفقد روحه حزنًا على فقده قطه مينوش فلزم غرفته أربعين يومًا وقد “جعل أمواج الحزن تضرب بلا توقف على شواطئ روحه وسقى عزلته بجدول الأرق. أقام جنازته الداخليّة هناك في ركن قصيّ من الغرفة لا يبارحه، يجفل فقط حينما يظهر له ظلّ ‘مينوش’ مرصوصا على الحائط أو يمرّ شبحه خفيفا من بين”.
وقد تكون الهزيمة هزيمة حرب، أو هزيمة امرأة أو الاثنان معًا كما مُنِي بطل قصة “ميت عائد من الحرب بسفرجلة” لسعيد منتسب، فيجلس البطل في هذا المكان الذي لا يعرف كيف أتي إليه، مُتذرعًا بحزنه علي تلك المرأة التي فقدها، ومجترًا هزائمه من فقد امرأة هجرته، ومن ذكريات حرب ذهب إليها أصدقاؤه “ليعزفوا ألحانًا على مسرح نظيف” فما عادوا، وكانوا “يقطعون أصابعهم بسواطير حادة ليطعموا أطفالهم المحاصرين بالدبابات والقنابل والراجمات”، ومن شعوره بفرط أزمته يتبرأ من هذا الجسد الذي خذله، فيرفضه “أنا لست بحاجة إليه، أريده أن يبتعد عني، أن يختفي، أن يتوقف عن استعبادي. لا أريده. لا أريده!”.
السِّمَةُ الغالبة لشخصيات كثير من القصص، أنّها دومًا شخصيات مأزومة تشعر بالإحباط واليأس ينتابها القلق والحيرة ويغلب عليها الشعور بالوحدة. وأزمتها في أصلها ترجع لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية
أقسى هذه الأزمات هي أزمة المحب العاشق الذي يُفْجع في محبوبه كما في قصة “طيّارة الريح” ليوسف بوذن، فالكاتب الذي هَام وعشق سعاد جارته التي تخرج معه للرعي، وشارك كافة عناصر الطبيعة في حُبِّها، أسراب الطيور والعصافير، وشجرة التين، يفجع بموتها وهو يستعد إلى زفافهما، ومن شدة الفاجعة التي ألمّت به، وهو الذي لمحتْ أمه في عينيه عشق امرأة، وعندما تتحدث إلي أبيه كانتْ تسميها له، يصير بعدما رأى جسدها يتجه إلى المقبرة أشبه بمجنون وعاشق من العشّاق العذريين فهام على وجه يردّد اسمها “حافي القدمين، مخطوف العين، ممزق الشفاه والثياب”.
تتوازى أحيانًا الهزائم مع السّلبية على نحو ما نرى في قصة “شجرة الزقوم” لأبي بكر العيادي، وهي قصة رمزية في المقام الأول، فالكاتب يرمز للفكر المتطرف والشاذ بهذه الشجرة التي “نبتت في قلب الجنان دون أن يغرسها أحد” بل كانت تنمو وتتعاظم في إشارة إلى خطرها المحدق، وكأنها نذير شؤم. ومع أن الكاتب أبرز عبر راويه مخاطرها إلا أنه مع الأسف جاء تعامل أهل البلدة سلبيًا، سواء في مشاهدة هذه النبتة الغريبة وهي تنمو دون مقاومة منهم، والأدهى أنهم عندما استطال خطرها اكتفوا بمقاومتها بالفكر القديم، فاستعانوا بخبرة الجدّ، وكان أولى بهم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والآلة.
وهذه السلبية التي أظهر بها الراوي شخصياته في تعاملهم مع الواقعة، وكأنها إدانة أيضًا من الكاتب للأفكار القديمة التي يُرددها الكثيرون لحل مشكلة الإرهاب، ومن ثم يعوّل على سلاح العلم والفكر لمقاومة الأفكار الخبيثة.
تتكرّر السّلبية في قصة “تفاحة مقضومة” لعبدالهادي الفحيلي، فمع أن القصة وجودية بامتياز وتنتهي نهاية كفكاوية في إشارة لعبثية الواقع الذي عاش فيه البطل العاطل عن العمل، رغم أنه خريج جامعة وحاول أكثر من مرة إلا أنه فشل، وهو ما حدا به إلى الدخول في إشكالية وجودية، فيتساءل في شك “لماذا يا الله…؟”، ومرة أخرى “أنت تدب على الأرض فأين رزقك؟. وعندما يرى منظر النمل وهو يعمل يعيد ترتيب المواقع ويتخيّل نفسه النبي سليمان والكلّ يَسجد له. حالة الاضطراب والشّك التي وصل إليها، جعلته يهلوس ويتخيّل أن النمل يأكل جسده، ومع استيقاظه تتداخل الهلوسات بالواقع مع صياح أمه بأن جسده صار مثل “التفاحة المقضومة”. طبعًا القصة سخرية من هذا الواقع المرير وضغوطاته في صورة الأب الذي كلما رآه صرخ فيه “ابحث عن عمل حتى الحمار يعمل”.
حال المرأة
لا تختلف المرأة عن الرجل فهي أيضًا دومًا تعاني من سوء تصرفات الأب وإهمال الزوج وعدم مبالاة الأخ أو فضول الآخرين، فتأثير الذكورية خلق أزمات عديدة على نحو ما حدث مع بطلة “شرفة الضجر” التي تعاني من أزمة نفسية بسبب حالة الفقد التي تشعر بها، فينتهي بها الحال إلى جريمة قتل، بعد أن افترستها الوحدة، وبديلاً عنها انشغلت بمراقبة الناس، حتى رأت علاقة الجار بالأطفال وعندما أرادت أن تستكشف ما يحدث، أراد أن يغويها، فقاومته، وهو ما أوقعها في جريمة قتل.
وبالمثل بطلة “سرقات صغيرة” فموت أمها ثم انصراف الأب عنها، أوقعها في ارتكاب هذه الجرائم التي توصفها بأنها صغيرة، من قبل سرقة الجوارب الشفافة تارة، ورواية عن الحب تارة أخرى. وبعد الرواية لم تعد بحاجة إلى شيء، فاستغنت بعالم الخيال عن الواقع الذي جعلها تنمو وتكبر بين غياب أب لا ينظر لها وأخ غاب هو الآخر لانهماكه في لعب الكرة. والأغرب أنها بعدما كبرت راحت تواجه أزمة أخرى بأن قالت لها جارتها “لا تأخذي زوجي منّي” ومع الأسف لم يكن من اهتمامها سرقة الأزواج فهي كانت تسرق الحياة التي افتقدتها بغياب الأم وعيشها وسط جو ذكوري لم يبال بكونها أنثى لها احتياجاتها.
وهناك أيضًا أزمة بطلة قصة “لم أعد طفلة” في عالم الذكورة المتلصص، فهي كلما حاولت أن تخفي أشياءها الخاصة بذاتها تقف لها عين ويد الذكورة بالمرصاد، بدءًا من قطعة القماش التي سعت لتخفي بها سرها، فجاء الأخ وأخذ قطعة القماش المنشورة واستعملها في لُعبة من ألعابه، وعندما واجهتها مشكلة نموّ الشعيرات في أماكن تحت إبطها وبين فخذيها، كان المنقذ في صديقتها التي أهدتها موسى حلاقة قالت إنه من النرويج، وإمعانًا في الإخفاء حتى لا تصل إليه اليد المتلصصة، أخفتها في صدرها، على قطعة القماش التي تشد بها نهدبهيا “كي لا ينفلتا بجنون نحو أنوثة لم أكن بعد مستعدة لها” على حد قولها في نهاية القصة، وهو ما يؤكد تخطيها حالة القمع التي مورست عليها من قبل الذكورية.
بعض القصص تكاد تكون ثيمتها تكرارًا على نحو قصة “عدوى الحب” فموضوعها قديم حيث حب الصديق لحبيبة صديقة بسبب كلامه عنها ووصفه الدقيق، لكن المفارقة هنا أن المؤلف جعل من الحبيب يموت في حادث سير، يتذكر الحكاية عندما ذهب في عزائه ورآها دون أن يرشده أحد، فمن كثرة كلامه عنها صار يحلم بها، يستغل اللقاء الذي جمعه يوم وفاة صديقه في الجامعة، ويخبرها أنه سوف يرسل لها رسالة مع أخته. كانت الرسالة هي ذاتها التي كتبها صديقه أكثر من مرة ومزقها، أعاد كتابتها بخطه، وأرسلها من جديد، بما تحويه من كلامه السابق لها. وبعد زواجها يسمّي ابنهما مراد على اسم ذلك الذي كان طرف الخيط بينهما. القصة توحي بالأمل وأن الحب لا يعرف مكانًا.
لا تختلف المرأة عن الرجل فهي أيضًا دومًا تعاني من سوء تصرفات الأب وإهمال الزوج وعدم مبالاة الأخ أو فضول الآخرين، فتأثير الذكورية خلق أزمات عديدة
القصة والوعي المرجعي
في أطروحات ميخائيل باختين خاصة في كتابيه “شعرية دوستويفسكي” و”الماركسية وفلسفة اللغة” أشار إلى مصطلحين غاية في الأهمية هما التفاعل اللفظي والتداخل النصي. والتداخل كما يرى شيكلوفسكي هو “أنّ العمل الفنّي يُدْرَك في علاقته بالأعمال الأخرى، وبالاستناد إلى الترابطات التي تقيمها فيما بينها” ومن ثمة فقيمة هذا النتاج الأدبي تتجلّى من خلال عملية التقاطع مع باقي النتاجات الأدبية، ومدى التأثير والتأثر المتبادلين.
معظم الدراسات لم تلتفت إلى حضور هذا المصطلح في القصة القصيرة، على الرغم من أن القصة القصيرة “نوع بيني” في الأصل، فقصروا اهتمامهم على حصر تجلياته على حقل الرواية. يتأتى -هنا- حضور هذا المصطلح بما يكشفه من وعي ثقافي مرجعي يستعيده الراوي عبر تداخلات وتضمينات كما في قصة “اللحن” لعبداللطيف النيلة، يقيم السّارد علاقة جدليّة مهمّة تبرز قيمة النص مع حكاية الموسيقار “لوساك هوسمان” القادم من النمسا، من خلال شخصية النص المحورية البطل عازف الكمان الذي هجرته الألحان، وظن أن قريحته الموسيقية قد نضبت، فيقرّر أن يغيّر المكان، وبالفعل يقصد منتجع “أوريكا” وهناك في الغابة الجميلة، وأثناء بحثه عن بيت للكراء، يتعجب من شروط صاحب البيت الذي يؤجّره في النهار أما المساء فلا، وهنا يصمم على أن يستأجر البيت رغم تحذيرات الخادم وصاحب البيت موسى، وما أن يبدأ أول لياليه هناك، حتى تعود إليه ألحانه، لكن المفاجأة أن صوت الكمان وهو ينساب كان متداخلاً معه صوت عزف بيانو، وهنا يعرف قصة هذا الموسيقار الذي قدم إلى المكان وأقام فيه، حتى تحلّلت روحه.
وبالمثل في قصة “مينوش” لأنيس الرافعي، وهي القصة التي تتماهي مع حياة الفنان التشكيلي المغربي عباس صلادي، وعلاقته بقطه مينوش، فالراوي يسرد عن فنان تشكيلي مغرم بقطه مينوش الذي وجده في أحد مقالب الفضلات، صارت بينهما علاقة توحد، فكما يقول الراوي “على ما يبدو اكتملت دورة روح عباس واستقام تلعثم أفكاره لمّا أصبح له، أخيرًا، رفيق دائم يمسّد سواد جلده مثل بيانو جديد، ويرى في وميض عينيه الحيوانيّتين أصباغًا لا حصر لها ستولد عمّا حين على أهداب الفرشاة” ومن ثمّ رفض بيعه، وعندما اضّطر إلى سكن في مكان آخر لم يكن يدري بأنه اختار المكان الخطأ.
ذات يوم خرج مينوش ولم يعد، تحسّر عباس على تركه يخرج، خاصة بعد أن اشتكى أصحاب المنزل “مرارًا وتكرارًا، من بقايا فضلاته على السلالم، ومن هبشه العشوائيّ لصفائح اﻷزبال” ولكنه ربّى الأمل بسطوعه بين لحظة وأخرى. وجد مينوش ولكن كان السّم أخذ مأخذه منه، فمات، هنا زادت حسرة عباس عليه، حتى أنه “لزم غرفته لمدة أربعين يومًا، لا يشرب سوى الماء ولا يأكل سوى الخبز الجاف”.
كان يخاف من هجمة الخواء وانقراض الذكرى، لذا جعل أمواج الحزن تضرب بلا توقف على شواطئ روحه وسقى عزلته بجدول الأرق. أقام جنازته الداخليّة هناك في ركن قَصيّ من الغرفة لا يُبارحه، يجفل فقط حينما يظهر له ظلّ “مينوش” مرصوصًا على الحائط أو يمرّ شبحه خفيفًا. غادر عباس الغرفة، وفي ذات يوم جاء ليأخذ بعض أشيائه، فقابلته زوجة صاحبة البيت ضامرة. وحكت له ما حاقَ بزوجها وابنها بعد محاولتهما تفادي الاصطدام بقط خرج من تحت إبط الطريق ومرق من أمامهما!
وبالمثل قصة “ميت عائد من الحرب بسفرجلة” لسعيد منتسب، ثمة بنية مرجعية، وهنا ليس مع نص بل مع صورة الممثلة إليزابيث تايلور. وفيلمها كليوباترا مع أنطونيو، ومن فرط أحلامها بها، يتخيل أنها “تمسح فمها بكُمّ فستانها” وتطلب منه أن يكون “أنطونيو” لكن الغريب أنه يتبادل الأدوار ويفضل أن يكون الأفعى. كما أن قصة “علبة الرسائل الصفراء” لغادة الأغزاوي، لا تتعامل مع التصدير الذي سبق القصة، بمعزل عنها، بل هو داخل في بنية القصة، فالتصدير الذي يقول ” بَعض الكتّاب، لَيسوا كتّاباً مثلَ الآخَرين..” وهو مقتبس من الروائية الفرنسية كريستين آنچو، يتداخل مع بنية القصة، فعندما يتعرض الكاتب لحرق في أصبعه، يضطر لأن يستعين بحارسة العقار لكي تكتب رسائله وترسلها إلى الناشر.. ويأتي عنوان قصة لحسن باكور “الوقائع الغامضة لاختفاء المواطن أحمد البهجة” متناصًا مع عنوان إميل حبيبي “الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل“.
ثمة مراوحة في النصوص في تمثُّلها لمفهوم القصة بمعناه الكلاسيكي، على نحو ما نرى في قصة “انتظار” لعبدالرازق بادي، فهي تلتزم ببنية القصة سواء في شكلها بما في ذلك الاستهلالات الوصفية لخلق جو نفسي، أو في بنيتها الداخلية، وكأننا إزاء قصة “نظرة” ليوسف إدريس، فجوهر القصة قائم على لقطة/أو لحظة لعجوز بملامح وجه متعب، وأخاديد زمن واضحة على صفحة وجهها، وهي تهبط بحملها الثقيل، وثمة تركيز على الأبعاد النفسية لها كنوع من التحفيز للتعاطف معها حيث “الحمل على رأسها ثقيل والضغط على الرقبة لا يطاق، الألم يسري عبر الظهر المتعب من رحلة الحياة الطويلة“، ومع حالة الصراع والمقاومة التي بدت عليها العجوز وهي تود مواصلة مسيرتها وإن كانت ببطء شديد دون توقف، فهي تعلم أنَّ الزمن “لا يتوقف لأيّ كان” وإن كان أملها في أنها “ستصل إلى كوخها عند طرف الوادي في آخر المطاف” إلا أن صاحب الكاميرا يركز في التقاط الصورة وضبط زواياه، دون الاهتمام بما يحدث للمرأة التي سقطت على ظلها فما كان يهتم به هو “أن يتوسّط خيال العجوز مرمى العدسة” في إشارة لفقد المشاعر الإنسانية في الزمن الاستهلاكي.
ثمة مراوحة في النصوص في تمثُّلها لمفهوم القصة بمعناه الكلاسيكي، على نحو ما نرى في قصة “انتظار” لعبدالرازق بادي، فهي تلتزم ببنية القصة سواء في شكلها بما في ذلك الاستهلالات الوصفية لخلق جو نفسي، أو في بنيتها الداخلية، وكأننا إزاء قصة “نظرة” ليوسف إدريس، فجوهر القصة قائم على لقطة/أو لحظة
وهناك مَن يرقش غياب بني الوعي وتصلبها، كما في قصة “غافية على ركبة الزمن” للتونسية هيام الفرشيشي، فتندد بمخاطر رجال الدين الذين يستغلون الفاقة وحاجة الناس للمال، لاستغلال المحتاجين فتسرد على لسان البطلة شهادتها كيف استغل المسلحون الذين سكنوا الجبل وما أحيط بهم من ألغاز وأساطير تعود إلى اليونان الذين كانوا يمارسون التعذيب في المكان نفسه. وكانوا يقايضون السلاح بالمال. القصة تنتصر للعلم وقدرته على فضح الفكر الخرافي، وأيضًا تكشف زيف الأدعياء الذين يتستّرون بالدين.
الطابع الكلاسيكي حاضر في قصة “ريشة الغراب” لإسماعيل غزالي، فبطل القصة يعمل مُحرّرًا في مؤسسة أدبية متخصصة في نشر دواوين الشعر فقط، مُنشغل هذه الأيام بانتخاب مختارات لمئة شاعر، وبينما يمر في المدينة إذ تسقط عليه ريشة غراب بعد سماعه صوت طلقات قنّاص. يعود بالريشة ولا يعرف ماذا يفعل، إلا أنه يستغلها في كتابة رسائل إلى شخصيات نسائية مجهولة، تصل الرسائل إلى أربعين رسالة وبعدها عجز عن كتابة أيّ رسالة.
كانت العناوين التي يرسل إليها الرسائل تأتيه في الحلم. وبعد أن انصرمت أيام وصلت إلى أربعين يومًا، جاءته امرأة وانتظرته على عتبة بيته بعد عودته من الحانة، سألته إن كان هو المحرّر. وعبر حوار قصير دار بينهما أخرجت المرأة رسالته الرسالة التي أرسلها لها. وكان سؤالها من أين عرف عنوانها. حكى له عن قصة الرسالة وهي أيضًا كشفت له أن النساء الأربعين من هن إلا امرأة واحدة، هي التي تجلس أمامه. وكان لهذا الأمر قصة عاشتها في طفولتها بعد مرضها بالانفصام.
تتداخل القصة مع حكاية أخرى عن علاقة المرأة بالغراب عن طريق صبيّ زنجي غريب الأطوار مع أنه وسيم وساحر، وذات مرة كتب على جسدها مائة قصيدة كان يحفظها، وما أن اكتشف الأب القصة عاقبه بالجلد حتى الموت. الأغرب أن المئة شاعر والمئة قصيدة كانت هي ذات المختارات التي كان يجمعها المحرّر.
القصة تكشف عن حالات اللاوعي التي يعيشها الكاتب مع أعماله، وكيف أنها تصل به إلى حالة من الهوس أقرب إلى الجنون كما رأينا في القصة. فالكاتب هنا اعتمد على شكل كلاسيكي وحكايات متوالدة داخل النص الواحد.
وهذه الكلاسيكية سارية ومتحققة في نص “شرفة الضجر” لأمينة الشيخ، فنحن أمام شخصية تضطرها الظروف بسبب الوحدة والإهمال الذي عانت منه بسبب انشغال أمها عنها، وبعد زواجها الذي جاء تقليديًا من زوج “يميل إلى الصمت وتجنب الجدال” وجدت الحل في النافذة التي كانت بمثابة الخلاص مما تُعانيه، ومن المكوث فيها لمقاومة الضجر، تحوّل الأمر إلى عادة لمراقبة الرجل الأحدب، وهو ما انتهى بها لاكتشاف جريمة لم تتأكد منها وعندما يدفعها الفضول للتحقق من شكوكها، تقع في جريمة قتل دفاعًا عن ذاتها، كلاسيكية القصة ليس في بنيتها واعتمادها على حدث وعقدة كما هو الحال في قصة “مينوش”، ولكن أيضًا في موضوعها الذي يبدو اجتماعيًا ناقمًا على التربية وزواج الصالونات.
وقد تأخذ القصة شكلاً تراثيا كما هو حال قصة لحسن باكور “الوقائع الغامضة لاختفاء المواطن أحمد البهجة” حيث السّرد الخبري، إلّا أنّ السّارد يتلاعب بنصه عبر الاستعانة بتعدد الرواة، وسرد الحكاية من وجهات نظر مختلفة ليجعل من حدث عادي لشخص أقل من العادي حدثًا مهمًّا، يَحظى بالمتابعة وهذه غاية الفن الجيد. فليست غاية الفن تقديم صورة عن الواقع فقط أي عكسه، وإنما تحويل المألوف إلى غريب عبر وسائل وتقنيات تجعل من العادي يأخذ منحى جماليًا.
تدمير الحكاية
في مجمل القصص يسعى الكُتَّاب إلى استخدام تقنيات كتابية تعتمد في المقام الأول على اللغة، بعيدة عن الاستهلاك، وبعضهم يقترب من الحكي الشفاهي كما في قصة “جناح لثغاء الأبجدية” لعبدالرازق بوكبة، القصة المروية بلسان راوٍ يمتلك صفات الرّاوي الشعبي كما هي قصص يحيى الطاهر عبدالله، فالتلاعب باللغة والمفردات أحد أهم سماتها، كما أنّ ثمّة ارتباطًا بين اللغة والوسط المنتجة فيه، أو ما أسماه باختين “التفاعل اللفظي” وكأنّها لغة شفاهية. وهناك من القصص ما تتصل باللغة الشعرية بما تكتنزه المفردات من مجازات بلاغية وتشبيهات وكنايات دالة.
لكن الشيء اللافت أن معظم القصص سعت إلى تدمير الحكاية وهدم سياقاتها المتداولة، وتركيب سياقات جديدة، فغدت بعض القصص وكأنها تميل إلى التغريب أحيانًا كما في قصة “تهاويم ليلة باردة” فالسادرة تحكي عن علاقة متوترة بين زوجين تؤذن بالرحيل ودخول أخرى إلا أنها أغرقت القصة بالغموض. وإن كانت في حقيقة الأمر استدعت القصة قارئها لا بوصفه متلقيًا سلبيًا، بل بوصفه فاعلاً في النص بالدخول إليه وفك تشابكاته، وردّ دواله إلى مدلولاتها، وهذا واضح في قصة “جناح لثغاء الأبجدية” لعبدالرزاق بوكبة، حيث تلاعب الكاتب بقصته عبر اللغة وأعطى للكلمات دلالات أخرى غير متداولة ليكشف فداحة الأحداث التي عُرفت بالعشرية السوداء في الجزائر.
وقد استوعبت اللغة حالات الحيرة والتردد ومشاعر الفقد والهيام، وأيضًا السّخرية من الدكتاتور. وفي أحد جوانبها كانت لغة عارية كاشفة لطبيعة الجسد وتكويناته.