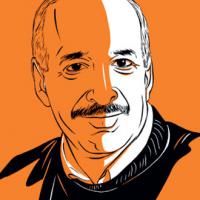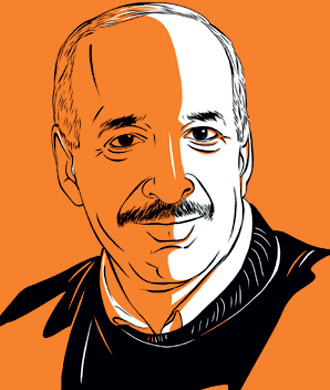جدّي الاستثنائي

عند مدخل محطة قطار كركوك، التي أعمل فيها حارسًا منذ 13 سنةً، أوقفت دورية عسكرية أمريكية سيارتَنا الميتسوبيشي، قُبيل شروق شمس الثلاثاء الرابع من كانون الثاني 2004. كان أخي الصغير محمود يقودها ببطء، متوقّعًا أن تصادفنا مثل تلك الدورية في أية لحظة، على الأخص في ذلك الوقت المبكّر من اليوم، بينما كنت جالسًا إلى جواره، منكمشًا، مضطربًا، أتطلع من غير تركيز إلى شجيرات الدفلى الممتدة على جانبي الطريق، يستحوذ عليّ الأسى وأنا أستحضر صورة جدّي لأبي الذي فارق الحياة، وأسدل عليه ستار العدم.
كان محمود قد اتصل بي هاتفيًّا بعدما لاحت خيوط الفجر، وقال لي بنبرة حزينة “جدّي فنجان أعطاك عمره”، وقد شعرت بأن شفتيه ترتعشان وهو يُنبئني بذلك، وعقب نصف ساعة جاء إلى المحطة ليقلني إلى البيت، وكانت ريح الشتاء، قبل وصوله بدقائق، غاضبةً تتمادى في ضرب الأشجار، مصحوبةً بمزنة رعدية قوية، وحبال ماء متماوجة تسّاقط في إيقاع بطيء تارةً وسريع تارةً أُخرى، لكن ذلك لم يستغرق طويلًا، سكنت الريح على حين غرّة وكأن مروحةً عملاقةً كانت تدفع الهواء صوب المحطة ثم أُطفئت، وتحوّل المطر إلى رذاذ ناعم.
عزّاني صاحباي في الحراسة باران وياسين، وقالا إنهما سيأتيان رفقة صاحبنا الرابع مراد للمشاركة في مراسم التشييع بعد حضور الحرّاس النهاريين.
أشارت مجنّدة، تحمل على ذراعها شارةً من ثلاثة خيوط، إلى محمود أن يطفئ مصابيح السيارة والمحرك، ثم دنت بخطى سريعة وصوّبت بندقيتها تجاهنا، وأمرتنا بصوت هائج أن نترجّل رافعَين أيدينا وندير لها ظهرينا. كان وجهها أبيض منمّشًا تخالطه حُمرة، ذكّرتني بممثلات الإغراء في سينما هوليود. انصعنا لأمرها، مثل أسيرَين، من غير أن ننبس بنصف كلمة، وراح جندي ثانٍ يلفّ حول السيارة بجهاز كشف الأسلحة والمتفجّرات، وألزم جندي ثالث محمود بأن يفتح صندوق الأمتعة، فانصاع له محمود. شرع الجندي في التفتيش، وحينما انتهى كرّر العملية مع باطن السيارة.
كان التوجّس باديًا على سحنات أفراد الدورية بسبب مقتل عدد من رفاقهم قبل يوم بصاروخ آر. بي. جي 7 استهدف عجلتهم الـ”هامفي” في حي “العروبة” بالمدينة. وكانت الأوضاع قد ازدادت توترًا منذ عملية القبض على الرئيس منتصف الشهر السابق في إحدى مزارع بلدة “الدور”.
لم يعثروا على شيء في السيارة، فزعقت المجنّدة ذات الثلاثة خيوط “Go to Hell” (اذهبا إلى الجحيم). اختلست نظرةً خاطفةً إليها، بعدما شغّل محمود المحرك، وأردت أن أصرخ في وجهها”Fuck you”، لكنني لم أجترئ، وانطلقنا مبتعدَين. تطلّع محمود عبر المرآة الداخلية إلى الخلف، وباح بما يعتمل في نفسه “آه لو تُتاح لي فرصة الانفراد بها”، قلت “أستطيع أن أُخمّن”، قال “لا، ما في بالك يمتّعها ويسلّيها، وما في بالي يجعلها غير صالحة للخدمة العسكرية”.
نشّفت شعري ووجهي اللذين بلّلهما رذاذ المطر، واستعدت كلام جدّي قبل ساعات من مجيئي إلى العمل “منذ سنين وأنا أحلم برؤيتك عريسًا. هل ستظل أعزب طوال عمرك؟ جميع إخوتك وأخواتك تزوجوا، حتى أخوك الأصغر سيتزوج خطيبته قريبًا”، وعانقني كأنه كان يحدس أن حياته في طريقها إلى الأفول.
ما كنت أتوقع موته. ظننت أنّه سيجتاز التسعين، وربما يُصاب بالخرف، لكنّه فاجأني بغروب شمس يومه الأخير عن تسع وثمانين سنةً. توقف قلبه عن النبض، ومات موتًا هادئًا، وأسدل الظلام ستائره عليه من دون أن تُتاح لي فرصة توديعه. اختتم حياته في الدنيا ومضى خفيفًا، مخلّفًا وراءه غابة من الأحزان، أحزان أهله وأقاربه والجيران وزبائنه القدامى في دكّان التبغ، الذين كانوا ينادونه “حاج فنجان”، رغم أنه ما قصد مكة قَطّ.
لم يكن يعاني من أيّ داءٍ سوى آلام المفاصل التي كانت تثبّطه عن السير باستقامة، ولم يقترف في حياته ذنوبًا كبيرةً، إنما أستطيع القول هفوات صغيرةً يُمكن أن تُغتفر، وقد يقترفها أيٌّ زاهد.
كان جدّي، المتقاعد من العشق منذ قرابة ربع قرن، حلو الفؤاد كالعسل، يدّخر في رأسه الكثير من الاستيهامات والحكايات الطريفة والهلاوس التي يبرع في روايتها، ويطيب لجلاّسه سماعها، يمطرها عليهم كما لو أنها حقائق. أتذكّر من استيهاماته أن الجنة فيها أبقار، وهي مصدر أنهار اللبن التي يذكرها القرآن، وفيها ثيران أيضًا وإلا كيف تتكاثر؟ ثيران مجنحة تطير مثل الطيور، وكلما عنّ لثور أن يسفِد أنثاه حطّ على ظهرها.
سألته من باب المزاح:
- كيف تتحمّل البقرة ثقل الثور على ظهرها؟
- يا ولد يا فهيم، أبقار الجنة ليست ضعيفةً مثل نسواننا، بل لها قدرة على التحمّل تعادل قدرة عشرات الأبقار قي الأرض.
وأطلعته ذات يوم على صورة لثور مجنّح منشورة في مجلة، أيام كان بصره قويًا، فهتف:
- والله، لو لم يكن له رأس بشري لقلت إنه الثور العملاق الذي سيكون طعام أهل الجنّة.
- مَن قال ذلك؟
- أحد الملالي في القرية.
- هل قال إنه ورد في حديث نبوي؟
- أظنه قال ذلك.
- لكنني قرأت أن أهل الجنّة يُضيَّفون، أول ما يُضيَّفون، بزائدة كبد الحوت ثم يُنحر لهم الثور ليتغذوا بلحمه.
- لماذا الحوت؟
- لأنه، كما يقولون، من الحيوانات المائية التي تشير إلى عنصر الحياة، والثور من الحيوانات البرية التي تشير إلى الحرث والكسب، واستطعام أهل الجنّة منهما إشارة إلى نهاية الدنيا وبداية الآخرة.
- وأنت ماذا تقول؟
- والله يا جدّي دماغي لا يستسيغ هذا الكلام، لا الحوت ولا الثور.
- ماذا تريد؟ لحم غزال؟
- حبذا يكون كبابًا مع طماطم وبصل مشويين.
- كباب لحم ثور؟
- لا، لا، لحم خروف.. لحم خروف.
ظلّت حكاية الثيران مغروسةً في ذاكرتي، وصرت أتحيّن الفرصة لاستثمارها في قصة قصيرة، ولا بأس أن تكون فانتازيةً بطلها جدّي. وذات يوم شرعت في كتابتها، وأنجزتها في أسبوع، ولمّا راجعتها، وشذّبت ما يلزم تشذيبه، لم أجد عنوانًا ملائمًا لها أفضل من “ثيران الجنّة”، ثم جال في خاطري أن أحولها إلى رواية.
من استيهامات جدي أيضًا أن امرأةً داهيةً خطف نظرها شاب اسمه مطر، فوثّقت علاقتها به وواعدته بأن يقضي معها ليلةً يوم سفر زوجها، واتفقت معه على ترك باب بيتها الخارجي مفتوحًا. ولما جاء اليوم الموعود طرأ طارئ جعل الزوج يلغى سفره، وكان التيار الكهربائي مقطوعًا والجو ماطرًا. فكّرت المرأة في خدعة لئلا تفوّت الفرصة، فاشتكت لزوجها من ارتفاع حرارة جسمها، بينما كانا في حجرة المعيشة، وفتحت النافذة وعرّت مؤخرتها ودفعتها إلى الخارج، وأسدلت الستارة على جسدها، وانحنت باسطةً كفّيها على ركبتيها ليتسنى للبرودة أن تنفذ إلى لحمها وعظامها. حين دخل العشيق خُلسةً واقترب من باب الحجرة، لفت نظره وضع عشيقته في النافذة، فأدرك مغزى الأمر، وحلّ سرواله على الفور، وطفق يرهزها رهزًا متباطئًا. لكن ذلك لم يرق لها، فحثّته بصوت عالٍ “دُق يا مطر دُق…. دُق يا مطر دُق…. دُق يا مطر دُق”. استجاب مطر لها وصار يدّقها دقًّا أقوى حتى أتت شهوتها وارتخت عضلاتها، بينما كان زوجها يضحك حتى ترى منه لهاته، متوهمًا أنها تخاطب مطر السماء.
حين وصلنا إلى البيت كان نواح أخواتي يهزّ الفضاء. دلفت إلى الحجرة التي سُجّي فيها جثمان جدّي، ورفعت طرف البطانية عن رأسه. كانت عيناه مفتوحتين كأنهما تنظران إليّ، فأردت أن أطبق جفنيه بأصبعي، إلّا أن نفسي لم تطاوعني. مسحت جبينه بباطن كفّي وقبّلته واستغرقت في البكاء، شاعرًا بأني أنسحب إلى أعماق جسدي، لكن صهري أمجد سرعان ما أعاد البطانية إلى وضعها، وهو يؤنبني “لا تبكِ يا رجل، البكاء يعذّب الميت”، ورفعني من كتفيّ وأخرجني إلى باحة البيت.
انتظرنا في الصباح حتى يتوقّفْ المطر لنباشر بمراسم التشييع، لكنه عاد إلى حاله التي كان عليها في الفجر، وطال انتظارنا عدة ساعات إلى أن انقطع في الظهيرة، وظلت تخيّم على السماء غيوم كابية معتمة، فبدا الجو باعثًا على الانقباض.
وضع بضعة رجال النعش في سيارة بيك آب حملته إلى مسجد ملاصق لسياج المقبرة، واقتفى أثرها موكب مشيّعين يستقلون ما يقرب من ثلاثين سيارة. في الطريق انضاف إليهم آخرون لا أعرفهم. أدّوا شعائر الغسل وصلاة الجنازة في المسجد، ثم رفعوا النعش على الأكتاف بالتناوب، وساروا إلى القبر الذي حُفر على بعد أمتار عن قبر أبي.
حين أنزلوا الرفات إلى القبر، وحلّ الدفّان عُقد كفنه وأضجعه في اللحد، أثقل عليّ الأسى، وانكمشت على نفسي، وفاضت عيناي بالدموع، فانتحيت جانبًا، حيث قبر أبي، وبسطت كفيّ على شاهدته، وأسندت جبيني إليهما وواصلت البكاء.
لم أساير الآخرين في نثر حفنة تراب على قبر جدّي. شعرت بأن الزمن توقف، وأن أُسرتي فقدت بموته عمودها بعد رحيل أبي. ولما انتهى طقس التلقين، وانفض المشاركون في مراسم الدفن قرأت له الفاتحة بخشوع، والتقطت آجرّةً ووضعتها على قبره كعلامة.
حزن الجميع على موت جدّي، بدا ذلك على وجوههم في مجلس العزاء، وبكى بعضهم، ما عدا أمّي التي لم تذرف دمعةً أو يرفّ لها جفن، ولم تُخرج آهةً من صدرها قطّ، كأنها تخلّصت من مصدر إزعاج كان يرهقها وهي في حاجة إلى مَن يخدمها. ربما كان يراودها خاطر بأنها ليست مضطرةً إلى تحمّل طلباته الكثيرة.
ظلت خيمة العزاء منصوبةً في الشارع خمسة أيام بدلًا من ثلاثة، كما هو معتاد، لأن أقاربنا ومعارفنا كانوا يتوافدون زرافات ووحدانًا من بلدات وقرى بعيدة، وليس من اللائق أن نستقبلهم في البيت.
***
كان جدّي قريبًا من نفسي، وأنا أقرب الجميع إلى قلبه، أشعر بإلفة في مجالسته، أرهف السمع إليه، وأحس بأن وجوده يحميني. كنت أحبه أكثر من أبي. أذكر أنني سألته وأنا في عمر أربع عشرة سنة:
- جدّي، لماذا سمّاك أبوك فنجان؟
قال:
- لأنه كان يحب القهوة كما أحب أنا الحليب وأنت تحب الصبايا.
كان رجلًا استثنائيًا، وكنت في أول شبابي أُفرغ أمامه ما يعتلج في داخلي، وأطلب معونته حينما تعترضني معضلة، فيربّت على ظهري “هوّن عليك، الحياة لا تساوي نعلك، ومع ذلك ينبغي أن تُعاش بحلوها ومرّها، فيها أيام سعادة، وأيام نكد، أيام صفاء مثل الضوء في المرآة، وأيام كدرة كالماء العكر، لم يقع اختيارنا عليها، بل هي التي اختارتنا”.
وكان متسامحًا، رؤوفًا، يتأوّه كلما سمع بموت أحد معارفه، ويقول “صحيح أن الموت حق لكنه لا يروق لي، عزرائيل قاسٍ”. وكان عالَمًا قائمًا بذاته، لا تفوته صغيرة ولا كبيرة، كثير المزاح، يتلفظ بعبارات ريفية لم أعتد عليها، ويأتي باستعارات عجيبة لتشبيه بعض الناس بالنبات أو بالحيوان أو بالحشرات أو بالأدوات والآلات، فالمرأة النحيفة شجرة عجفاء، والفارعة الممتلئة ناقة، والرشيقة شطب ريحان، والمستنزفة لمالِ زوجها عثّة، وصاحب النخوة سبع، والشرس ذئب أمعط، والخبيث حنظل، والأكول حوت، والبخيل حِصرِم، وعديم الغيرة ديّوث، ومَن ينهب في غدوه ورواحه منشار، ومَن يقُشّ بلدوزر… وهكذا. وكان رحب الصدر، ظريفًا، يسترسل في أخيلة يندُر أن يمتلكها أبناء الريف.
لم يتلقّ تعليمًا في طفولته لعدم وجود مدارس في القرى وقتذاك، فأرسله أبوه إلى شيخ المسجد ليحفّظه آيات من القرآن، ويلقّنه بعضًا من أصول الدين وأحكامه، ويعلّمه القراءة والكتابة، فحفظ السّوَر القصار، وعجز عن حفظ السّوَر الطوال، وحين شبّ تزوج من إحدى قريباته (جدّتي)، وكانت فتاةً يتيمةً ذات بشرة بيضاء مشرّبة بالحمرة، إلى درجة أن نسوة القرية كنّ ينادينها “احمَيرة”، وصارت تشاركه في مساعدة أبيه في زراعة أراضٍ يمتلكها رجل إقطاعي يأخذ ربع محصولها. لكنّ ما كانت تجنيه الأُسرة لا يسدّ غائلتها.
وفي سن الثلاثين استُدعي إلى خدمة الاحتياط في الجيش، ونُسّب إلى فوج بإمرة مقدّم تركماني من كركوك اسمه عمر علي البيرقدار، ذاع صيته في حرب فلسطين سنة 1948 لِما تحلّى به من شجاعة، وأحبه جدّي حبًّا جمًّا، خاصةً أن اسمه يشبه اسم أبي. وقد طلب منّي مرةً، وهو يقترب من سن الثمانين، أن أدوّن على لسانه قصة مشاركته مع جنود فوجه في تلك الحرب ليطّلع عليها أبناء أحفاده الذين سيولدون بعد مماته، ولا أزال أحتفظ بالدفتر الذي دوّنت فيه القصة على لسانه، كما رواها، من غير تنميق وتزويق.
وكان جدّي ينوي، عقب رجوعه إلى القرية، أن يتطوّع في الجيش إلاّ أنه وجد والده مصابًا بمرض الرئة، ولم يلبث أن فارق الحياة، فألغى الفكرة. كما فوجئ بأن الرجل الإقطاعي، الذي يعمل في أرضه، يطمع في زوجته، وصار يحاول إرغامه على تطليقها ليضمها إلى زوجاته الثلاث، ويهدّده بالطرد من العمل إذا لم ينفّذ طلبه، لكن جدّي أبى الرضوخ لابتزازه، وقرر ترك القرية إلى كركوك، وقال له “أرض الله أوسع من أرضك”. وبعد بضعة أيام باع حصته من الماشية التي تمتلكها الأُسرة، وشدّ رحاله إلى المدينة.
لم يكن جدّي يعرف من أهل المدينة سوى شخص واحد اسمه إبراهيم سبقه في النزوح من القرية إلى كركوك بسنين عديدة إثر خلاف مع الإقطاعي نفسه، وسكن في حي “ﭙريادي”، وتمكّن من إيجاد عمل في سوق الماشية، يشتري ويبيع النعاج والماعز، لكن من سوء الحظ لم يكن بيته واسعًا، بالكاد يكفي أسرته. أقام هو وجدّتي وطفلهما (أبي) عنده في حجرة كانت مخصصةً لولديه فأخلاها لهم. لكن الولدين، اللذين صارا ينامان في حجرة المعيشة، لم يخفيا تضايقهما من احتلال مهجعهما وتعكير حياتهما، فاضطر جدّي، بعد بضعة أسابيع، إلى استئجار حجرة لدى عجوز كردية تقطن وحدها في بيت بالحي عينه، وتعتمد في معيشتها على دكان صغير تمتلكه مجاور لمدخل البيت، كان في الأساس حجرةً تطل على الزقاق تستعملها لخزن المؤونة وبعض الأشياء الفائضة والأدوات المستهلكة من مخلّفات زوجها المتوفى.
وكان جدّي يأمل أن يعيش حياةً أقل بؤسًا من الحياة في القرية، لكنه ذاق الأمرّين في المدينة خلال سنواته الأولى، حدّ أنه أبغض وجوده فيها. بحث عن مهنة يرتزق منها فلم يفلح، بالأحرى وجد مهنتين بائستين، إحداها حارس ليلي في سوق الذهب يتقاضى راتبه من الصاغة، والثانية حارس ليلي حكومي عليه أن يجوب الشوارع مع حارس آخر حفاظًا على حياة الناس من اللصوص والسكارى. وفي كلا المهنتين كان يتحتّم عليه أن يقضي الليل خارج البيت، ويترك جدّتي وابنهما وحيدَين. لذلك طلب من إبراهيم أن يشغّله معه في سوق الماشية، فاستصحبه إليه، وصار يعمل في حمل الخراف على رقبته لإيصالها إلى محلّات الجزارة نظير مبلغ زهيد عن كل واحد منها، وفي بعض الأحيان كان يتكرّم عليه الجزّارون بالعظام المكسوة بقليل من اللحم فيجلبها إلى جدّتي مغتبطًا.
تحمّل مشقة ذلك العمل من أجل لقمة العيش، خاصةً بعد مجيء عمتيّ سليمة ونجية إلى الدنيا. عادةً ما كانت الحيوانات التي يحملها تتبوّل أو تتبرّز على كتفيه في الطريق، فيضطر إلى الاستحمام وتبديل ثيابه يوميًّا. وحين أمكن له ادّخار مبلغ ماليّ اشترى عربة دفع يدويةً ليتخلّص من تلك المشكلة. وبعد بضع سنوات وفقه الله بإقامة شراكة مع أحد أقرباء العجوز الكردية في فتح محلٍّ لبيع التبغ، فخفّ عناؤه وتحسّن رزقه، واستطاع أن يستأجر بيتًا مستقلًّا لأسرته.
لكن هذا غيض من فيض مما يجدر بي أن أحكيه عن جدّي فنجان، وسأحكي في المرة القادمة عن مغامراته مع عشيقته بعد وفاة جدّتي.