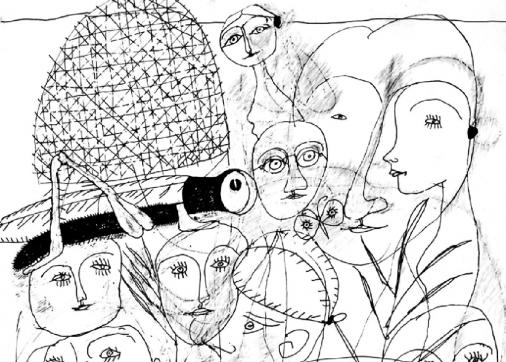خارج سلطة الموت

ولأن الشاعر الكبير لم يكن من فصيلة الشعراء الحزانى، ولم يشتهر أبدا بقصائد الرثاء (وإن كتب في ابنه المتوفي شابا توفيق وزوجته بلقيس قصيدتي ألم ولوعة من أجمل قصائده)، فإن سيرته الذاتية الثانية تحمل الطاقة الهائلة نفسها على الحياة والفرح والسخرية التي حملها شعره على مدى 50 عاما. وبالتالي فقد نبِّه قراءه أن كتابه هذا لن يكون تاريخا بالمعنى الأكاديمي للكلمة لأن التاريخ حسب قوله هو علم الحوادث الميتة، ولذلك فإن قباني هنا لن يخرج عن الطريقة التي اختطَّها لنفسه في الشِّعر والحياة. وللتأكيد على ذلك فإنه ينبِّه القارئ إلى أنه لن يعطي في كتابه هذا دروسا لأحد، وأن كتابه لن يكون درساً يلقى في مدرسة ثانوية، أو محاضرة في جامعة، بل إن الشاعر المشغول دائما بالبساطة والناس يؤكد أنه سيذهب مع القراء في نزهة قصيرة إلى شاطئ البحر، ونقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع.
من أغرب ما في كتاب نزار هذا إيراده استشهادا طويلا يبرز فيه رأي الفنان محمد عبدالوهاب المنشور باحتفالية كبيرة من نزار يمكن اعتباره، من الناحية الأدبية المحضة، ركيك الصياغة بل وقاسيا نوعا ما مقارنة بأي قراءة محبَّة لشعر قباني. فهو يقول: لم أشعر في شعره بانتفاضة قلبه، أو بمأساة عاشها، أو مشكلة مر بها واعتصرت قلبه، وصاغها شعرا، فهل يتقبل أي شاعر القول إنك لم تشعر في شعره بانتفاضة قلبه أو بمأساة عاشها؟ يشرح عبدالوهاب ذلك بالقول عن الشاعر إنه مصوّر وأنه رسام بالكلمات، فيزيد بشرحه الفكرة غموضا. ثم يشرح أيضا فيقول إن نزار عندما يعاني مشكلة، ينفصل منه نزار آخر يرقبه في محنته، ويسجل عليه تصرفاته، ثم بعد ذلك ينضمُّ إليه ليصبح نزار الشاعر يكتب ما رآه شعرا.
نزار المعجب بهذا القول الغامض يسأل زوجة عبدالوهاب عن كيف استطاع الموسيقي أن يكتب عن الشاعر بهذا الصدق والشفافية فترد: لأنه كان يكتب عن نفسه!
حول هذه العلاقة المعقدة بين الشاعر ونفسه، فإن قباني يقول في مقدمة كتابه:
“أريد أن أكشف الستائر عن نفسي بنفسي وسبب ذلك أن الشعر نبات داخلي من نوع النباتات المتسلقة التي تتكاثف وتتوالد في العتمة. إنه غابة من القصب لا يعرف خارطتها إلا من راقبها وهي تكبر في داخله شجرة.. شجرة…”.
ولعلَّ رغبة الشاعر في شرح نفسه بنفسه سببها ضيق كبير من النقاد فهو يريد أن يشرح نفسه: قبل أن يقصني النقاد ويفصِّلوني على هواهم، لا أريد أن أدخل غرفة العمليات، وأسلم جسدي إلى مباضع الناقدين.
وبعد أن حولهم من النقاد إلى الناقدين ينعتهم بالتراجمة والأدلة وأشرطة التسجيل، بل إنه في مكان آخر يشكك في كونهم موجودين!
غير أن إحدى النقاط التي ستكون أحد أبرز محاور الكتاب الداخلية هي العلاقة بين السلطة والشعر، بين زوالية السلطات الزمنية، وبين أبدية الأدب وسلطته اللازمنية. ويشير الشاعر إلى ذلك في المقدمة قائلا “إن سيف الدولة حادث تاريخي. ولهذا فهو قابل للموت. أما المتنبي فهو (حادث شعري) خارج سلطة الموت”. وبذلك يحدد قباني الخطوط بين سلطتين: آنية معتدة بذاتها وسطوتها ولكنها زائلة سيغيبها الفناء، وسلطة أدبية خالدة.
ولعل ظاهرة نزار الأكثر جلاء هي ممارسته لهذه السلطة الأدبية أثناء حياته، ورؤيته بعينين صافيتين عددا هائلا من المشاهد التي تؤكد قدرة هذه السلطة الأدبية على تحدي السلطة الزمنية، وإثبات فاعليتها ونجاعتها وقدرتها على تطويع السلطات التي بيدها العصا والصولجان، وليس العكس.
مفاتيح الجنة
قبل أن يخوض عراكه مع هذه السلطة يقوم قباني بتقديم بيان عن شعره ولغته الذي كان الهدف منه تحقيق حلم أن يكون الشاعر وجدان شعبه. لتحقيق مثل هذا الحلم، يقول قباني إنه كان يحتاج إلى لغة ديمقراطية، لا أثر فيها للغرور والتعالي والتثاقف الكاذب، عن هذه اللغة البعيدة والقريبة، والممكنة والمستحيلة، كان الشاعر يبحث، “وحين عثرت عليها بعد خمسين عاما، يقول قباني، شعرت أنني عثرت على مفاتيح الجنة!”غير أن هذه المفاتيح لا تأتي إلى الشاعر بالحظِّ أو برضى الله والوالدين برأي قباني، والقصيدة الجيدة لا تخرج للشاعر من كيس، ولا تطلع له من أوراق اليانصيب، والمعادلة هي: الموهبة تأتي أولا، والشغل يأتي ثانيا، والثقافة تأتي ثالثا، والمعاناة اليومية تأتي رابعا، والكاريزما الشخصية تأتي خامسا. وبالتالي فلا يمكن لشاعر بليد، أو منطفئ، أو غليظ، أو ثقيل الدم أن يصبح شاعرا كبيرا، ولو ربح كل أوراق اليانصيب في العالم.
على الشاعر حسب قباني أن يذيع منذ البداية بيانه الشعري الأول، ويحدد منهجه، ورؤياه، والدروب التي سيسلكها للوصول إلى المدينة الفاضلة، كما يفعل جميع الانقلابيين ودعاة التغيير، وأن يقدم سيرته الذاتية والشعرية والثقافية مع نماذج من شعره إلى اللجان الشعبية لقراءة الشعر، وهذه اللجان حسب الشاعر موجودة في كل العواصم العربية، وهي دائمة الانعقاد، وقراراتها لا تقبل المراجعة والاستئناف والتمييز.
بعد ذلك يهاجم قباني الحالة الشعرية الحالية واصفا إياها بأنها زفة لا تعرف فيها الداعين من المدعوين، ولا أهل العريس من أهل العروس، ولا كبار الضيوف من الغارسونات، ولا المغني من أفراد الكورس، ولا الراقصة من ضارب الطبلة.
ويعتبر قباني ذلك محاولة لمحو الذاكرة الشعرية، وهي محاولة فاشلة برأيه لأن إلغاء زمن شعري عظيم لا يكون بجرة قلم، ولا أحد يستطيع التباهي بقتل أبيه، إذا لم يكن أفضل منه. وكما لو كان يقدم مثالا للشعراء الجدد في كيفية التعامل مع الشعر يورد نزار الحكاية المشهورة لقصيدته “خبز وحشيش وقمر” التي طالب نائب في البرلمان السوري من جماعة الإخوان المسلمين آنذاك بإحالة الشاعر بسببها إلى لجنة تأديبية، وطرده من وزارة الخارجية السورية، وكيف صفَّق النواب السوريون للقصيدة حين سمعوها من فم النائب الأصولي نفسه.

لوحة: جان حنا
ولعل هذه الحادثة، رغم انتصار السلطة ممثلة برئيس الوزراء التقدُّمي خالد العظم له فيها، هي الأولى التي كشفت لنزار أهمية حاجته إلى الابتعاد عن العمل في مؤسسات الدولة والتفرغ للشعر وحده. الحادثة الثانية التي جعلته يفكر جديا في ترك العمل الدبلوماسي تمثلها حكاية يرويها للقائه في دار القنصلية السورية في لندن عام 1954 بمواطن مغربي يطلب منه ترك العمل الدبلوماسي الروتيني وينشغل بالمهنة الحقيقية التي تناسبه، مهنة الشاعر، وبعد 40 عاما على هذه الحادثة يسدد الشاعر دينه لهذا الرجل الذي نصحه معتبرا أنه حرَّرني من كل السلطات الأبوية والسياسية والقبلية والعشائرية والجاهلية وأرجعني إلى رحم القصيدة.
لا جمارك على الشعر
تحت هذا العنوان يبدأ الشاعر بتسديد دين آخر عليه إلى لبنان الذي جاءه عام 1966، وهو يشير به إلى لقائه المدير العام للجمارك اللبنانية الذي سمح بإدخال أثاث منزل كامل جاء به قباني من إسبانيا، والذي قال له: نحن في لبنان عشاق لشعرك، ولبنان لا يتقاضى رسوما جمركية على الشعر. وفي بيروت، يقول الشاعر، مشيرا إلى إنهائه للازدواجية الكبيرة التي أنهكته بين العمل لما أدعوه العمل لسلطة زمنية، والعمل لسلطة أبدية، هي سلطة الشعر. هذه الازدواجية، حسب قباني استمرت إحدى وعشرين سنة، كنت خلالها ألبس قناعين، وأتكلم بصوتين، وهكذا انفصل التوأم السيامي عن بعضه، وذهب طفل الشعر جنوبا، وذهب طفل الدبلوماسية شمالا. يقول الشاعر حول علاقته ببيروت كرستني شاعرا وعمَّدتني بماء بحرها الأزرق، وأعطتني (دكتوراه) في الشعر لا تزال معلقة في غرفة مكتبي في لندن.
بيروت أعطت أيضا شهادات الدكتوراه في الشعر لشعراء عرب طليعيين كبدر شاكر السياب، ومحمد الماغوط، ويوسف الخال، وعلي أحمد سعيد (أدونيس) ومحمود درويش، وأطلقتهم كالشهب في سماوات الوطن العربي.
وإذا كان قباني قد قرر أن يكون شاعرا في بيروت، فهل يكفي هذا القرار لكي يقف على قدميه في مدينة شاطرة جدا، وتاجرة جدا، ووفية جدا لإرثها الفينيقي؟
بالإشارة إلى التجارة والشطارة يمهد قباني المجال للحديث عن علاقته مع الناشرين اللبنانيين الذين رحبوا به عند قدومه، لكن عندما ازدادت شعبيته وازداد انتشار كتبه وتوزيعها وازداد شحمي ولحمي، أكلوا لحمي وزوَّروا كتبي، على حد قول الشاعر.
وفي توصيف حالة النشر في لبنان يقول قباني إذا استثنينا عشرة بالمئة من الناشرين اللبنانيين ممن يتحلَّون بالشرف والثقافة والقيم العالية، فإن التسعين بالمئة الباقية منهم جزارون محترفون يتعاطون مع الكتاب كما يتعاطى جزار وثني مع قطيع من الأغنام، دون أن يراعي في عملية الذبح أحكام الشريعة الإسلامية أو أي شريعة أخرى، بل إن هؤلاء الناشرين أميون بالوراثة، ومجموعة من الضباع!
وفي المعركة مع هؤلاء المزورين يستخدم الشاعر نفوذه أحيانا مع السلطات الأمنية، ومن ذلك استعانته بقوات الردع العربية عام 1976 لتعاونه ضد مزوِّري كتبه، فقامت القوات بمحاصرة مراكز المزوِّرين ومطابعهم ومستودعاتهم وصادرت أهراما من الكتب المزوَّرة، وأرغمت الفاعلين على دفع جميع حقوق التأليف المسروقة.
ومن معاركه مع المزوِّرين ينتقل قباني للدفاع عن خياره الاستقلالي بالانتماء للشعر، الذي كان يجبر السلطات، (على ما جرى مع قوات الردع) على الدفاع عنه كشاعر ومثقف، وليس كابن للسلطة، ويتمثل ذلك بنقاش خلافي مع الشاعر عمر أبوريشة الذي زار قباني مرة في مكتبه الصغير ولامه على تركه أمجاد السفارات والسلك الدبلوماسي ليقعد في مكتب أصغر من خرم إبرة، وردُّ قباني على أبوريشة كان حادا معتبرا أن المجد الحقيقي هو الشعر، ويصور قباني النتيجة على الشكل الآتي؛ وخرج عمرأبو ريشة بقامته المديدة كقامة الرمح من مكتبي، ولم نلتق مرة أخرى، لأن دروبنا قد تباعدت، وأحلامنا قد تباعدت. هو كان على موعد مع الرئيس نهرو في دلهي لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة، وأنا كنت على موعد مع عمَّال مطبعة (كار الكتب) في بناية العازارية لتصحيح مُسودَاتِ مجموعتي الشعرية الجديدة (الرسم بالكلمات).
وبعد هذه المشاهد المليئة بالعنفوان يعود قباني إلى الحديث عن الشعر وقصيدته الرسم بالكلمات التي تم استخدامها منذ نشرها بطريقة تعسفية تشبه تلاوة (ولا تقربوا الصلاة) ضد نزار قباني، وخصوصا البيت الشعري الذي يقول فيه شهريار على لسانه “فصَّلتُ من جلد النساء عباءة وبنيتُ أهراما من الحَلَمَاتِ”.
كما يعود إلى إزجاء لبنان حقوقه الأدبية عليه متذكرا حادثة جرت عام 1966 حين حوصر بسيارته في منطقة ضهر البيدر تحت عاصفة ثلجية، وكان متجها للموت بالبرد حينما اكتشفه رجال مخفر قريب للدرك قاموا بدفع السيارة عدة كيلومترات تحت العاصفة الثلجية إلى مكان آمن.
ويصف الشاعر مشهدا مليئا بالفانتازيا في مدينة طرابلس المحافظة حيث تطلب فتاة جميلة جدا منه في ندوة مليئة بالناس توقيعه على فخذها، ويصوِّر الشاعر المشهد قائلا: ورفعت تنّورتها إلى الأعلى، أمام جمع غفير من الناس، دون أن يرفَّ لها جفن، أو يرتجف لها عصب، وقفت ذاهلا أمام الأفق الحريري المفتوح أمامي، وبدأت أحفر توقيعي على البرونز المشتعل، كنحَّات محترف يشتغل بإتقان على تمثال جميل (…) انتهت حفلة التوقيع الخرافية وغابت (ساندريلا الطرابلسية) بين أشجار الحديقة، دون أن أعرف من هي، وما هو اسمها، وما هي مؤهلاتها الثقافية.
كل ما أتذكر أنها سيدة جميلة، بدوية الملامح وخارجة على القانون. حادثتان أخريان تظهران السطوة الهائلة لشعر نزار على الجمهور، الأولى تحدث في بلدة النبطية الجنوبية اللبنانية حيث يجتمع الناس في سينما المدينة، وفي مشهد رائع يصف نزار كيف رأى النساء الجنوبيات يشغلن الصفوف الأولى من قاعة السينما، وكلهن تقريبا مرضعات بذلن قصارى جهدهن لدر الحليب في أفواه أطفالهن الرضع، حتى لا يرفعوا أصواتهم خلال إلقاء الشعر، ويحسُّ الشاعر أنه ألقى شعره في أحد مستشفيات الولادة، وأن حليب الشعر قد اختلط بحليب الحياة في مزيج سماوي مقدس. والحادثة الأخرى يصف نزار فيها ندوة أخرى في مدرسة للراهبات في منطقة الأشرفية في بيروت، وبعد أن يقوم باختيار معتدل للقصائد ويلقيها، يفاجأ بالمدرسات يطالبنه بقراءة إحدى أكثر قصائده جرأة وهي قصيدة (حبلى).
ينهي نزار كتابه بوصف لعلاقته مع الغناء والمغنين وخصوصا بمحمد عبدالوهاب، وانتقالته الكبيرة من تلحين أشعار أحمد شوقي إلى تلحين (أيظن) و(ماذا أقول له؟)، ويبين تأثره الكبير بمثال عبدالوهاب الذي يعتبره أحد كبار المثقفين الموسيقيين في العصر الحديث.
***
يقدم نزار في كتابه هذا مشاهد مذهلة تتجادل فيها المعاني ولكنها كلها تظهر اللمسة الذهبية الهائلة للشعر على الناس، على تنوع فئاتهم، من عناصر شرطة في مخفر ناء، إلى امرأة من نساء النبطية المرضعات، إلى راهبات جريئات، وكل هذه المشاهد تؤكد عددا من الأطروحات الأساسية للكتاب: أولها، خلود الشعر وبقاؤه ولازمنيته، مقابل زوال السلطات والحكام. وثانيها، ضرورة التفرغ للشعر، وثالثها، ضرورة الإخلاص للناس، وفي كل ذلك كان نزار قباني مجليا ومعلما ورائدا أساسيا، لأن شعر نزار كان مهرجان سعادة وفرح رغم (كل ما يحتويه من غضب وثورة وألم) كما حياته (رغم الطعنات الهائلة التي لم تستطع كسر روحه). ولأنه كان طاقة عارمة دافعة للحياة والحب، فلن يكون هذا النص تأبينا ولا رثاء بل جزء يعاد إليه من رصيده المحبّ الذي خزّنه لدى قارئي العربية في كل مكان.
ليس المقصود من هذا النص أيضا تصنيم نزار قبّاني- وهو أحد محطمي الأصنام والأفكار التقليدية ومن خلصاء الراغبين في التجديد والابتكار- بل تصويره كما كان في أرض الممكن والمفهوم والمعقول.