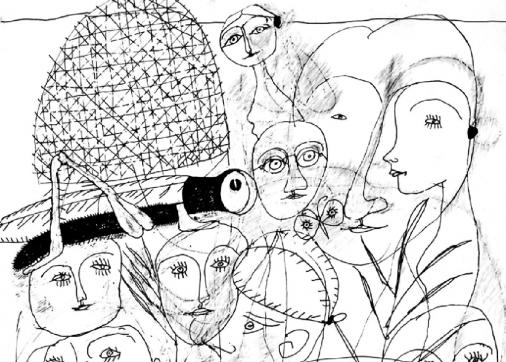العقل الناقد والعقل اللاقط

من المهم لكل قراءة أن تنتبه للسياق العام الذي يتنزل فيه مقروؤها، ونوعية المخاطَب الذي تتوجه إليه، والوسيط الذي يحمِلها إلى هذا المخاطَب، فكلُّ هذه محددات مهمة، كي لا تحمّل مقروءها بأكثر مما يحتمل، وكي لا تطالبه بما لم يهدف إليه، وبذلك يمكنها فهمه واستيعاب مضمراته وإشاراته وإحالاته.
يتكون كتاب “شجرة، وطن، دين”، المنشور في مؤسسة بتانة، القاهرة 2017/، من ستين مقالة نشرت في أكثر من جريدة سيَّارة، بداية من مارس 2015، حتى مايو 2016 وهذا يعني أمرين:
أولا: أننا إزاء مجموعة من المقالات يغلب عليها التنوع، ولكن هذا التنوع لا يصعب ردّه إلى عدة أفكار رئيسية، تدور حولها هذه الكثرة.
ثانيا: أنها تتجه إلى القارئ العام الذي لا يعرف الكثير عن اصطلاحات المتخصصين، أو لا يستسيغها، وقد تكون حاجزا بينه وبين الثقافة والمثقفين عموما، ولذا سنجد ميلا واضحا إلى تبسيط بعض الأفكار وبعض الاصطلاحات التي دارت بكثرة على ألسنة الناس.
وهذا يعني أننا إزاء كتابة حيوية، ذات طابع تداولي، تحملها بنية سردية شيقة، ويمكننا أن نردّ كلّ مقالة إلى سبب ما، كأن يكون موقفا شخصيا، أو فكرة كثر بشأنها الجدال العام، أو حدثا عاما انشغل به الناس بعد الثورة، وما أكثر هذه الأحداث التي احتاجت من الكثير من الكتاب الانخراط فيها وكشف ما وراءها.
وهنا، يبدو أن علينا أن نشير إلى صعوبة الدور الذي يقوم به المثقف في نقد واقع ما بعد الأيديولوجيات الكبرى، ويزداد الأمر صعوبة في عالم معولم، ويتجه إلى المزيد من العولمة، ولا تثبت فيه الأفكار بقدر ما تتحرك، ولا تصحّ بقدر ما تبطل، إلخ. هذه الحالة من الصيرورة والتحوّل والتغيّر أشّرت إلى وعي ثقافي جديد، يعاد به تعريف المثقف، بما يتأكد به البعد التداولي والدور الوظيفي ويتراجع فيه الدور التبشيري والدعوي، لقد فارق المثقف دور الداعية “حارس الأفكار” الكبرى التي يمكنها أن تنتقل من ثقافة إلى أخرى، يدعو إليها باعتبارها الجواب الشافي والحل الكافي الذي سوف يحيل الواقع المتخلف إلى واقع متقدّم بمجرد الإيمان بها.
تؤكد مقالات الكتاب بانخراطها في الهمّ اليوميّ، أنّ كل فكرة صالحة هي بقدر ما تزيل من عتمة الواقع وما تشخِّص من مواجعه؛ فالفكرة هنا وسيلة وليست غاية، وهي منبثقة من الواقع وإشكالاته وليست طارئة عليه، إنها ليست شعارا أو دعوة فوقية يسقطها الكاتب على الواقع، وإنما هي أداة للفهم، تتغير بتغير الواقع، وتتحوّل بتحوّلاته، إنها ليست أقنوما، وعليه فهو لا يدافع عن فكرة ما في المطلق، وإنما يدافع عن قدرة فكرة محددة على حل إشكال “ما”، هنا والآن، داخل هذا الواقع.
ولأن الوضع كذلك، فقد بات على المثقف أن يراجع دوره ويراجع أفكاره، ويراجع رؤيته للواقع والحياة، وهذه المراجعة هي البداية لحل إشكالات الواقع، أي أننا هنا ندعو المثقف إلى أن يتغيّر قبل أن يدعو هو الواقع إلى التغيّر، فـ”المثقف التنويريّ والعقلانيّ والتحرريّ، ليس هو الذي يحيل الأفكار الخصبة التي أنتجت حول التنوير والعقل والحرية إلى مجرّد معلومات يردّدها على شكل محفوظات، وإنما هو الذي يقيم علاقة نقدية مع ذاته وفكره، على نحو يتيح له أن يتحوّل عمّا هو عليه، بإغناء مفاهيمه عن الحرية والعقلانية والاستنارة”. (علي حرب: “أوهام النخبة” ص 13).
*
تهيمن على جميع المقالات فكرة “مبدئية” تعززها فكرة “منهجية” تغزوها وتنسجم معها: أما الفكرة المبدئية فهي أن من حق أيّ إنسان أن يتساءل، بل يجب عليه أن يتساءل، ويجب على الثقافة والتعليم أن يؤكدا على قيمة العقل الناقد في مقابل العقل اللاقط، وأن هذا التساؤل أو هذا الحق يجب أن يطول الخطابات كافة، فلا ممنوع ولا محظور. يتعزز هذا المبدأ بالفكرة المنهجية التي تسعى دائما إلى تحرير مواضع الخلاف، وتبسيط مفردات الإشكال، سواء أكانت أفكارا أم مصطلحاتٍ، إلخ.
ولشرح هذا المستخلص يمكننا أن نقف إزاء عدة مقالات تناقش محورا محددا مثل محور “تجديد الخطاب الديني” أو ما اصطلح عليه كذلك، فقد فرضت هذه القضية نفسها على الجميع سياسيّا وإعلاميّا عقب ثورة يناير، وأخذت حضورا واضحا بعد تبني القيادة السياسية لها، حتى لقد بات صعبا على أي كاتب أن يتأخر عن متابعة هذا المفهوم، خصوصا أنه احتلَّ مساحة مهمة في خارطة البرامج الدينية ومواقع التوصل الاجتماعي، بالإضافة إلى انشغال الكثير من الكتاب والدارسين به.
لا يقدّم الكاتب هنا رأيه في تجديد هذا الخطاب، وإنما يرصد هذه الظواهر التي نتجت عن هذا المفهوم وتلك الممارسة، والفكرة التي يدافع عنها هنا هي حقه في أن يقول رأيه في ما يسمع ويرى، ويدعو غيره إلى أن يقول رأيه كذلك، ومن هنا كانت مقالته التي تفند رأي الحبيب علي الجفري، والتي ذهب فيها إلى أن “الدين علم”، وهذا يعني أن العلم يقتصر على العالمين به، وأن غير العالمين به ليس عليهم إلا الامتثال لهذا الخطاب… يبدو الإشكال هنا في مفهوم العلم نفسه، وهنا يفعّل الكاتب منهجه؛ فيعيد الأمر إلى نقطة البداية، ويتوجه بالسؤال إلى الشيخ الجفري: ما العلم؟ أو ماذا نقصد بالعلم؟ فالعلم وجهة نظر، ولكنها مؤسسة منهجيا، وهي ليست مطلقة، أي أنها نسبية، تقبل باستمرار المراجعة والنقد.. فالعلم إذن ليس كما تصوّر الشيخ الجفري، العلم لا يعني إطلاقا السمع والطاعة لمستخلصاته، وإنما يدعونا باستمرار أو قل يحرّضنا على التفكير والنقد والمراجعة، والمفارقة أن الشيخ الجفري قدّم هذه الحجة (أي أنّ الدين علم) في معرض مناظرته الباحث الإعلامي إسلام بحيري، وقد أراد بها أن يغلق باب الجدل، ولكن المفارقة أنه قد فتح باب الجدل من حيث أراد أن يغلقه.
ولذا فهو يسأل الشيخ “هل تقبل أن نراجع الدين كما نراجع العلم؟”.
ولا يعني هذا أن الكاتب ينحاز إلى كفة إسلام بحيري الذي سيرد ذكره في أكثر من مقالة، والحقيقة أنّ إسلام بحيري شكّل ظاهرة زاعقة في نقد الخطاب الفقهي حول القرآن والسنة… ينتقد وليد علاءالدين ظاهرة بحيري معترضا على طريقته في الأداء وتسفيه خصومه والتقليل منهم… وهذا الاعتراض الشكلي يلتقي عليه الكثير من المتابعين، حتى من أنصار بحيري نفسه، ولكن علاءالدين يضع يده على ملمح نقدي لا يمكنك أن تدركه إلا بالمزيد من التأمل، وهو أن إسلام بحيري يقدّم أفكاره بيقين مبالغ فيه، إنه يضع نفسه في دائرة الحق ويضع غيره في دائرة الباطل، ممّا يجعل خطابه في التحليل الأخير وجها آخر لخطاب الأصولية، وكأن المطلوب منا هو أن نستبدل يقينا بيقين أو أصولية بأصولية أخرى.
من المهمّ أن ننتبه إلى هذا المعنى، ومن المهم أيضا أن نقرأ ظاهرة إسلام بحيري في السياق الثوري الغاضب والميداني الشعاراتي، فشعارات الميادين تلخص المشهد الغاضب والمستنفر، ولك أن تقول المفجوع، في النموذج الذي قدّمه الإسلاميون للدين قبل وصولهم إلى الحكم وأثناء حكمهم وبعد إزاحتهم عنه، لا يمكننا أن نقول إنّ إسلام بحيري قدّم تجديدا للخطاب أو أنّ ما يقدمه هو التجديد، أو لنقل إننا قد نختلف حول ذلك كثيرا… ولكن ما يجب أن نتذكره أو نؤكّد عليه أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ترجع إلى عقود خلت؛ فلدينا توجّه نقديّ فلسفيّ شامل للتجديد، تتوزع أطروحاته في الكثير من دور النشر، قام عليه دارسون كبار أفنوا أعمارهم في الكتابة حول خطاب إسلامي معاصر، منهم من قتل، ومنهم من فصل عن عمله، ومنهم من فُرِّق بينه وبين زوجته، إلخ.
وللمبدأ نفسه -وهو حق المتلقي في ممارسة حريته في انتقاد ما يسمع- ينتقد علاءالدين خطاب الداعية عمرو خالد، لأنه يقدم ما يناوئ هذا الحق؛ وذلك في محاضرة يتحدث فيها عمرو خالد عن فكرة الطاعة وفضيلة الاتباع، مستدلّا على ذلك بحادثة غريبة، انتدب فيها النبيُّ (ص) عليّا بن أبي طالب للقيام بعملية استكشافية تستطلع أمر العدو قبل غزوة معيّنة، وأوصاه قائلا “ولا تولينّهم ظهرك أبدا”، ولكن عليّا يتذكّر أمرا ما، كان يجب أن يسأل النبي عنه، وذلك بعد أن قطع شوطا طويلا في عمق الصحراء، ويقرّر الرجوع، ولكنه يعود ممتطيا ظهر جواده بالمقلوب حتى لا يخالف أمر النبيّ!

لوحة: تسنيم شرف
لا يمكن أن تكون هذه هي الطاعة، ولا يمكن أن تكون القصة حقيقية خاصة وبطلها هو عليّ، العربي الفصيح، واسع العلم بحقيقة الكلام ومجازه ومقصده أيضا. وهنا يتساءل الكاتب: إلى أيّ مدى يمكننا أن ننتقد مثل هذا الكلام الذي لا يعقل على لسان عمرو خالد؟ وإلى أيّ مدى قد يمكننا أن نراجع أقوالا معيّنة لأن فلانا هو الذي قالها؟
يتحدث علاءالدين هنا ببساطة عن خطورة ما تطلق عليه بلاغة الحِجاج بـ”حجة السلطة”، وهي واحدة من مرتكزات الخطاب الديني الوعظيّ بشكل عام، فالكثير من الأقوال تصعب مراجعتها لأنها تستمدّ مكانتها أو قيمتها من انتسابها إلى شخص له مكانة دينية؛ فالكلام لا يستمدّ حِجاجه أو قيمته من ذاته أو من قدرة العقل على فهمه واستيعابه، والمؤكد أن هيمنة “حجة السلطة على خطاب ما تأتي على حساب العقل والمنطق والقدرة على الفهم والنقد، وحين يكون الأمر كذلك، يختلط لدينا القول بالقائل بالقيمة الخلقية التي يدعو لها”، وهذه -فيما يرى- “الخلطة السحرية المثلى لتفريخ التعصب الأعمى الذي يمكن تعريفه في أبسط كلمات بأنه تلك الحالة التي لا يستطيع معها الإنسان التفرقة بين هذه المكونات الثلاثة بالتحديد: الأخلاق والدين الذي ينتمي إليه والأشخاص الذين يمثلون هذه الأخلاق وهذا الدين”. (ص 205)
***
ولأن الموضوعات لا تنتهي يحاول الكاتب باستمرار أن يؤكد على الفكرة المنهجية، فأفرد لها أكثر من مقالة، ولعل أهمّها تلك المقالة التي جعلها عنوانا للكتاب، فقد لاحظ عبر هذه المقالة “شجرة، وطن، دين” أننا لا نتفق حول الكثير من المفاهيم، فنحن نتحدث عن مفاهيم متعددة لدال واحد أو كلمة واحدة، ويمكننا بطبيعة الحال أن نعود بهذه الفكرة إلى سقراط في محاوراته مع السفسطائيين الذين كانوا يؤثرون على الناس عبر هذا التميع النسبي لدلالات المفاهيم؛ فإذا قال السفسطائيون مثلا “الإنسان مقياس الأشياء”، سألهم سقراط “وماذا تعني كلمة إنسان؟” وإذا قالوا “القوة فوق الحق” سألهم “وما الحق؟”.
لقد قام علاءالدين بشيء يشبه ذلك مع طفليه حين سألهما “ماذا تعني كلمة شجرة؟”، وقد كانت إجابة كلا منهما مختلفة رغم أنهما قد عاشا معا تحت ظل بيت واحد، وحصلا معا على تعليم واحد، ورغم أن كلمة شجرة تنتمي إلى حقل المجسدات وليس المجردات!
ويمكنك أن تعمم هذه الفكرة حول الكثير من المفاهيم وعلى رأسها مفهوم كلمة “وطن”، التي يختلف مفهومها لدى عموم المصريين عنه لدى جماعات القتل باسم الله وعلى سنة رسوله، ولذا فهو يتساءل “ما الوطن؟”.
يحتاج المفهوم إلى تحرير بالفعل، ونظرا لأن المقالة كانت تعليقا على حادثة قتل جنود الجيش بالشيخ زويد، ولأن المساحة المخصصة للكتابة لا تحتمل المزيد من النقاش المجرّد، يضع علاءالدين ما يصفه بالقاعدة الأساسية التي لا يجب أن نختلف عليها أو حولها، وهي أن الوطن أوسع من الدين، وأنّ أيّ خلاف سياسي لا يمكن تصفيته أو حسمه على حساب الوطن، ولا يمكن لمن قتل الجنود أن يكون وطنيّا، فالفرق كبير بين الاختلاف حول الوطن والاختلاف مع من يديرون أحوال هذا الوطن.
يؤكد علاءالدين أنه بهذا لا يحتكر الوطنية، وإنما يحرّر المفهوم، أو الإطار المنطقي والعقلاني “الذي لا يجوز لمن فقدها أن يظل في جبهة الوطن”. (ص80)
وطبقا لهذه الفكرة تأتي عدة مقالات، لعل أبرزها مقالة “للكبار فقط” وفيها يناقش الجدل الذي أعقب نشر فصلٍ من رواية أحمد ناجي بمجلة أخبار الأدب، وانتهى بتقديمه للمحاكمة ومعه رئيس التحرير، لقد بدا الخلاف واسعا بين من يؤمنون بحرية التعبير ومن يرون أن المجلة أخطأت بنشر مادة قدمت الجنس على نحو صريح، وأنّ محاكمة ناجي أمر طبيعي في هذا السياق… يقدّم علاءالدين هنا حلا لهذا الخلاف، فطبيعة المجلة أو سياستها لا تشير من قريب أو بعيد إلى عنايتها بنشر مثل هذا النوع من المواد، ومن حق القارئ أن يكون على علم بذلك، أي أن المجلة فاجأت القارئ بما لم يتوقعه، وهنا يشير علاءالدين إلى أن أصل المشكلة، ليس ما كتبه ناجي أو ما نشرته المجلة، وإنما غياب الإطار التنظيمي الذي يشكل اتفاقا مبدئيا بين المطبوعة وقرائها، وهذا الإطار تعرفه الكثير من الدول المتقدمة، حين يشيرون إلى أن هذه المادة مثلا لا يجب أن يشاهدها من هم دون العاشرة، أو دون السن القانونية، إلخ.
لا يقف وليد علاءالدين مع ناجي أو ضدّه، ولكنه يفكر في إطار ينظم هذه الحرية، بما يجعل المتلقي على معرفة مسبقة بما سوف يشتريه، وبما يجعل الكاتب على معرفة مسبقة بسياسة الوسيلة التي ينشر فيها، فغياب هذا الإطار عن ثقافتنا كان سبب أزمة المجلة والروائي والقراء جميعا.
***
إذن لم يكن لهذه المقالات من همّ غير انشغالها بتحرير المفاهيم ذات الطبيعة الخلافية، ودعوتها إلى تأكيد قيمة العقل الناقد المبدع الذي يمكنه أن يقبل ويرفض ويقدّم أدلة لأسباب رفضه أو أسباب قبوله، وإذا لم يكن لها غير تأكيد هاتين الفكرتين لكفاها لتكون جديرة بالقراءة والنقاش.