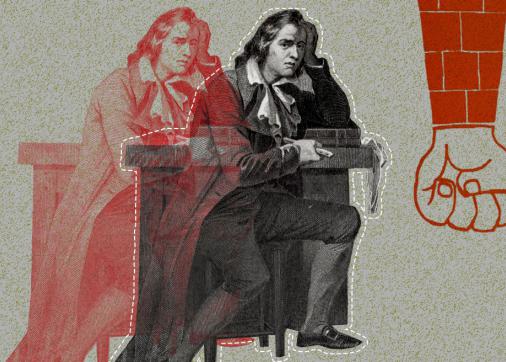الأصولية الجمهورية الجديدة
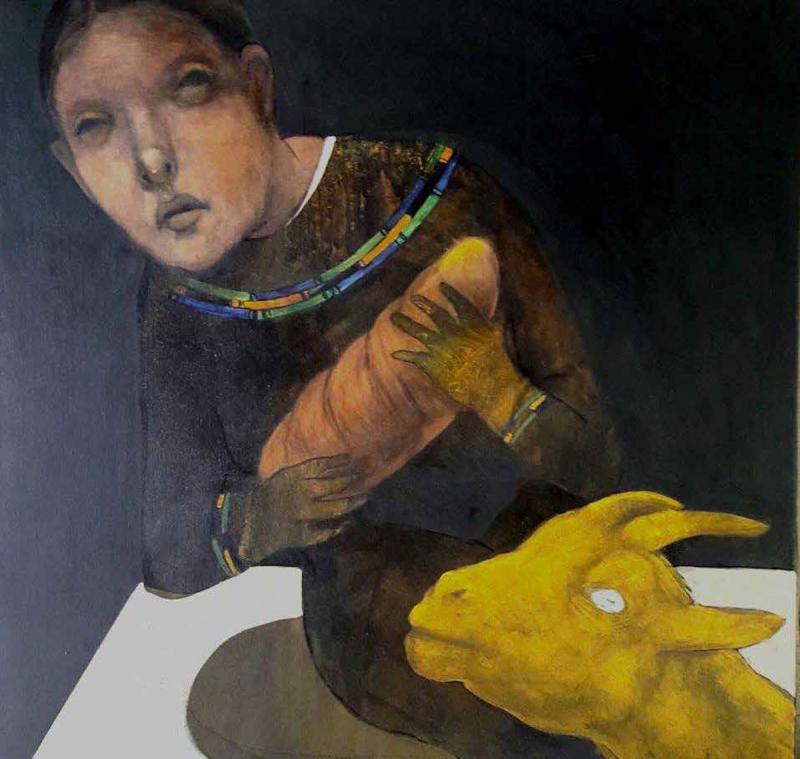
جديد المفكّر الفرنسيّ جان فابيان سبيتس كتاب بعنوان "الجمهوريّة، أيّ قِيَم؟" يطرح فيه انحراف الفكر الجمهوريّ في فرنسا عن مبادئه التأسيسيّة، من خلال التركيز الشوفيني على قضايا الهويّة، والتنكر للجمهوريّة نفسها التي كانت بالأساس مبدأ للعدالة الاجتماعيّة.
في هذا الكتاب يصف جان فابيان سبـيتس بدقّة آلية انحراف المعاني المرتبطة بالمفاهيم التي قام عليها المشروع الجمهوري في بداياته، ويعرض ما تتطلّبه جمهورية تظلّ وفية لهدفها في التحرر. على امتداد فصول الكتاب الثمانية، التي تجمع بين العمق المعرفي والوضوح، يرسم المؤلف ملامح مجتمع يطيب فيه العيش، بالعودة إلى المبادئ الأساسيّة للجمهورية، عملا بمقولة ألان سوبيو: إنّ إعادة المعنى للكلمات هو الخطوة الأولى الضرورية لاستعادة السيطرة على المستقبل"، ويعرّي زيف النيوليبراليّة، التي لا تعني في الواقع تقليص دور الدولة فحسب، وإنّما أيضًا استخدام الدولة لضمان منطق السوق وقمع المطالب الاجتماعية، فالدولة تُوظَّف لحماية حقوق الملكية ضد الحقوق الاجتماعية، ويتم تحييد القضايا الجوهرية كالفقر والسكن والتعليم والعمل... إلخ.
لفهم ذلك التحالف القائم بين الجمهورية والنيوليبرالية، من الضروري العودة إلى العلاقة التي يُفترض أنها طبيعية بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية، إلّا أنّ الواقع غير ذلك، ماضيًا وحاضرًا؛ فالليبرالية السياسية تقوم على حماية الحريات الفردية، والتعبير عن الحقوق السياسية، والتعددية، والتوازن المتبادل بين السلطات، في حين أنّ الليبرالية الاقتصادية ترى في تنظيم السوق الأفق الأقصى لنظام حرّ. هذا الارتباط الضروري بين اقتصاد السوق والليبرالية السياسية هو ما ينبغي تفكيكه بغرض استعادة الموارد الفكرية للفلسفة الليبرالية. وقد اعتمد سبـيتس في ذلك على فكر آدم سميث، الذي رأى أن "حرية السوق، قبل أن تكون عامل رخاء متزايد، كانت أداةً لتحرّر الأفراد، وشكلاً من أشكال التنظيم الاجتماعي يتيح لهم التخلص من التبعيات الشخصية، وتحريرهم من كل علاقة قسرية يفرضها مزوِّد أو مقدّم خدمات أو ربّ عمل أو محتكر. لقد كانت السوق حينئذ قادرة على تعزيز الحرية، واستقلالية الأفراد.
غير أنّ الشروط الاجتماعية التي جعلت من السوق عامل تحرّر لم تعد قائمة: فنحن نواجه اليوم تركيزًا مفرطًا للملكية، وتصنيعًا شاملاً، وتعميمًا لعلاقات التوظيف المأجور، وتمويلًا واسع النطاق للاقتصاد. ومن ثَمّ، باتت حرية الأفراد تستلزم تحرّرهم من الضغوط التي تولّدها السوق في مجال الوصول إلى الضروريات التي تضمن الاستقلالية: التعليم، الصحة، السكن، العمل، التقاعد... والنيوليبرالية لا تستجيب لتلك المطالب، إذ أصبح الفاعلون الاقتصاديون متفاوتين على نحو حوّل علاقاتهم إلى أشكال من الهيمنة؛ وذلك نتيجة انحرافٍ مصدرُه تقديسُ حق الملكية عند فريدريش هايك والليبرتاريين. وهذا التقديس، في جوهره، أدّى إلى إخضاع الحقوق الاجتماعية لمبدأ احترام الملكية، في حين أنّ مؤسسي الليبرالية كانوا "يعتبرون أن تمكين جميع النّاس من الوصول إلى الوسائل المادية للحرية شرطٌ لشرعية التملّك الخاص للموارد الطبيعية".
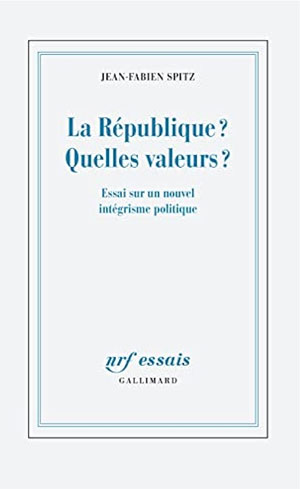
ذلك المبدأ أهمله المتشددون الجمهوريون، الذين شرعوا، منذ ثمانينيات القرن الماضي، في تفكيك المؤسسات الاجتماعية، ولا سيما تلك التي تضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة، تلك التي تميل إلى التواكل، باسم الحفاظ على الحريات المدنية. في الغالب. إلا أن تفكيك الدولة الاجتماعية زاد الفوارق حدّةً، وأدّى إلى انقسامات تغذّي العنف، نجم عنها قمع ما الحريات المدنية. ومن ثَمّ صارت الليبرالية سلطوية بعبارة هيرمان هيلر، تدير ظهرها لمبادئها التأسيسية، إذ جعلت من اقتصاد السوق المصدر الوحيد للحرية والازدهار، ومن القانون المدني نظامًا يكرّس إخضاع مصالح الأضعف لمصالح الأقوى؛ وباتت مهمّة الدولة أن تضمن المنافسة، وأن تنتج الشروط الأخلاقية والاجتماعية لإمكان قيام تلك المنافسة.
أمام ذلك التوتر القائم بين الرأسمالية والديمقراطية، ثمة مخرجان ممكنان: إما أن نعتبر أن الرأسمالية تُهدّد الديمقراطية من خلال تمركز الملكية وتفاقم التفاوت، وإما العكس، كما تذهب إلى ذلك النخب الأوروبية والأمريكية. وهو موقف لا يخلو من عواقب وخيمة، في نظر سبيتس، كالتجاوز المتكرّر لنتائج الاستفتاءات المناهضة للمعاهدات الأوروبية، أو تصاعد امتناع فئات واسعة من الطبقات الشعبية عن التصويت. والسبب أن الرأسمالية غير المنظَّمة ميّالة بطبيعتها إلى السلطوية، تسعى دومًا إلى حماية نفسها من نزوع الديمقراطية إلى تقييدها. ومن ثم، فإن القضايا الجوهرية التي تتعلّق بمستقبل المجتمع، كالتّفاوت، وهشاشة ظروف العيش، وغيتوهات ضواحي المدن الكبرى، وصعوبة الوصول إلى التعليم والعمل والسكن، تُقصى منهجيّا، بل قد تُطرد أحيانًا من دائرة النقاش العامّ. أما المشروع النيوليبرالي، فهو يرمي إلى إخضاع الدولة القومية لمنافسة اقتصاد عالمي يحرس حقوق الملكية بصرامة، ممّا يؤدّي بالضرورة إلى الحدّ من الحقوق السياسية.
فما هي الأسس التي يُبرّر بها هذا المشروع نفسه؟ يُشدّد سبـيتس على مسألة استبدال المبادئ بالقيم في خطاب المتشددين باسم الجمهورية، فـالمبادئ هي قواعد يُدعى المواطنون إلى مطابقة سلوكهم معها، أما القيم فهي مقولات أخلاقية يمكن للمرء أن يوافق عليها أو يرفضها. وهذا الاستبدال يُظهر بجلاء السمة التي تميّز التشدّد الجمهوري: تحويل النقاش العام إلى قضايا الهوية بدلًا من علاقات الهيمنة، فتغدو الفكرة التي يُفترض أنها "جمهورية" أداة فكرية لحماية نمط من المجتمع ينقلب على فكرة الجمهورية نفسها، وعلى الديمقراطية السياسية، وعلى المساواة الاجتماعية، ويتجلى ذلك في الكيفية التي تُعامَل بها المبادئ التأسيسية.
أمّا الحرية، فإنها تصبح، إذا ما تمّ إخضاعها للسوق واحتياجاتها، حرية زائفة، سلطوية، مناهضة للديمقراطية، معادية للعدالة الاجتماعية، كما أوضحت ويندي براون، حيث "تعتبَر كل السياسات الاجتماعية الهادفة إلى حماية فئات معيّنة من الهيمنة انتهاكًا للحرية، ومبدأ حياد القانون وكونيته". وهو تصوّر ينفي أن تكون للمجتمع مسؤولية بنيوية عن وجود علاقات القوة والتبعية المتجذّرة في مؤسساته، قانون العمل، أو قانون الأسرة. أمّا الحقوق الخاصة التي تسمح للمحرومين من الملكية بكبح أشكال السيطرة، فإنّها ترفض باسم تصوّر مشوَّه للحرية، يرى أن الدولة الاجتماعية تتعارض مع الحرية الفردية. والكاتب يؤكّد أننا لا يمكن أن نكون أحرارًا ما لم يكن لنا بوسعنا الوصول إلى ما يضمن استقلاليتنا.
كثيرًا ما قيل إنّ الحرية لا تتلاءم مع المساواة، وإنّ الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق قدر من المساواة في الاستقلالية هي انتهاك لحقوق الأفراد، وخصوصًا حق الملكية، وحقّ التصرف في ما نملكه كما نشاء. وكان الفيلسوف الأمريكي رونالد دوركين قد فنّد ذلك الادعاء، إذ أكّد ضرورة بناء نظرية معقولة تُراعي جميع القيم السياسية الجوهرية: الديمقراطية، والحرية، والمجتمع المدني، وكذلك المساواة؛ وبيّن أن كل قيمة من تلك القيم تنبع من الأخريات وتعكسها في الوقت ذاته. وكانت تلك المقاربة تريد أن تُبرهن، على سبيل المثال، أن المساواة لا تتوافق فقط مع الحرية، بل إنها تمثّل قيمة لا بد أن يعتزّ بها كل من يعتزّ بالحرية، فهي في نظر سبيتس جوهر الليبرالية السياسية، ولكن يُساء إليها حين يجعل المتشددون الجمهوريون من العلمانية قيمة هوويّة. وهنا يستحضر الكاتب أعمال جان بوبيرو، لفهم طبيعة التحوّل الذي أحدثه، منذ ثلاثين عامًا تقريبًا، أولئك الذين أهملوا الطابع الليبرالي العميق لقانون 1905 (فصل الدين عن السياسة)، ومسخوا العلمانية الفرنسية، تأثرا بالليبرالية الأنغلوساكسونية، متناسين نقائصها الجوهرية، ولا سيما استبعاد الأجانب والمقيمين والعبيد والنساء، سيرا على منوال المدينة الإغريقية التي بقيت منغلقة، أسيرة تصور إثنيّ للانتماء.
في هذا التصوّر المُحرَّف، تُقدَّم العلمانية على أنها قيمة تراثية متجذّرة في تاريخ فرنسا،
وبالتالي، يُنظَر إلى الإسلام على أنه غريب عن هذا التاريخ، متّهم بالتمرّد على مبادئ الجمهورية، كما نبّهت إلى ذلك دانييل سالناف: "عندما نقرأ في بيان ”الربيع الجمهوري“ تمجيد الأمة والكونية والعلمانية، يتّضح لنا أن ذلك يثار في إطار معركة لا يُسمّى فيه العدو صراحة، لكن كل شيء يوحي بأن الإسلام والمسلمين هم المستهدَفون."
ومع ذلك، فإن التسامح، الذي يهاجمه المتشددون الجمهوريون باستمرار، لا يتعارض إطلاقًا مع مبدأ العلمانية. وإن كان لا يمنح الحضور لكل الأفكار، فإنه يُقرّ بحقّ المدافع عنها في أن يجد أذنا صاغية، بوصفه مواطنًا وليس معتنق رؤيةٍ لا تتسامح مع الآخرين؛ لأن "تبنّي أي موقف آخر سيجعلنا ندخل في علاقة عداء مع مواطنينا، سواء أكانوا أصدقاء أم خصومًا" على حدّ قول سبيتس. ففي رأيه أن المتشددين الجمهوريين، الذين يصفهم بالأصوليين الجدد، يُعرّضون السلم الأهلية لخطر جسيم حين يزعمون أن الإسلام يشكّل تهديدًا لـ"الهوية الفرنسية". فالـ"قيم الجمهورية" التي ينادون بها تُسهم في تحريف المعنى الحقيقي للمفاهيم. وهو تزوير يرى الكاتب سبـيتس أن فضحه بات أمرًا ملحًّا.
في هذا العمل التحليلي الدقيق، يقدّم جان فابيان سبـيتس نقدًا عميقًا لانحراف الفكرة الجمهورية في فرنسا، حيث يكشف كيف تحوّل ما يُسمّى بـ"الجمهورية" إلى غطاء أيديولوجي يُخفي مشروعًا نيوليبراليًا سلطويًا. فبدل أن تكون الجمهورية مشروعًا للعدالة والمساواة والتحرّر، أصبحت أداة لفرض الهيمنة الاقتصادية وتبرير الإقصاء الثقافي والاجتماعي، خاصة ضدّ المسلمين باسم "قيم الجمهورية".
ويركّز سبـيتس على التمييز الحاسم بين المبادئ والقيم، محذرًا من التلاعب بالمفاهيم، حيث تحوّلت العلمانية إلى قيمة هوياتية، تُستخدم ضد فئات بعينها، وتُفرَغ من مضمونها التحرّري؛ كما يكشف كيف تُستغل الدولة، لا لتقليص دورها كما يدّعي النيوليبراليون، بل لضمان منطق السوق ومنع تدخل الديمقراطية في ضبط علاقات القوة.