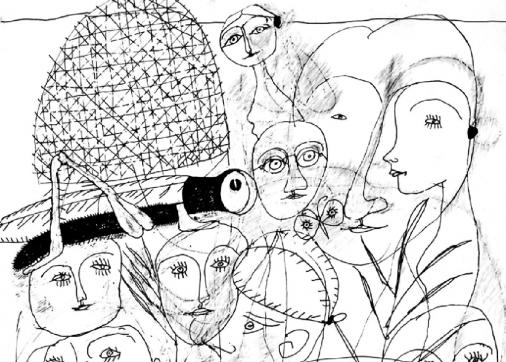اللغة والمعرفة والقيد الصدئ للحرية

تعنى هذه المقاربة بإلقاء ما يمكن إلقاؤه من ضوء على “طبيعة اللغة” واشتمالها على اللسان، أو الكلام والحكي والقول والخطاب والرسالة والكتابة والقراءة أو التأويل.. إلخ، على أنها، أي اللغة، انفصاح الذات الإنسانية، ذات الفرد/الجماعة/المجتمع، وانبساطها في العالم وفي التاريخ، وعلى أنها الشكل الأعلى من أشكال تملك الإنسان لعالمه، على اعتبار أن التملُّك فعل إرادة، لا تكون إلا حرة. وتهتم، من ثمة، بتبيُّن وحدة المعرفة واللغة والحرية، مقابل وحدة المعرفة واللغة والسلطة، انطلاقاً من واقع اللغة العربية وإمكانات نموها وتطورها في أفق العصر.
المقابلة بين وحدة المعرفة واللغة والحرية وبين وحدة المعرفة واللغة والسلطة هي مقابلة بين الواقع والممكن، في مكان وزمان محددين، تكشف عن جذور الاغتراب في الطبيعة والدين والسلطة، وعن جذور التسلط والاستبداد الضاربة في الأعماق المبهمة للمعرفة-اللغة، وقد صارت مركباً رمزياً فائق التعقيد، يسمى تراثاً ثقافياً أو حضارياً، يلقي بكل ثقله على الحياة الإنسانية. إن كل ما يقيد الإنسان يقيد المعرفة، يقيد اللغة، سواء كانت القيود داخلية أم خارجية، ذاتية أم موضوعية. فلا يسوّغ، في نظرنا، البحث في أحوال اللغة بمعزل عن أحوال من يتكلمونها. نشير هنا إلى أن النقص الخطير في تحليل أوضاع مجتمعنا ناجم عن إهمال التأثير الحاسم للبنى المعرفية-اللغوية في هذه الأوضاع وإعادة إنتاجها، من خلال مؤسسات التربية والتعليم والتلقين الأيديولوجي وأنظمتها المغلقة.
اللغة انبثاق[1] المعرفة من القوة إلى الفعل، أو من الإمكان إلى الوجود؛ وترجمة ديناميكية مستمرة للمعلومات الجينية الخاصة بالإدراك والنطق ونشاط الحواس، في الشفرة الوراثية للفرد، ذكراً وأنثى، إلى طاقة حيوية ونشاط دماغي وقدرات نفسية وذهنية وجسدية، لا ينفصل هذا النشاط عن نشاط سائر الجسد. ولكن هذه الترجمة محكومة بالبيئة الطبيعية والاجتماعية، لا العكس. فلغة التعبير بوجه عام، ولغة الكلام والكتابة بوجه خاص سجلّ يبيّن سيرورة تشكل الذوات الإنسانية، وفقاً لعلاقاتها المتنوعة بمواضيع فاعليتها وعملها من جهة، وعلاقاتها المتنوعة بالأخريات والآخرين وأشكال انفعالها واستجاباتها، من الجهة المقابلة، وسجلّ رغباتها وأحلامها وأشواقها وأذواقها.. وقدرة كل منها على تأسيس ذاتها وتحقيقها في الزمان والمكان، يصعب فرز ما هو شخصي في هذا السجلّ عمّا هو إنساني واجتماعي.
فاللغة ذوق وتذوق أيضاً، فإن تأسيس الذات والسعي إلى تحقيقها وتمكينها هما مما يستدعي سائر العلاقات المشار إليها؛ فالتبادل والتواصل، على سبيل المثال وسيلتان لتأسيس الذات وتحقيقها إنسانياً واجتماعياً، لا العكس.
ذهب تشومسكي والتوليديون إلى أن “دراسة اللغة يجب أن تقوم على دراسة العقل الإنساني”[2]، لأن عمليات اكتساب اللغة وإدراك رموزها وعلاماتها واستعمالها كلها عمليات عقلية-نفسية، مما يعيّن علاقة وثيقة بين علم اللغة وعلم النفس المعرفي، تبين الطبيعة الفكرية للغة والطبيعة اللغوية للفكر، وتبين أثر اللغة في تشكُّل الذات وتكوُّن الشخصية، على أن تفهم اللغة هنا بمعناها الواسع، الذي يشتمل على النطق أو الكلام، وقد غدا موضوعاً للسانيات الحديثة.
ولعل دراسة الحالات الخاصة، كحالات المكفوفين والصم والبكم ومن يعانون من “عيوب الكلام”، كالحبسة والتأتأة واللجلجة واللعثمة.. تساعد في فهم اللغة بصفتها تفكيراً متعيناً، وأثر الصفات الفردية والعامة لمن يتكلمونها أو يتكلمنها في إنتاج الرموز والإشارات والعلامات، وفي عمليات تفسيرها وتأويلها، أو في ما يسمى “فك الترميز″.
الكلام عمل واللغة حدوده؛ الكلام سلوك واللغة معاييره؛ الكلام نشاط واللغة قواعده؛ الكلام حركة واللغة نظامها؛ الكلام يُحس، ويُدرك، ويُفهم، ويُعقل؛ الكلام فردي، ولكن اللغة اجتماعية، لأن المتكلم/ــة والسامع/ـــة طرفا هذا النشاط الإنساني[3]، وكذلك الكاتب/ـة والقارئ/ــة.
الاجتماعي لا يكون بغير الفردي. وعلى المنوال نفسه: المعرفة فردية والعقل فردي، ولكن الثقافة اجتماعية، والاجتماعي لا يكون بغير الفردي. العلاقة بين الكلام اللغة وبين المعرفة والثقافة هي ذاتها العلاقة بين الفردي والاجتماعي؛ الاجتماعي حد لا بد من تجاوزه، من أجل حد جديد، وقيد لا بد من كسره، من أجل قيد جديد.. تلكم هي نسبية المعرفة-اللغة ونسبية الحرية. القطعية اليقينية في المعرفة ملازمة للركود في المجتمع والاستبداد في السياسة.
نلفت النظر إلى أن ما يقال عن ذكورية اللغة الفصحى وذكورية علوم اللغة، القديمة ومنها والحديثة أيضاً، وذكورية العلم عامة، ليست شيئاً آخر غير ذكورية السلطة المركزية
لذلك، نتحرز أشد التحرز من اعتبار اللغة أداة أو وسيلة، سواء للتواصل والتعارف والتبادل والتثاقف والتخاطب والتبليغ.. أو للتعبير والوصف والتسجيل والتقرير والإبداع الأدبي والفني والجمالي، أو اعتبارها آلة للعقل والمنطق، أو أداة للسلطة ووسيلة من وسائلها. فهي من حيث مستوياتها الصوتية والتركيبية والدلالية سلطة بذاتها، هي سلطة المعرفة، تتضمن رؤية للعالم، لا “أداة سلطة وتسلط على النفوس والعقول، أو أداة سَوْس وسياسة”[4]. فإن اعتبار اللغة أداة أو وسيلة لا يستبعد اعتبار الإنسان نفسه أداة ووسيلة، على نحو ما تنظر السلطات المستبدة إلى رعاياها، وعلى نحو ما تعاملهم.
هذا يقتضي التفريق بين سلطة المعرفة وبين معرفة السلطة، أي المعرفة التي تتوسل بها السلطة للهيمنة على النفوس والعقول والضمائر وعلى الأجساد أيضاً. “معرفة السلطة” هذه هي أداة السَّوْس والسياسة والتسلط، ولها لغتها الخاصة في كل زمان ومكان. نستدل على ذلك بنشوء “اللغات القومية”، في العصر الحديث، واقترانها بالثورة الديمقراطية، في “الغرب”. كما نستدل عليها بتشكُّل اللغة العربية الفصحى، لغة قريش، واقترانها بالسلطتين: السياسية والدينية، وبالمركزية الإثنية-الذكورية والمركزية السياسية، وتشكل ثقافة مركزية تنبذ كل ما عداها إلى الهامش، لذلك لا تنفك جدلية المعرفة والسلطة ولا تنفصل عن جدلية المتن والهامش وآليات الاصطفاء الاجتماعي-السياسي، ولا عن جدلية الثقافة “الرفيعة” الموسومة بالكتابة والثقافة الشفوية، أو ثقافة العامة والدهماء والرعاع.. أو بين الثقافة المكرسة والثقافة غير المكرَّسة واللغة المكرسة واللغة غير المكرَّسة.
نلفت النظر إلى أن ما يقال عن ذكورية اللغة الفصحى وذكورية علوم اللغة، القديمة ومنها والحديثة أيضاً، وذكورية العلم عامة، ليست شيئاً آخر غير ذكورية السلطة المركزية وذكورية الثقافة المركزية. اللغة ليست موضوعاً محايداً للعلم، بل هي ذات وحياة. فمن العبث التفكير في لغة أنثوية مقابل لغة ذكورية، أو لغة الهامش مقابل لغة المتن، بدلاً من التفكير في كسر احتكار السلطة واحتكار الثقافة، ونقد جميع أشكال المركزية، في سبيل أنسنة اللغة وأنسنة الثقافة، والخروج من الدَّوْر أو الحلقة المفرغة في ما يسمى تناقض الذكورة والأنوثة. مسألة اللغة هنا هي مسألة الإنسان ومسألة المجتمع، ومسألة تحولات ديمقراطية يصعب الرجوع عنها.
اللغة نشاط إنساني وطاقة حيوية إنسانية الخصائص والسمات، هي شكل المعرفة ومضمونها وعلة نسبيتها؛ المعرفة لغة واللغة معرفة، كل منهما شرط إمكان الأخرى وشرط وجودها، فلا تكون إحداهما من غير الأخرى. ومن ثمة، يمكن النظر إلى اللغة والسلطة من الزاوية نفسها التي ننظر منها إلى المعرفة والسلطة. فليس استقلال اللغة النسبي، الظاهر[5]، عن المعرفة سوى استقلال السلطة النسبي والظاهر عنها، أي عن المعرفة؛ بل إن هذا الاستقلال لا يزيد على كونه فاصلاً بين المنطوق وغير المنطوق أو الملفوظ وغير الملفوظ، وبين المبنيّ وغير المبنيّ، وهو فاصل يشبه الفاصل بين الوعي واللاوعي، وبين العقل واللاعقل.
قد يستهجن بعضنا وجود علاقة وثيقة بين قواعد السلطة ومبادئ الحكم وبين البنى المعرفية-اللغوية. ونكاد نجزم بأن أيّ تحسن ذي شأن في الأولى يستتبع تحسناً ذا شأن في الثانية وبالعكس
فلا يمكن فصل ما يسميه ميشيل فوكو “ميكروفيزياء السلطة”، أي علاقات القوة الأولية، التي تنشأ من العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات، ونقاطها المبثوثة في الجسم الاجتماعي، عن جنيالوجيا المعرفة، أي المبادئ الأولية التي تشكل أنماط التفكير ومنظومات القيم، بالتلازم الضروري بين هذه وتلك؛ إذ السلطة معرفة مموضعة، معرفة لا تتحدد بطبيعة موضوعها فقط، بل بإرادة السيطرة عليه أيضاً. هذه الإرادة، إرادة السيطرة، أو إرادة السلطة أو “إرادة القوة”، ولا فرق، مكنونة في المعرفة-اللغة، وتنبثق منها، فتستقل عنها، لكي تعيد إنتاجها وإنتاج ذاتها فيها. العلاقة المركبة بين المعرفة والسلطة هي بالضبط العلاقة المركبة بين الحرية والضرورة؛ الضرورة مكنونة في الحرية وتنبثق منها، فتستقل عنها لكي تعيد إنتاجها وإنتاج ذاتها فيها مرة تلو مرة. نفترض هنا أن ثمّة علاقة شديدة التركيب والتعقيد بين الحرية والمعرفة-اللغة.
المعرفة-اللغة شرط إمكان الحرية الإنسانية وشرط تعيُّنها أو تحققها؛ والحرية سلب لهذين الإمكان والتعيُّن. تحقق المعرفة هو نفيها، وتحقق الحرية هو نفيها، ذلكم هو جوهر التراجيديا الإنسانية، وما يضع نسبية المعرفة ونسبية الحرية، وما جعل اللغة تناوباً بين الإثبات والنفي، إذ كل إثبات هو نفي، و”كل تعيُّن هو سلب”، حسب إسبينوزا. فلا تتبين علاقة المعرفة بالسلطة بتمامها إلا بالنظر إليها على أنها علاقة إيجاب وعلاقة سلب في الوقت نفسه. أشرنا إلى سلب الوجود، ولكن ماذا عن سلب الإمكان؟ كل كائن ناتج وصائر، ولكن ليس كل ممكن قابلاً لأن يكون. كل ممكن هو سلب لممكن آخر.. إلى ما لا حصر له من ممكنات، وبهذا فقط يكون التاريخ توقيعاً لممكنات على حساب ممكنات أخرى. وهذ الأخيرة لا تنعدم، هكذا ببساطة، بل تتحول إلى حدّ على الكائن وحدّ على الكون (مصدر الفعل كان).
إذا صح أن الكلام فردي واللغة اجتماعية وأن المعرفة فردية والثقافة اجتماعية، فاللغة ليست مستودع الحقيقة؛ والحقيقة ليست غاية اللغة، وليست، من ثمة، غاية المعرفة. وإذ لا مفر من الاعتراف بأن الإنسان كائن غائي، فإن غاية المعرفة وغاية اللغة، بل غاية المعرفة-اللغة هي الحياة الإنسانية في حدود الوجود الإنساني، ليس غير. المعرفة-اللغة، التي تزعم أنها مستودع الحقيقة هي الأيديولوجيا فقط، وهذه، أي الأيديولوجيا، ملازمة للسلطة، ولعلها شرط إمكانها، بقدر ما تسوّغ التفاوت، وتمنحه قيماً اجتماعية وأخلاقية، وتضفي عليه هالة من القداسة. نشير هنا إلى معرفة المقدس والمدنس، ولغة المقدس والمدنس، وإلى المعرفة المقدسة واللغة المقدسة. التقديس والتدنيس عنصران في الشعور، لا يقتصران على الشعور الديني، إذ ثمة مقدسات ومدنسات مدنية، كالوطنية والسيادة.. لا تقل دهاء عن المقدسات والمدنسات الدينية.
القول بأن المعرفة تنتج السلطة (قل الحرية تنتج الضرورة) هو نصف الحقيقة، نصفها الآخر: المعرفة تعمل على تفكيك السلطة وتفسيخها من داخلها ومن خارجها، لكي تعيد إنتاجها من جديد؛ إذ كل سلطة تولّد مقاومة ابتداء من لحظة تحققها، لأن تحققها هو نفيها. (قل الحرية تعمل على تفكيك الضرورة وتفسيخها من داخلها ومن خارجها، لكي تعيد إنتاجها من جديد، لأن كل تحقق هو نفي وكل تعين هو سلب). هذه العملية التناقضية الجارية بلا توقف تتيسر ملاحظتها على المستوي الميكروي، حيث تجري عملية “صناعة التاريخ” أكثر مما تتيسر على المستوى الماكروي، الذي يبدي أو يمكن أن يبدي نوعاً من الاستقرار و”الثبات”، ولكنه استقرار وهمي أو ثبات وهمي. التغيير الاجتماعي السياسي والثقافي الجذري لا يكون كذلك إذا لم ينطلق من هذا المستوى المايكروي أو الصّغري. من هنا تأتي ضرورة العناية بالنظام التربوي والتعليمي وأنسنته وعلمنته ودمقرطته مدخلاً إلى التغيير الاجتماعي. واللغة في صلب هذه العملية التاريخية، فلا بد من أنسنتها وعلمنتها ودمقرطتها.
المعرفة تنتج السلطة، ثم تعيد السلطة إنتاجها، وتحدّد حقولها، وتتحكم في توزيع حصادها ومحصولها وثمارها. “السلطة والمعرفة تقتضي كل منهما الأخرى، فلا توجد سلطة من دون تأسيس مناسب لحقل معرفة، ولا توجد معرفة لا تفترض ولا تقيم علاقات سلطة”[6]، خطابية وغير خطابية، كالمؤسسات، التي هي تعيُّنات أو تموضعات للمعرفة-السلطة في تواشجهما واشتباكهما وتحولاتهما التاريخية، ورموز للواقع، هي ذاتها عناصر الواقع متمفصلة على محاوره ونصوصه ووقائعه؛ تختزن في بنيتها وأنظمتها دلالات اجتماعية-اقتصادية وثقافية وسياسية وقانونية وأخلاقية تاريخية، تتعدى آليات عملها وشروط كفايتها وقدرتها على القيام بوظائفها، وإن تكن هذه غير مستقلة عن تلك الدلالات. المؤسسات عامة هي الحقول التي تتعين فيها وحدة الحياة الخاصة للأفراد وحياتهم (النوعية) العامة، أو وحدة الفرد والنوع؛ واللغة هي التعبير الأشد وضوحاً عن هذه الوحدة الجدلية.
فاللغة، وهذه الحال، خروج الذات من عتمة التكوين داخل شرنقتها الذاتية، إلى العالم، لكي تصير موضوعية، أو لكي تتموضع وتفض جميع خصائصها فيه، وتعمل من ثمة على استكشافه وتعرفه وتعرف ذاتها فيه. والعالم هنا ليس العالم الطبيعي، بل العالم الاجتماعي-الاقتصادي-السياسي والثقافي والأخلاقي، عالم الإنسان. ومن أبرز هذه الخصائص التبادل؛ تبادل الأشياء النافعة والأفكار والتصورات والمعارف (النافعة). الطبيعة البشرية تبادلية بذاتها؛ التبادل ليس صفة خارجية من صفاتها. لكن التبادل يمكن أن يظل فيزيائياً، إذا جاز التعبير، ما لم يتحول إلى تواصل، أي إلى تذاوت، هذا التحول هو أهم مظهر من مظاهر التمدن، ونقيضه التفاصل والتجنب، اللذان لا يزالان سائدين في المجتمعات ما قبل المدنية، وفي المجتمعات المدنية غير المتمدنة على نحو كاف.

لوحة: بطرس المعري
يمكن أن تكون اللغة تبادلية، تقيم تبادلات تقتضيها الحاجة والضرورة، ويمكن أن تكون تواصلية؛ الحالة الأولى، التبادلية، هي القيد الصدئ للحرية، لأن التبادل يكون بين ذوات مكوَّنة ومنظومات مغلقة، تقوم فيما بينها علاقات شاقولية، تعينها نسبة القوى، في حين يكون التواصل بين ذوات تتشكل باستمرار ومنظومات مفتوحة على الدوام، تقوم فيما بينها علاقات أفقية وشبكية. من هنا يكتسب التواصل دلالة أعمق من دلالته القاموسية، فيشير إلى انفتاح الذات الفردية والجمعية على أفق إنساني. وهذا أيضاً من ممكنات الطبيعة البشرية ذاتها، لأن “النوع″ الإنساني هو قوام الفرد الإنساني وهويته/ـا الجذرية. هذا الانفتاح يقتضي تغييراً جذرياً في بنية المعرفة-اللغة، أو اللغة-المعرفة، بجميع مستوياتها الدلالية والنحوية والصرفية والجمالية، وكسر القيود الصدئة، التي تقيد الحرية. ولا يتأتى ذلك إلا بتغير البنى المجتمعية وتغير قواعد السلطة ومبادئ الحكم تغيُّراً جذرياً.
لا شك في أن المعرفة فردية، والعقل فردي، والضمير فردي.. لكن هذا ربع الحقيقة، الربع الثاني أن المعرفة تتحدد بالأطر الاجتماعية، وكذلك العقل والضمير، والربع الثالث أن المعرفة إنسانية والعقل إنساني والضمير إنساني، والربع الأخير أن المعرفة تاريخية والعقل تاريخي والضمير تاريخي. هذا كله ينطبق على اللغة. اللغة فردية واجتماعية وإنسانية وتاريخية، لذلك قد لا تفيدنا علوم اللغة كثيراً من دون فلسفة اللغة وتاريخها.
اللغة المنطوقة، الكلام، إنتاج للمعنى والقيمة، بالتلازم، والكتابة إعادة إنتاج. ولمّا كانت اللغة التي تتكلمها وتكتبها أيّ جماعة تنطوي بذاتها على رؤية للكون (الكوسموس)، ورؤية للعالم (الإيكوس)، ورؤية للإنسان، ولا سيما للمرأة، فإن هذه الرؤية المركبة هي التي تحدد عملية إنتاج المعاني والقيم. الرؤية الكوسمولوجية هي القيد الأول للحرية، لأنها التموضع الأول للمعرفة والاغتراب الأول في الطبيعة، والبذرة الأولى للدين. فلا يمكن فصل “نظرية التوقيف” في أصل اللغة، عن أسطورة/أساطير الخلق، ولا يمكن فصلهما معاً عن البنى المعجمية والدلالية والنحوية والصرفية والبلاغية أو الجمالية، ولا يمكن فصل هذه جميعاً عن نظام المجتمع وبنية السلطة ونظام الحكم، على اختلاف تسمياته: خلافة أو إمامة أو سلطنة أو إمارة أو ملكاً أو “جمهورية”. الرؤية ليست قيداً بذاتها، بل لأنها تؤسس حقول معرفة-سلطة، وتعين ممارسات خطابية وغير خطابية، وأشكال عمل وأنماط سلوك.
فالبنية الدلالية للغة الفصحى، على سبيل المثال، تتمحور على التوحيد والوحدانية والطاعة والعبادة، والدعوة (التبشير) والجهاد، والبطولة والشهادة، والبعث والنشور والثواب والعقاب، والجنة والنار.. والخير والشر والحسن والقبيح والمباح والمحظور.. إلى آخر القائمة. وتتمحور من جهة أخرى على التبادل والعقود والمعاملات، وعلى الحياة الجنسية من جهة ثالثة، حتى ليمكن القول: إن الحرب والتجارة والجنس هي أعمدة اللغة ومحاور الرؤية ومادة السلطة.
من أبرز الأمثلة على القيود الدلالية، علاوة على القيود النحوية والصرفية، القواميس العربية من معجم العين إلى القاموس المحيط وما بني عليها مما يعيِّن بنية دلالية مغلقة، ازدهر إلى جانبها البحث في “الأصيل والدخيل”، وبنى تركيبية (صرفية-نحوية-بلاغية) مغلقة، ولا تزال عاجزة عن إنتاج مصطلحات ومفاهيم قابلة للتداول المعرفي والثقافي العمومي على الصعيد العالمي، وعاجزة عن استقبال مثل هذه المصطلحات والمفاهيم استقبالاً حسناً، على مبدأ “أهلاً وسهلاً”، أو مبدأ “السلام عليكم”.
القواميس العربية عقبات معرفية وقيود على حرية التفكير والتعبير، ومجامع اللغة العربية تشدد هذه القيود وتحكم إقفالها. على أن العيب ليس في مجامع اللغة، على الرغم من غلبة الطابع السلفي المحافظ على معظمها، إن لم يكن عليها جميعاً، بل في النظم الاجتماعية والسياسية أساساً. فقد يستهجن بعضنا وجود علاقة وثيقة بين قواعد السلطة ومبادئ الحكم وبين البنى المعرفية-اللغوية. ونكاد نجزم بأن أيّ تحسن ذي شأن في الأولى يستتبع تحسناً ذا شأن في الثانية وبالعكس. وذلكم هو المعنى الأعمق للثورة الاجتماعية، بما هي عمل تاريخي كلي، يقتضي كسب منجزاته كل يوم، بخلاف ما تسمى ثورات سياسية لم تنتج إلا مسوخاً.
وما من شك في أن أول عملية تقييد للمعرفة-اللغة كانت عملية/عمليات التقعيد والتأطير والتصنيف والتنويع والتفريع والتقسيم، في ما سماه الجابري “عصر التدوين”، (هكذا فعل أرسطو في الثقافة اليونانية)، وكانت تهدف في أساسها إلى تحقيق نوع من الانضباط الاجتماعي-السياسي والثقافي والأخلاقي. (لاحظوا الرابطة الدلالية بين تدوين اللغة والمأثورات والأحاديث النبوية وغيرها وما استتبع ذلك من علوم اللغة وعلوم الدين.. وبين إنشاء الدواوين، كديوان الجند وديوان الخراج والبريد وغيرها وتطورها التاريخي، إذ التدوين ترجمة معرفية وثقافية للتنظيم السياسي، وإنشاء حقول معرفية مواتية للدواوين). ولكن عملية التقييد تلك كانت ضرورية أملتها عملية تشكل مجتمع جديد. وعملية تقييد جديدة وحديثة تبدو لنا ضرورية أيضاً، بخلاف الدعوات الانفعالية إلى الكتابة بحروف لاتينية أو إلغاء الإعراب، الذي دعا إليه هادي العلوي ولم يستطع التقيد به، أو إلى إصلاح النحو الذي دعا إليه أستاذنا سعيد الأفغاني، ولم ينجز منه شيئاً.
لا تكون اللغة إلا كما يكون أهلها، في وجودهم العياني، الاجتماعي-الاقتصادي-السياسي والثقافي والأخلاقي، فما يعزى إلى اللغة من انغلاق وجمود وعجز عن المشاركة الإيجابية في الثقافة الإنسانية الحديثة.. لا يرجع إلى اللغة في ذاتها، بل إلى أهلها أفراداً ونخباً وجماعات ومؤسسات ودولاً أو أشباه دول. ويعزى، بصورة أساسية إلى بنى السلطات العربية، وهي نسيج من عناصر خطابية وغير خطابية، قوامه “اللغة الفصحى”، بما هي لغة السلطة، منذ تفصيحها إلى يومنا وساعتنا. فلا يمكن، وهذه الحال، تحديث اللغة العربية والنهوض بها إلى المعاصرة، معاصرة، اللغات الإنسانية الخلاقة، إلا بتغيير قواعد السلطة ومبادئ الحكم. اللغة العربية مزامنة للغات الخلاقة، ولكنها، ككثير من اللغات، ليست معاصرة لها، وليست خلاقة للسبب ذاته. مسألة اللغة هي مسألة المعاصرة في أفق الحداثة المتحققة بالفعل والحداثة الممكنة. والمعاصرة، (على وزن مفاعلة) تقتضي المشاركة، مشاركة في الوجود ومشاركة في المصير.
لذلك، ندعو إلى إنشاء مؤسسة عربية قوامها متخصصون في جميع فروع المعرفة تقوم بوضع عدد من القواميس:
1 – قاموس لغوي يزيل ما تحمله مفردات اللغة من شحنات أيديولوجية، أنتجتها رؤية أسطورية للكون، ورؤية دينية للعالم والإنسان أولاً. وتستَبعد منه المفردات الميتة، التي خرجت من التداول كلياً، ثانياً. ويدمج المفردات المتداولة في الأوساط الشعبية فيه ثالثاً، ويتعامل مع المصطلحات والمفاهيم المتداولة في العالم اليوم على أنها من أهل البيت، دونما تفريق بين أصيل ودخيل، رابعاً. وتعميمه على المؤسسات التعليمية والثقافية وإتاحته للأفراد أخيراً. وهذا كله لا يفيد كثيراً من دون نزع طابع القداسة عن اللغة العربية الفصحى ونصوصها التأسيسية ومدوناتها وعلومها وعلمائها.
2 – قاموس لغوي-تاريخي، يعنى بالإيتمولوجيا، (علم أصول الكلمات)، ويبين تطور دلالة الكلمة واستعمالاتها في المجالات المختلفة.
3 – قواميس متخصصة في جميع فروع المعرفة، يصار إلى تحديثها دورياً لمواكبة التطور المتسارع، في مختلف مجالات المعرفة وفروعها.
4 – توثيق الثقافة الشفوية للمجتمعات الصغيرة والمجتمع الكبير، وتدوينها، والعمل على نشرها، لا لتكون معيناً للباحثين في العلوم الإنسانية، ولا سيما اجتماعيات الثقافة فقط، بل لإخراجها من الظل وإزاحتها من الهامش، وإبراز محتواها الإنساني، ودمجها في الثقافة الوطنية المنفتحة على أفق إنساني وديمقراطي.
5 – العمل على إنتاج رؤية استراتيجية لتوزيع المؤسسات والموارد الثقافية توزيعاً عادلاً بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، في كل بلد على حدة، وإقامة علاقات أفقية وشبكية متكافئة فيما بينها، على نحو يتيح تدفق المعارف والموارد الثقافية بحرية، من جهة، ويسهم في تطور كل منها وفق إيقاع تطور الأخريات من جهة ثانية.
ثمة مساحة، تتسع اليوم باطِّراد، يتقاطع فيها العلم والشعر والفلسفة، ترهص، في اعتقادنا، بثورة في المعرفة-اللغة، يمكن تبيُّن ملامحها، في ثقافتنا المعاصرة، من خلال الإبداع الأدبي عامة والشعر خاصة. فقد كسر الشعر العربي عدداً من القيود الصدئة، قيداً تلو الآخر، بدءاً من القيود القاموسية وصولاً إلى القيود البلاغية. لكن تخلّف العلم والفلسفة لا يزال يحد من انطلاقة الشعر، ويحتجز إمكانات الثورة المعرفية- اللغوية. ويبدو لنا أن تخلف السلطة/السلطات ولاإنسانيتها هو ما يحتجز هذه الإمكانات. السلطة، على نحو ما استقرت في ثقافتنا وتاريخنا، وعلى نحو ما نعيشها ونعاني من وطأتها، هي القيد الصدئ للحرية.
إشارات
[1]- نعني أن اللغة ليست توقيفاً، وليست اصطلاحاً أيضاً، على الرغم من قدرتها الاصطلاحية والترميزية.
[2] – جمعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 145، يناير، 1990، ص 17.
[3]- سيد يوسف، ص 47، بتصرف.
[4] – محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبد العالي، اللغة، سلسلة دفاتر فلسفية، رقم 5، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2005، ص 5.
[5]- نقصد باستقلال اللغة النسبي صيرورتها موضوعاً مستقلاً لعلوم اللغة واللسانيات الحديثة، ما يحصرها في نطاق الوضعية الإيجابية، ويجفف نسغها الروحي أو الإنساني، ولا فرق.
[6] – ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن ترجمة علي مقلد، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1990 ص 65. بتصرف