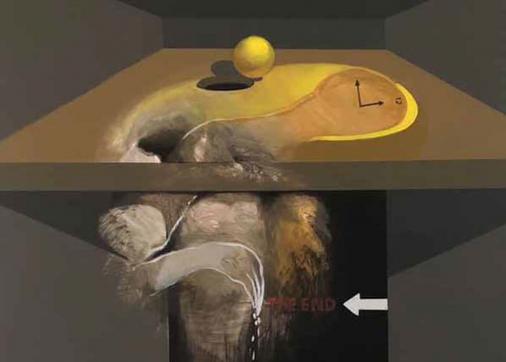إنقاذ الوعي

لعل أيّ شخص يقوم بتدريس اللغات والآداب اليوم في المدارس الثانوية أو في الجامعات يدرك حجم الصعوبات التي تواجه الطلاب عند محاولتهم قراءة وفهم النصوص ذات الطابع الأدبي، فقد أصبح من الصعب على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و23 عامًا استيعاب الأفكار الأساسية للنص، وفهم الفروق الدقيقة، فضلًا عن قراءة ما بين السطور، وإقامة روابط بين طبقات المعنى داخل النص وبين النص وواقعه وسياقاته المختلفة، والنفاذ إلى المعاني العميقة التي لا تمنح نفسها على الفور من القراءة الأولى المتعجلة.
ليست الصعوبات التي تواجه من يحاول كتابة نص مركب أو أقله غير وظيفي، حيث يفتقر معظم ما ينتجه الشباب الذي ينتمي لهذه المرحلة العمرية إلى التناسق والتماسك، وهذا ما أكدته دراسات علمية مختلفة تناولت بالتفصيل هذه الصعوبات. وقد أثارت نتائج هذه الدراسات قلق العديد من البلدان الأوروبية لاسيما إيطاليا حيث أظهرت دراسة أجريت في عام 2018 على مجموعة من الطلاب في سن 15 عامًا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كجزء من برنامج تقييم الطلاب الدوليين أن الطلاب الإيطاليين هم أقل الطلاب في أوروبا قدرةً على قراءة النصوص وفهما.
تتضاءل القدرة على القراءة بشكل مقلق في إيطاليا، فوفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) في عام 2019 فإن 40 في المئة من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، أي الذين تعلموا القراءة والكتابة يقرؤون كتابًا واحدًا على الأقل سنويًا. وهو ما يعني أن 60 في المئة من الإيطاليين لم يقرؤوا أي كتاب على الإطلاق. ووفقًا لـمعهد Istat أيضًا، فإن الإغلاق بسبب وباء كورونا في عام 2020 كان من المفترض أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في هذه النسبة لكنه لم يؤدي إلا إلى ارتفاع ضئيل حيث ارتفع عدد الإيطاليين الذين يقرؤون كتابًا واحدًا على الأقل سنويًا إلى 41.4 في المئة. وقد يتساءل البعض حول مدى صحة أن يوصف من يقرأ كتابًا واحدًا فقط في العام بأنه “قارئ”؟ ناهيك عن التساؤل حول نوعية الكتب التي يقرأها هؤلاء القراء؟
مشكلة القراءة الحقيقية في عالم اليوم لا تكمن في حجم ما يتم قراءته وإنما في جودته، لأنه في الواقع، نقضي جميعًا اليوم وقتًا أطول في القراءة أكثر من الماضي إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي نقضيه على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى غيرها من المواقع الإلكترونية، فنحن نقرأ المنشورات والأخبار ونعلق عليها وأحيانًا نكتبها، كما نقرأ المدونات والصحف عبر الإنترنت، ونقرأ كذلك رسائل البريد الإلكتروني ونكتبها، ونتحادث، ونتصفح … ونقوم بذلك في كل لحظة من يومنا، بفضل الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. نحن نقرأ في كل وقت، لا توجد لحظة خاصة مكرسة للقراءة فقط. وهذه هي المشكلة تحديدًا، فقد أصبحت القراءة واحدة من الأنشطة العديدة المحمومة في الحياة الحديثة. لكل هذا، إلى جانب انتقال فضاء القراءة بشكل شبه كامل إلى الشاشات، عواقب مهمة على نظامنا المعرفي. علّمنا عالم الأعصاب واللغويات نعوم تشومسكي قبل أيّ شخص آخر، أننا نحن البشر ولدنا لنتكلم. بعبارة أخرى، يوجد في دماغنا استعداد بيولوجي للغة الشفوية ناتج عن سلسلة من الطفرات الجينية التي بدأت منذ حوالي 100000 عام مع عملية الانتخاب الطبيعي. لذلك، اللغة هي تعبير عن الدماغ نفسه. إذا استخدمنا الاستعارة البليغة للغوي وعالم الأعصاب الإيطالي أندريا مورو، فإن الأمر يبدو كما لو أن “الجسد أصبح لوغوسا”. لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة إلى القراءة التي تعد اختراعًا ثقافيًا بشريًا منذ ستة آلاف عام فقط، وبالتالي يجب تعلمها من خلال التعليم الرسمي، بغض النظر عن نظام إنتاج اللغة الشفوية. تحتاج دوائر الدماغ إلى التدريب على القراءة والقراءة تغير دوائر الدماغ. إن نظام الدماغ المخصص للقراءة مرن بطبيعته، ويتأثر بنظام الكتابة والمحتويات وأداة القراءة وكيف يتعلم المرء القراءة. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرحه العديد من علماء الأعصاب على أنفسهم اليوم هو كيف تغير القراءة على الشاشة دوائر دماغنا وما هي العواقب العملية التي يمكن أن تترتب على حياة الإنسان والمجتمع ككل، وهو سؤال أساسي أيضًا لفهم مصير الأدب في الثقافة الرقمية.
قال عالم الاجتماع الدنماركي ديريك دي كيركوف متحدثًا في لقاء ريميني في الخامس والعشرين من أغسطس، إننا ربما ندخل في أكبر أزمة معرفية في التاريخ، حيث تتحول الحضارة التي عاشت على الكتابة والثقافة الأبجدية الآن إلى الثقافة الرقمية، وهذا الانتقال يشبه الانتقال من الثقافة الشفوية إلى الثقافة الكتابية. لكن هذا الانتقال يخفي خطرًا كبيرًا يتمثل في فقدان الأنا. وفقًا لـ De Kerckhove، فإن الأنا هي نتاج ثقافي نتج عن الكتابة، أي الثقافة الأبجدية، عندما بدأ الناس في القراءة في صمت واستوعبوا نظام الفكر وبنية الوعي. القراءة على الورق ضرورية وتجب حمايتها، لأن هذا هو المكان الوحيد الذي يتم فيه تثبيت اللغة ويصبح الشخص فيه سيد الكلمة، في تلك العلاقة الحميمة مع نفسه.
تناولت عالمة الأعصاب الأميركية ماريان وولف هذه القضية بالتفصيل في كتابها الجميل بعنوان Reader، Come Home: The Reading Brain in a Digital World، موضحة بوضوح شديد سبب ارتباط فقدان القراءة على الورق والقراءة العميقة وما هي العواقب الوخيمة على الشخص وعلى المجتمع البشري. تتضمن القراءة العميقة عمليات معرفية معقدة، وتتطلب استخدام الاستدلال والاستدلال القياسي لكشف الطبقات المتعددة لمعنى ما نقرأه. تستخدم ماريان وولف صورة سيرك ثلاثي المسارات لشرح ما يحدث في أدمغتنا عندما نقرأ بعمق. فدون الخوض في التفاصيل، تتضمن القراءة العميقة، حتى قراءة كلمة واحدة، نقل الإشارات عبر جميع طبقات الدماغ الخمس، وتفعيل مجموعة كاملة من الذكريات والعواطف والمعاني المرتبطة بها. تترك قراءة كلمة ما أثرًا لا يمحى في الدماغ يمكن إعادة تنشيطه بقراءات لاحقة، من خلال شبكة من الروابط التي تُغنى أكثر فأكثر مع كل قراءة جديدة. كما قال عالم الأعصاب ديفيد إيجلمان “يوجد في سنتيمتر مكعب واحد من أنسجة المخ عددًا من الوصلات يساوي عدد النجوم في مجرة درب التبانة”.
كيف يظهر هذا الترابط الدماغي الكثيف الناتج عن القراءة على مستوى وعي القارئ؟ يعتقد مارسيل بروست أن القراءة هي “معجزة تواصل مثمرة في حضن العزلة”. بالنسبة إلى سوزان سونتاج “كان الكتاب مثل الدخول إلى المرآة”. ما يصفه بروست وسونتاج هو التكوين البطيء للأنا في مواجهة الآخر. على الرغم من طبيعته الانفرادية، فإن فعل القراءة، وفقًا لعالم اللاهوت جون دن، هو إعداد للجهود المبذولة للتعرف على البشر الآخرين وفهم ما يشعرون به والبدء في تغيير تصورنا لمن هو وماذا أيضًا. تمنحنا القراءة العميقة القدرة على أن نصبح أكثر إنسانية، لأنه من خلال القراءة بعمق، كما يقول وولف، نرحب بالآخر كضيف في داخلنا، وغالبًا ما نصبح آخرين. للحظة نتخلى عن أنفسنا، وعندما نعود، ربما نشعر بالثراء والتعزيز، نجد أنفسنا متغيرين عاطفيًا وفكريًا. يضيف وولف أن عملية افتراض وعي الآخر أثناء قراءة نص سردي وطبيعة محتويات هذا النوع من النص، حيث يتم تنظيم العواطف الكبيرة وصراعات الحياة عادة، لا تساهم فقط في تعاطفنا، بل إنها تمثل ما أطلق عليه عالم الاجتماع فرانك هاكيمولدر “مختبرنا الأخلاقي”.
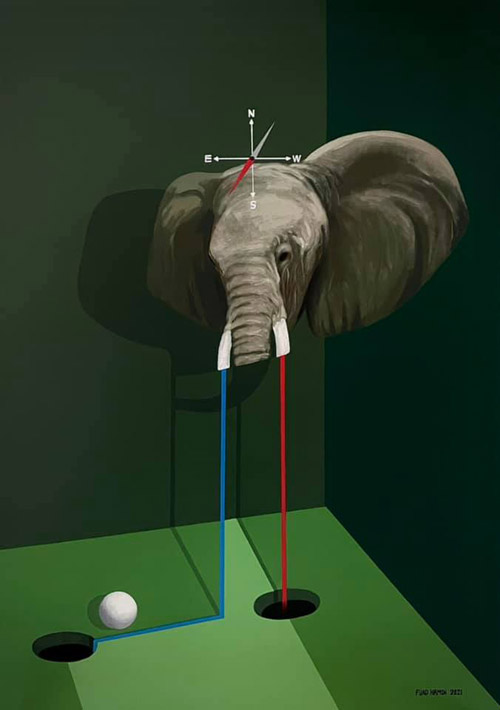
لذلك، يؤكد العلم ما يعرفه كل قارئ خبير من التجربة الشخصية: عندما نقرأ القصص الخيالية، نشعر حقًا بما يعنيه أن تكون شخصًا آخر، وبهذه الطريقة نستعد للعيش حقًا مع الآخرين، نتعلم التعاطف والاستماع. القراءة العميقة، بالنسبة إلى وولف، هي عنصر أساسي في تكوين الفرد ومجتمع أكثر ديمقراطية. ماذا سيحدث للقراء الشباب الذين لم يلتقوا أبدًا ولم يبدأوا أبدًا في فهم أفكار ومشاعر شخص مختلف تمامًا عنهم؟ ماذا سيحدث للقراء الأكثر نضجًا الذين يبدأون في فقدان الاتصال بهذا الشعور بالتعاطف مع الأشخاص خارج روابطهم الأسرية أو فهمهم؟ لأن الشباب المولودين في العصر الرقمي ليس فقط هم الذين يعانون من فقدان القراءة العميقة، ولكن أيضًا أولئك الذين ولدوا قبل اختراع الإنترنت والثورة الرقمية. أجرت ماريان وولف بنفسها تجربة يمكن لكل واحد منا تكرارها. أعاد قراءة كتاب لهيرمان هيسه كان له تأثير عميق على تكوين شبابه، وجد بجزع أنه لم يعد قادرًا على الانغماس في القراءة والتوافق مع السرد كما فعل عندما كان شابًا. تقرأ بشكل سطحي، محاولاً إجبار إيقاع السرد على قراءتها السريعة والشاملة، بدلاً من “اختطافها” وحملها في الكتاب. فقط بعد أسابيع من الممارسة والكثير من الانضباط، تمكنت أخيرًا من اللحاق بعمليات القراءة العميقة.
يستغرق تنشيط عمليات القراءة العميقة سنوات. هناك حاجة إلى ما تسميه ماريان وولف الصبر المعرفي. يستغرق الأمر وقتًا وتركيزًا وبطءا، وكلها تتعارض مع سرعة العصر الرقمي. القراءة السائدة على الشاشة في هذا العصر غير كافية للقراءة العميقة للنصوص الطويلة والمعقدة لأسباب عديدة، كما أظهرت دراسات علمية مختلفة. يرتبط السبب الأول بما يسمى بالتأطير المكاني، أي بحقيقة أن ذاكرتنا، لكي تعمل بشكل جيد، مرتبطة بسياق الزمكان الذي اكتسبناه فيه. بعبارة أخرى، لا تزال ذاكرة محتوى معين في النقطة التي نقرأها في الكتاب. على عكس النصّ الموجود على الشاشة، يتميز النص الموجود على الورق بسياق مكاني ثابت ومحدد جيدًا يعطى من خلال المادية، ثلاثية الأبعاد والملموسة للكتاب التي تساعد على إصلاح الذاكرة والسماح للمعنى بالاستقرار الوعي. يساهم العنصر الحسي بالقدرة على لمس الصفحات وشمّها في فهم النص وإثرائه. السبب الثاني هو أن القراءة على الشاشة، على سبيل المثال الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر، يسهل تشتيت انتباهنا عن البيئة المحيطة. نتعرض باستمرار لمحفزات لا علاقة لها بالقراءة، مثل إشعارات الرسائل والبريد الإلكتروني أو إعلانات الشعارات. تجذب هذه المنبهات انتباهنا بقوة، حتى بشكل مستقل عن إرادتنا، لأن دماغنا مهيأ بيولوجيًا للتفاعل مع أيّ محفز خارجي قد يشير إلى وجود خطر. آلية سمحت لنا في الماضي بالبقاء على قيد الحياة، ولكنها حولت قراءتنا اليوم إلى قشط، قراءة سطحية تتحرك فيها العيون في شكل منعرج متعرج على النص لتحديد الأفكار والمعلومات الرئيسية بسرعة. تؤدي عادة القراءة الرقمية إلى فقدان القدرة على القراءة بعمق حتى على الورق، مع وجود عواقب نوقشت بالفعل مثل الافتقار إلى الصبر المعرفي الذي يؤدي بدوره إلى الفشل في تطوير التفكير النقدي التحليلي والمثابرة المعرفية. إن معرفة الذات والآخرين والعالم الذي تستعد له القراءة العميقة، في حميمية الذات، لم تعد تتطور مع القراءة السطحية على الشاشة، وتبقى على مستوى المعلومات غير الدائمة، لدرجة أنه يمكن للمرء أن يلجأ دائمًا إلى الشبكة لاستردادها عند الحاجة.
بالنظر إلى صورة الموقف، من السهل أن نفهم كيف تقوّض القراءة الرقمية الأدب، الذي يتكون نسيجه من نصوص معقدة، ذات معان طبقية، لا يمكن فهمها إلا من خلال قراءة عميقة. من بين جميع الأنواع الأدبية، ربما تكون الرواية هي الأكثر أزمة بعد الثورة الرقمية. صحيح أننا نتحدث منذ عقود عن موت الرواية، ويرجع ذلك أساسًا إلى منافسة السينما والتلفزيون، لكن الأزمة التي تواجهها الرواية الآن، في العصر الرقمي، لها تداعيات جديدة. يكاد طول الرواية يتوافق مع مدى الانتباه المنخفض للغاية وسرعة القراءة لقراء اليوم، الذين اعتادوا على قراءة نصوص قصيرة على الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية. في الفصول الدراسية في المدارس والجامعات، غالبًا ما نرى كيف أن الطلاب أقل صبرًا ونجد صعوبة متزايدة في قضاء الوقت اللازم لفهم بنية النصوص المعقدة، وبالفعل بنية الجمل المفردة ذات البنية المعقدة. إذا كانت هذه المشكلة موجودة في اللغة الأم، فيمكن للمرء أن يتخيل كيف يتم تضخيمها في حالة تدريس لغة ثانية، ربما تكون معقدة مثل العربية. تتدهور كتابة الروايات أيضًا، إذا كان ما أشارت إليه ماريان وولف صحيحًا، أي أن متوسط طول الجملة في أفضل الكتب مبيعًا حاليًا يبدو أنه أقل من نصف طول الروايات المكتوبة من البداية إلى منتصف القرن العشرين، مع عدد أقل بشكل كبير من البنود الثانوية لكل فترة. مع العلم، من دراسات Andrea Moro وNoam Chomsky، أن التركيب اللغوي هو قدرة بشرية بحتة تميزنا عن الحيوانات، يمكننا أن ندرك جيدًا مدى الكارثة.
أشار الفيلسوف سيرجيو جيفون والكاتب جيان ماريو فيلالتا، في حديثهما في لقاء ريميني هذا العام، إلى صعوبة أخرى للرواية في العصر الرقمي تتعلق بعلاقتها بخطية الزمن. على عكس، على سبيل المثال، المسلسل التلفزيوني الذي أطاح بالسينما اليوم أيضًا، فإن للرواية بداية ونهاية محددتين جيدًا، لكننا اليوم فقدنا خطية الوقت، منغمسون كما نحن في “الشبكة”، في مركز أبعاد الجمع. ربما اقترحت الكاتبة كارمن بيليجرينو، رداً على استدراج جيفوني وفيلالتا، أن الرواية يجب أن تتجدد قليلاً، وأن تتكيف في شكلها مع الطبيعة المجزأة لعصرنا. وهو ما فعلته الرواية أيضًا، لقول الحقيقة، بتجربة أشكال مختلفة. لكن ألا يعني هذا مزيدًا من الانغماس في الابتعاد عن القراءة العميقة، وإعادة إنتاج ما يحدث بالفعل في ذهن القارئ كتابةً؟ علاوة على ذلك، نحن منغمسون باستمرار في بحر من الروايات التي تأتي إلينا من اتجاهات مختلفة. كيف يمكن تمييز رواية الرواية عن رواية الاتصال الإعلاني، من رواية وسائل الإعلام، عن السرد في صور المسلسلات التلفزيونية، عن السرد الذي يصنعه الجميع بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كانت القراءة العميقة خاسرة؟ السرعة والسطحية في القراءة الرقمية؟
يتعارض شكل الرواية مع أشكال الاتصال السريعة اليوم. لا يبدو أن الرواية تتمتع بالشكل الصحيح لتظل قادرة على الإجابة على الأسئلة العظيمة المتعلقة بالمعنى التي رافقت الإنسانية دائمًا والتي بالتأكيد لن تختفي مع العصر الرقمي. وبالتالي؟ قد يجادل البعض بأن الرواية قد انتهت من مهمتها ولا حرج في ذلك. ومع ذلك، أنا مقتنعة بأن هناك حاجة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى للرواية والقراءة العميقة. إنها مسألة تتعلق بالصحة العقلية، اليوم فقط عندما نشهد تغيرًا تاريخيًا في أعقاب وباء Covid-19 ونحن في حاجة ماسة إلى تلك “المعجزة المثمرة للتواصل داخل العزلة” التي ابتكرها بروست مبتكر هذا التعاطف والفضاء الخيال ضروري لتجديد عالمنا وإشعال التفكير النقدي. قال الكاتب لوكا دونينيلي، في لقاء ريميني أيضًا، إنه يعتقد أن الرواية هي رسالة في زجاجة، لكن من سيجمعها في العصر الرقمي؟ ما الذي يمكن أن يكون مفتاح العودة إلى القراءة العميقة، أو “العودة إلى الوطن”، إذا أردنا استخدام كلمات ماريان وولف؟
أنا بالتأكيد لا أملك قرينة العثور على إجابة نهائية، ولكن تجربتي الشخصية في التدريس قد اقترحت طريقة ممكنة، وبهذه الطريقة، بشكل غير متوقع، الشعر. يبدو الأمر غير منطقي، وأنا أعي ذلك، لأن قراء اليوم الذين يقرؤون عددًا قليلاً جدًا من الروايات يقرؤون عددًا أقل من الشعر. إذا كانت الرواية مثل وضع رسالة في زجاجة، فإن الشعر يشبه وضع رسالة في الزجاجة بالعلم أنك في الصحراء، وفقًا لفيلالتا. لكن عندما اقترحت دراسة بعض القصائد على طلاب اللغة العربية المتقدمين، أدهشني رد فعلهم. لم يكونوا من طلاب الأدب، ولم يكن أيّ منهم يقرأ الشعر، واعترف لي أحدهم، في نهاية الدروس، أنهم لم يحبوا الشعر على الإطلاق قبل ذلك الوقت، ولكن بعد دراسة بعض القصائد في الفصل، تغير شيء ما. على عكس الرواية، تتمتع القصيدة بالشكل المكثف المناسب لجذب انتباه القراء المعتادين على القراءة السريعة والسطحية، والتي يتم تشتيت انتباههم باستمرار بواسطة ألف منبهات مختلفة. تحتوي القصيدة في آية واحدة على قصص حياة كاملة وقوة معاني العديد من صفحات الرواية. إنه قادر على تعليق لحظة الزوبعة التي لا تتوقف أبدًا في هذا العصر الرقمي. إنه قادر على “قلبنا”، كما لو كان أحدهم يتصل بنا ونلاحظه فجأة. إنه قادر على فتح ثغرة في ستار الروايات التافهة التي تستثمرنا باستمرار وهذا الخرق، وبعد ذلك، بمجرد فتحه، يمكن أن يتسع، إذا تم الاعتناء به جيدًا، للسماح للكلمة المكتوبة بالعودة إلى الصدى لفترة طويلة في وعينا.. حدث، على سبيل المثال، مع الطلاب الذين كانوا أمامي يومًا ما، وهم يقرأون قصيدة لوديع سعادة: كيف للسابح أن يصل والبحر يغرق؟
وحدث مع قصائد أحمد يماني استفزاز الطلاب الصغار كثيرا، والتشكيك في فكرتهم عن الحب. نعم، لأن قوة الشعر، التي استطعتُ ملاحظتها في الفصل، كانت تثير ردود فعل، بغض النظر عما إذا كانت إيجابية أم سلبية. أثارت هذه القصائد شيئًا عميقًا في نفوسهم، لأنها تحدت الصور المسبقة في أذهانهم، أو أثارت صورًا جديدة فيها، مما دفعهم إلى التفكير، والتساؤل، والتفسير، والرغبة في معرفة المزيد عمن كتبهم. (ها هو التعاطف!)، بالضبط ما هو متوقع من القراءة العميقة. لقد كانوا قادرين على تجربة التغيير المفاجئ في المنظور الذي يسمح لنا بتوسيع أفق الأفكار وبالتالي الواقع الذي نقرر أن نحصر أنفسنا فيه.
إذا اضطررتُ إلى الاعتماد فقط على خبرتي التدريسية، فلن أجرؤ على اقتراح الشعر كطريقة ممكنة للعودة إلى القراءة العميقة. لكنني لست الوحيدة التي تؤمن بأن الشعر يمكن أن يعيد اكتشاف دور مهم في العصر الرقمي، فآخرون أكثر شهرة مني لديهم نفس الرأي. هذا هو الحال، على سبيل المثال، لفرانكو أرمينيو، أحد أشهر الشعراء الإيطاليين في الوقت الحالي، الذي يقوم بجولة في إيطاليا لجلب شعره إلى جمهور كبير. يملأ أرمينيو الساحات والمسارح ويخبرنا بتجربته في مقابلة العديد من الناس من خلال الشعر. يقول إنه سمع العديد من الشهادات لأشخاص يزعمون أنهم يقرؤون الشعر لشفاء أنفسهم من شرور هذا الزمن. في مقال نشر في صحيفة La Repubblica بتاريخ الحادي والعشرين من أغسطس 2021، أوضح أرمينيو فكرته عن الشعر والكتابة: “الشعر جسد يحرر نفسه من همهمة اللغة، إنه السبيل للوصول إلى الصمت، النور، الأشياء التي هي خارجنا. […] الشعر هو تسجيل لزلزال يفتح شقوقًا في الجسد ومن هذه الشقوق تظهر اللغة، وتظهر الحياة المدفونة. يأخذ الشعر اللغة من الأحياء والأموات ومن المنفى ومن المجتمع ومن السفر والبقاء ساكناً. ربما يكون هذا هو الوقت الذي يمكن أن يقرأ فيه الشعر بشكل أفضل من التخصّصات الأخرى. ولا نعرف السبب حقًا. يبدو الأمر كما لو أن الآيات بها أشواك تحفر الأرض بشكل أفضل. الآيات هي أيضًا شباك رائعة للصيد بحثًا عن الألغاز التي تجوب الهواء. وتجد الهواء للصيد في قطار، في ساحة، في مطعم، تجده في بلدتك وفي المدينة المجاورة، تجده عند الفجر، تجده في قبلة، في جنازة، في المشي “. أرمينيو مقتنع بأن الإنسانية الجديدة القادمة تتكون من “تكنولوجيا مقطوعة عن الشعر”.
يجب أن نتحلى بالشجاعة وألا نتوقف عن اقتراح الشعر وإعادة اقتراحه حتى في عصر التكنولوجيا الفائقة والسريع، حتى مع الأشكال الأدبية الأخرى التي قد تولد. إذا فقدنا القراءة العميقة، نفقد الأدب. إذا فقدنا الأدب، فإننا نفقد اللغة. لكن اللغة، كما أخبرنا أندريا مورو، هي تعبير عن جسدنا وإذا فقدناها، أو ضمرت، فإننا نفقد أنفسنا ومنزلنا. ربما تستطيع الأبيات الشعرية أن تشق طريقها في الهمهمة المستمرة للغة التي تميز عصرنا وتعيدنا إلى بيتنا.