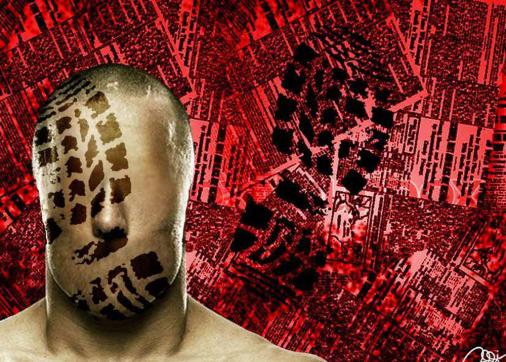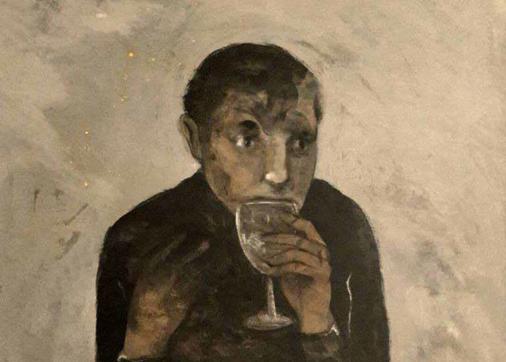تحت أقدام الهيمالايا

"مَنْ أضحى سائراً في الأرض، أمسى إماماً". "الهمداني"
كاتماندو
«بؤس العالم أفضل من ظلمه»! هذا ما سأُدْركه سريعاً في «كاتماندو» عاصمة «النيبال».
نصل إليها مساء بعد عاصفة مذهلة دفعت طائرتنا إلى تحويل مسارها نحو الهند. وبعد ساعات من البقاء محصورين في مقاعدنا، وهي جاثمة في أعالي الهيمالايا، حلَّقت، من جديد، نحو كاتماندو لتحط فيها في أول الليل. وفي أول الليل ماذا نرى؟ نرى الذُّهول: بشر وغبار، تلك هي كاتماندو. لكن ذلك ليس تعريفاً، كما سنعرف سريعاً، وإنما هو «طريقة حياة».
في الصباح الباكر نخرج بلهفة المشتاق لنرى كل شيء. نخرج إلى اللقاء، لقاء الآخرين المنتشرين في الطرقات مثل زُروع «الجزيرة». نمشي على هوانا، ونتفرج على المِحَن والغبار. بساطة البشر والأشياء مغرية. لا توتّر، ولا تناحر، ولا بطش، ولا عنجهية. لا شيء سوى وجودهم العاصف، الذي لا صفة له خارج حركتهم المستمرة. هذا الإحساس البسيط الطاغي، هو الذي يملأ فضاء كاتماندو حولك، وتحس به بقوّة منذ الوهلة الأولى. الكل سواسية في الحركة والصمت أمام الضوء الفاتر والغبار، أمام هَشاشة الوجود التي تكاد أن تمسكها بيديك.
أول ما نزور في كاتْمانْدو «القصر الملكي»، القصر الذي كان ملكياً. اليوم صار مُلْكاً لشعب لا ينسى شيئاً من حياته، وإن كان لا يتكلّم عن أي شيء. حاجات الحياة اليومية هي التي تملأ أمعاءه الفكرية، أو هذا ما يظهر لي. لكن الظاهر، غالباً، هو العفن الذي تحاول الكائنات التخلّص منه بأرخص الأثمان: رمْيَه بلا أسف على قوارع الطرقات مثل نفاية لم تعد ثمة ضرورة للاحتفاظ بها.
قبل أن ندخل القصر أخذوا منا كل شيء. أخذوا عقولنا وقلوبنا: الكاميرات، والهواتف، والساعات، وكل ما يمكن أن يدلّنا على الطريق: «طريق الحس السليم»، أو الذي كان يبدو لنا كذلك. ونبدأ الزيارة عُزَّلاً، نكاد نكون حفاة وعُراة. ملحقات الحضارة، ولوازمها اليومية، كلها، أخذوها! وقالوا: ادْخلوا!
على مدخل القصر الجميل، دُروع، وأحصنة، وأفيال. وثمّة طاووس أسود. يهيمن عليها جميعاً: الدب الأبيض، والنمور المفترسة. وأول ما نراه، داخلين، صُوَر الملوك الأوائل: «بريتيفي نارايانْ شاه» 1725، و«براتابْ سِنْجْ شاه» 1701، وصور ملوك آخرين، تزيِّن مداخل قاعات القصر المهيب. وأينما نظرت، تطالعك مناظر جبال الهيمالايا الأُسطورية، وكأنها تؤكِّد للعابرين أن رسوخها هو الذي يحمي القاع من الطيران.
نرى كذلك صور الطواويس الجميلة، وأثاثاً من العاج والمرمر متخماً بالفخامة، يغرق في لَجَّة من الصمت. صمت التاريخ الذي لم تعد له أهمية خارج الجدران. وأخيراً، صورة لِقمّة «أفريستْ» التي تعتبر الشعار القومي في «نيبال». ألوان القصر المسيطرة هي الأخضر لون المحبة والعِفَّة، والذهبي، والفضي. وعلى القاع السجاد الكاشميري ذو اللون الأحمر الفاقع. وفوق الجميع قمم الجبال العظمى القابعة تحت طبقات من الثلج والغيم. قُمم مفزعة، لكأنها تقرع أجراس الكون قبل أن يلج نقطة العدم. مَنْ ينقذني من هذه الجبال؟
عندما نخرج من القصر يودعنا «بودا». «بودا» الهادئ والعميق، وهو ينظر أسفل جفنَيْه. «بودا» لا يحدّق في وجوه الآخرين لأنه مستغرق في أعماقه. ومنذ أن نخرج من القصر، أقف في مكاني، وأنا أردد مذهولاً: ما هذه الجحافل المُتْربة؟ وأي بشر هم هؤلاء؟ يغُبّون الريح وهم يلهثون، وكأنهم عطاشى «الحسكة» القُدماء إلى هواء بارد. أولئك الذين عرفتهم في طفولتي، وتقاسمتُ معهم الجَمْر، جَمْر القيْظ وجحيمه! وما هذا التراب الناعم كالحرير؟ وهذه الأقدام الجَلْفة التي تدوس القاع بحميّة وتصميم وكأنها في حرب معها. أَأكون جئتُ إلى هنا عمداً لأتمتَّع بالحُفَر والقيعان؟
***
في معبد «باشوباتيناتْ»، أجلس على راحتي، متمتّعاً بسلام داخليّ عميق. في فضاء هذا المعبد الآجري الأحمر، تسرح القرود على هواها، وكذلك البشر، البشر والحمام وأحياء أخرى. ثمة كائنات غريبة شتّى، تجد فيه الراحة العميقة لنفسها. هنا تشعر الكائنات، أيا كان جنسها، بأخوة وسلام عميقين. لا أحد أفضل من أحد. جميعنا نتزاحم نحو الظل، ظل الأشجار العظمى التي تقينا من الشمس. فوق أحجاره الصُمّ أجلس طويلاً، غارقاً في صمت حيواني لا لغة فيه، ولا، أكاد أقول، أحاسيس. إنه صمت فقط. صمت عظيم دون أي بُعْد آخر.

معبد هائل الروعة هو هذا المعبد النيبالي. يقع فوق هضبة محشوّة بالشجر والحجر. المقدّس الخالد، واليوميّ العابر، يمتزجان فيه بطريقة عفوية، وعلى قدر كبير من الإنسانية التي تدهش بصدقها وبساطتها. فيه نفهم معنى السلام الكوني الذي يخلِّصنا في النهاية من التَّكَذُّب والتكَبُّر والحماقة. يجعلنا نتساوى، بالرغم منا، مع الأحياء الأخرى، لا مع الكائنات فحسب! هنا لا فرق بين القرد والفرد (لاحظوا: نقطة واحدة فقط). لا فرق بينهما إلا بالطول! لكن الطول لم يأتِ من عدم. إنه نتيجة عبقرية لتطوّر الأحياء. وهذا التطوّر اللامتناهي واللامحدود هو الذي سَوّانا كثْرة ومتعددين، ولكن، من دون أن يمنحنا ميزة على غيرنا. والآن، بعد جلسة طويلة برفقة القرود «الحذرين واللطفاء»، ولكن الأنانيون بشكل كبير، سأبحث عن بؤرة أخرى جديرة بالتأمّل والاهتمام.
***
«باغْماتي»، معبد عظيم آخَر يجعل الزائر يشعر بالدواخ. منَصّات حرق الموتى في أرجائه، على ضفة النهر البائس الذي لا يجري، أو هكذا يبدو من ثخانة مائه المليء بالسماد، تتراصف بشكل طُقوسيّ! منَصَّات صُوّانية مذهلة، ومساطب من الحجر والأخشاب، حيث «شواء» الجثث فوقها لا ينقطع على مدار اليوم. هذا «الجهنّم» الحيّ كان وجهتنا هذا النهار. أيّ شيطان دخل نفسي لأُلْقي بها في الجحيم؟ في بادية الشام، كنت أسمع الكلمات الغامضة حول السَّعيرة التي ستلتهم أجساد العباد يوم القيامة، وأرتعب. أهرب إلى البرّ لأتبوَّل من الخوف. وهاأنذا اليوم أواجه الموتى في حرائقهم المزيّنة، وكأنهم في عرس. في «نيبال» لم ينتظروا يوم القيامة ليُحرِقوا موتاهم. هاهم يلْقون بهم، بعد أن زيَّنوهم، وعطَّروهم، وغسّلوهم، في قلب التنانير المشتعلة على حافة النهر. النهر! بل قُلْ نُهيْراً ضحلاً مملوء بالرماد والطين والقشور والأسمال. ماؤه مخيف من شدّة ثَخانته. ولونه ترابي بائس، ولا يُحيل إلاّ إلى الموت. هذا الذي كان ذات يوم نهراً، غدا مدفناً مائيّاً لرفات لا متناهية العدد. ولأن الأهالي يلقون مع الميت بعض النقود المعدنية، ترى الأطفال الجوعى يخوضون في طين الجثث الثخين، غاطسين فيه حتى صدورهم، وأياديهم مثل المخالب تبحث في قعر النهر عن دُرَيْهمات بلا قيمة، أو تكاد.
أمام النار المقدسة أجلس بهيبة على القاع. نار؟ نيران عديدة يَشْوون عليها الموتى بطريقة فنية تكاد تكون طقْساً. يشعلونها بأعصية طويلة، وبها يحركونها عندما تخبو. حول النار التي ستلتهم موتاهم يتحلَّقون بتبجيل وصمت، وكأنهم يخشون أن يسمع الميت ما يفكِّرون به. ومثلهم أفعل مذهولاً. ولكن، ماذا يقرأون في ألسنة النيران المتعالية نحو الغيم؟ وما هو السر الذي يجعلهم يُبْقونها مشتعلة باستمرار؟ لماذا يسيطر اللون الآجريّ الأحمر على ضفة نهر الموتى المكرّسة للحرق؟ ولماذا كل هذه التجمّعات البشرية في فناء «معبد الموت» الذي يهيمن على مراسيم الوداعات الأبدية؟ ومَنْ هم هؤلاء الناس؟ وكيف يلتقي مَنْ بمَنْ؟
بعضهم يَشْوي أهله على الجمر، وآخرون يقيمون ولائم شواء لذيذ بالقرب منهم. يلتهمون الطعام الباذخ ولعابهم يسيل. شهوة الطعام تُعميهم عن رؤية حزن مَنْ حولهم؟ لا! إنها تجعلهم يقاومون الموت، يقاومونه بنَهَم لا يرتدع. وأنا؟ أنا أتنَقَّل مذهولاً بين جموع الأكَلَة الشرهين، متملّياً شهيتهم الغريبة، وبين جموع الحَرّاقين الذين يحرسون موتاهم المطْروحين على أعمدة النيران الملتهبة، صامتين، أمرّ. أمرُّ، وأُعاود المرور، من جديد. لا عويل، ولا نَدْب، ولا دموع. مشهد الوداع الأخير عندهم: صمت. وهو ما يعيدني إلى سهول الجزيرة، وندّاباتها الوقحات، اللواتي يملأ عويلهنّ البَرّ حتى على مَنْ لا يعرِفْنَهم!، يذكرني المشهد الصامت، أيضاً، بالنَدّابين العرب الذين «يذرفون كلمات الوداع» البليدة على مَنْ لا يهمهم أمره إنْ كان ذا شأن، بدلاً من أن يطهّروا أنفسهم من الزيف. وأدير ظهري لأبتعد عن المشهد، غارقاً فيه، وأنا أتساءل: إلى أيّ حُقَب يقذف بنا الفكر حينما نخاطر بالتفكير؟
في فناء «معبد الموت»، هذا، المليء بالحياة تجذبني جموع البشر السائرين بلا مبالاة، وهم يلبسون أجمل الثياب. لكأنّ الموت بالنسبة إليهم هو الشكل الأسمى للوجود. وإلاّ كيف نُفسِّر هذا البذخ المتمادي في المآكل والملابس والتزيّن والنظرات والحركات؟ ولِمَ تراني أقف عارياً في مشاعري، أُحَدِّق بشغف طاغ في المرأة التي تلبس الساري الأحمر، وهي تنحني بغواية لتنفخ النار الملتهبة، وكأنها تريد أن تشعل نار قلبي؟ رشاقتها ولونها الخمري اللذيذ ونعومتها وحركاتها الغاوية تأسرني فعلاً. وأجدني، بالقرب منها، أجثو على القاع، متربِّعاً بين الجالسين على الأرض بعفوية، ومثلهم ألْقُط عوداً طويلاً أحرِّك به النار! هنديّ من «الجزيرة السورية» في النيبال.
***
في السوق الشعبي في «كاتْمانْدو» أرى البؤس الكوني في حالته الخالصة، وأخاف. أتذكَّرني قديماً، يوم كان «البؤس» الذي أعيشه لا يعني لي شيئاً سوى كوني حافياً، وجائعاً، وشبه عار، ولكن بلا مآسٍ. وهو ما كان يملأ نفسي بأمل غامض سيتحقق ذات يوم. لكن بؤس النيبال الذي أراه، الآن، لا يوحي بمثل ذلك الأمل. لكأنه «بؤس نهائي»! أو هو«البؤس» في حالته المستقرّة تاريخياً. وهو ما يبعث على الشعور بشؤم طاغ، يجعلني أُعيد النظر بنظرية «سعادة البؤس» المحتملة التي كنتُ أتغنّى بها، أحياناً، إنْ لم أكن أشعر بأنني أفتقدها بصدق. واليوم، يتأكّد لي، بشكل واضح، أن البؤس شيء، والبائسين شيء آخر مختلف تماماً. لا مجال للخلط، بينهما، أو للربط. في هذا الجو المتخم بالرَّهق والبؤس والمعاناة، أقضي طيلة اليوم غاطساً في هذا المشهد المجحف بحق الإنسانية. ولكن أيّ مشهد آخر غيره، يمكن أن يكون جديراً بالوجود، أكثر منه؟ وكيف يحق لنا أن ننزع مشاهد البشر لكيْ نستبدلها بغيرها، دون أن نهتمّ بما يفكرون به هم؟ ألا يكفي أننا خارج المشهد؟
بعد يوم مفعم بالمشاهدات أعود إلى مقهاي المفضَّل في كاتماندو، والذي ألِفْته منذ وصولي. أجلس وحيداً بين الساهرين. أحاول أن أهتمّ قليلاً بنفسي علّني أخلِّصها مما رأت. وأكاد أضحك من ضحالة المشروع، وأنا أُناكِد حالي: «إذا كانت مرائي الآخرين، وحدها، تعتبر مكابدة وعناء عندي، فكيف لي أن أستطيع الحياة مثلهم لو كنت واحداً منهم»؟ ولكنني لست منهم. ولكنني منهم. مشاهداً ما أرى بعمق، ومنفعلاً به، يجعلني أشاركهم بمشاهد وجودهم القاسي. ومشاهد كاتماندو لا تُنسى. ولكن لا بد من نسيانها، حتى لا تتمكَّن مني فيغدو التخلّص منها مستحيلاً.
***
في بحثنا عن معبد «سِنْجا دورْبار»، سنتخطّى حُفَراً وأحجاراً وميازيب. الطرقات مهشَّمَة، والبشر يتعثّرون في مسيرهم، ومع ذلك لا ينقطعون عن المرور. ألوان ثيابهم الحُمْر والصُفْر الفاقعة تشعّ بفعل نور الشمس الساطع. شمس الصباح الباردة مثل كتلة وَهّاجة من الثلج. يمشون دون أن يأبهوا بي، أو بما أكتب، مع أن الكثيرين منهم يقفون لصقي، ينظرون إلى يدي التي تمسك القلم، ويروحون يتابعون حركاتها العُصابية، أو التي تبدو لهم كذلك، مسرعة من اليمين إلى اليسار، ثم يمضون دون صوت. الرجل الذي يقود عنْزاً شَهْباء، بلون «حَلَب»، هو الذي سيقف لصقي طويلاً متفحِّصاً كل شيء بما في ذلك وجهي وعينيّ، وبه رغبة جامحة لمعرفة المزيد. لكنّني سأُراوِغه مصطنعاً حركات بلا معنى. أريده أن يبتعد عنّي، قبل أن يبعدني هو عن نفسي.
النيبال، عالَم آخر لم أرَ له مثيلاً من قبل، ولا حتى في «كالكوتا» عاصمة منطقة البنغال الهندية. معابدهم الصغيرة، ولكن الفاخرة، مبنية في الشوارع أحياناً، وأحياناً فوق قمم الهضاب العالية. الدخول إليها حر، وكذلك الخروج منها. يَتَبَرَّكون بأقل الأشياء شأناً، حتى بقشرة من الخشب. ويقفون بخشوع عميق لصق جدران المعابد، وكأنهم يحاذرون من ولوجها السهْل. ومن بعد، يسيرون مبتهجين بالرغم من البؤس الكاسح الذي يعيشونه. وأكاد أسألهم: لماذا لا أرى تَجَهُّماً، ولا غلالة من العبوس؟ هنا لا عَبَسَ ولا توَلّى. وأتصوّر أن ثمة سراً دفيناً وراء ابتساماتهم العفوية الأليفة، أو التي تبدو لي كذلك. ما همّ، أنا سعيد بما يبدو من مظهرهم الطافح بالبشر، حتى ولو لم يكن يعبّر عن «الحقيقة». ولكن ما معنى «حقيقة خفيَّة» لا أراها، ولا أحسها، وإنما أفترضها كعربيّ كئيب؟
بؤس العالَم شيء، وبؤس العالم العربيّ شيء آخر. إنه بؤس زائف، أو إذا أحببنا: بؤس زَيّفه القمع والدين. أو السياسة والقَداسة. وهما خاصَّتان متأصِّلتان في المجتمع العربي العريق. أقصد الذي يقوم على دعائم أخلاقية ذات بُعْد دينيٌ ليس التحرر منها سهلاً. لكن هذا التحرر المُبْتَغى صار، اليوم، ضرورة منطقية لكي نتقدًّم قليلاً. أمّا الكثير فيقتضي أركاناً أخرى. البائس العربي الذي نصادفه في شوارع المدن العربية العريقة تاريخياً، مثل القاهرة أو دمشق، أو تونس، أو طنجة، على سبيل المثال، هو ملك هنا. وهو ما يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن لعربي أن يكون بائساً، والعالم العربي متخم بالتاريخ والثروة والإمكانيات اللامحدوة؟ لكن «نسبية الأوضاع» تجعل كل شيء ممكناً. هكذا تضمحل، أمام هذه «النسبية الافتراضية»، كل طاقات العالم العربي الحقيقية، حتى لنكاد نصفه، فعلاً، «بالفقير».
***
في النيبال، الحياة تغلي. البشر والحجر والأحياء الأخرى كلهم يتزاحمون. كل شيء في حُمّى حركيّة لا تهدأ. القذارة جزء أساسيّ من هذا المشهد الإنسانيّ العارم. مع ذلك، لا أحد يمكن أن يشرح لي لماذا كل هذه الحركة المستمرة، وهذا الزحام الكوني الآسر، فوق هذه البقعة المحدودة من الأرض، وأكاد أقول بهذا الشكل اللامعقول. لكن المشاهِد مُتْرَف حتى ولو كان له حقّ الامتعاض. وأجدني أتساءل: كيف يستدلّ الكائن على عِشّه في هذه المدينة؟ وهذا السؤال ليس مجازيّاً، أبداً. إنه بالمعنى الحقيقي، تماماً. لأن السكن في عِشّ في كاتماندو يُقارب الترف فعلاً.
الفضاءات الصغيرة حول المعابد هي وحدها التي يمكنني أن أقف فيها مرتاحاً لأكتب. أما الأمكنة الأخرى، حتى تلك التي تبدو لك في البدء خالية، فهي مزدحمة بشكل مريع. وعندما عدت من رحلتي هذه إلى «باريس»، وفي قلب «الحي اللاتيني» المزدحم (أو الذي كنتُ أراه كذلك من قبل) صرت أقف، وأتملّى الفضاء الباريسي «الخالي» حولي، وأنا أردد بأعلى صوتي: «صحراء! صحراء! باريس صحراء بلا بشر»! ذلك ليس مغالاة، ولا منافياً للحقيقة، مقارنة بما رأيت في النيبال. وهو مثال صارخ لأقرّب للقارئ مفهوم الكثرة، هناك . لا شيء في كاتماندو سوى الزحام. لكنه زحام الحياة التي لن ترحم مَنْ لا يغامر في المزاحمة.
***
في سهل منخفض محاط بالجبال من جميع الجهات تقع «كاتماندو». الناظر إليها من علٍ لا يرى سوى الغمام. غمام التلوّث والأبخرة والضباب. أو التلوّث الذي صار في النهاية غماماً. شوارعها ضيقة وملتوية مثل مدينة من القرون الوسطى. في حُفْرة عملاقة في أعماق الأرض سقطت كاتماندو. الجبال فوقها متسلّطة لا تتزحزح، وكأنها تريد أن تحجب عنها الشمس. هكذا ستبدو لي جالساً في حيّها التجاري الشهير: «دورْبا سكويرْ»، في مقهى فوق سطح الطابق الأخير لبناية عالية، حيث المقاهي المشرفة على المدينة، مثل هذا المقهى، والتي لا يؤمها، غالباً، إلاّ السوّاح والعابرون، تقع تحت الشمس مباشرة. ومع أن الشمس والرطوبة سيحرقانك في مكان مثل الذي أنا فيه، الآن، إلا أنك تستطيع أن تحيط بما يمكن لك أن تراه من شكل المدينة ومستوياتها، كما هو حال«دوربا سكوير» الذي تحت أعيننا، الآن.
«دورْبا سكَوَيرْ» حيّ عَجَب. وهو يعدّ من تراث الإنسانية. دمّره، بشكل جزئي، الزلزال الذي حدث في نيبال مؤخراً. أبنيته آجرية حُمْر ذات حضور باذخ، تحسّ أنها أُنْشِئتْ منذ الأزل، وهي لا تزال تحتفظ ببهائها وهيبتها. شوارعه مزدحمة بالزائرين الذي يأتون من شتّى بقاع الكوكب الأرضي. لا سيارات هنا، ولا حرافيش. الشرطة عين بعين. والنوء هو سيد المكان. يمطر أو لا يمطر. في أيّ لحظة يمكن أن تشويك الشمس، كما يمكن أن يغسلك المطر ممّا تراكم عليك من غبار. وتلك ليست مزحة. ففي ساعة واحدة في كاتماندو يمكن أن يتراكم فوقك من المطر ما يعادل عشرة أيام في «قاهرة المعز». ومع ذلك تبقى «دوربا سكوير» روعة إنسانية ومعمارية لا مثيل لها. يا رَحّالة العالَم تعالوا.
العجوز ـ الجثّة، في «دوربا سكوير»، تُقْعي على الأرض بلا فراش. تلتهم حُبيْبات القمح المحمّص بخِفّة شيطانية، وهي تشاجر الفضاء. مظلتها السوداء تحميها من الشمس والمطر. وأقدامها بجلدها العاري الثخين تستقر فوق القاع بثبات. تنظر إلى العابرين، دون أن تميّز أحداً منهم. لكأنهم عيدان صفْصاف تسوقها الريح. يذهبون ويعودن دون أن تهتمّ بهم. إنها تنظر باب المعبد المغلق، أمامها، فقط. لكأنها تنتظر خروج أحد منه. ولكنها منذ متى تنتظر، والمعبد مهدّم ومسدود؟ إزاءها أقف طويلاً مؤمّلاً أن تنظر هنيهة إليّ. ولكن لا. هي لا تنظر إليَّ مع أنها تراني. وأتجرّأ فأجلس قربها، فلا تهتم بي. تظلّ تنظر إلى حيث تنظر. وبعد طول بقاء لصقها، أجدني مثيراً للسخرية، فأغادر، وقد أدركتُ أنها لا تريد أن تسمع سؤالاً مبتذلاً: «مَنْ تنتظرين، يا سيدتي؟ وماذا…؟» يرميه عليها عابر بليد مثلي، فيزعج رصانتها.
***
« مونكي تامبل»، معبد القُرود، وأساطيره. ها نحن نحاول أن نلج فيه. بعد أن نصعد مئات الدرجات، نصل قمة الهضبة العالية التي يستقر فوقها هذا المعبد لكي نلتقي «بأجدادنا المحتملين». من أعلى المعبد نتفَرّج على الكون. العالَم يبدو تحت أقدامنا. نكاد نقفز فيه. ومن حولنا الجبال. جبال وراءها جبال وجبال. جبال تحيط بنا من جميع الجهات. تحيط بنا بتصميم جبليّ آسر. مَنْ يفكّ عن عينيَّ أسْر الجبال؟ ولكن لماذا بنى القدماء هذا المعبد المهيب في هذا المكان، في أعلى قمّة تحيط بكاتماندو؟

بنوه هنا لكي يبتعدوا عن كل شيء: عن النظر، وعن البشر، والشُرور. عن كل ما يمكن أن يُلَوِّث الوجود في عُرْفهم. واليوم يرقى البشر العاديون من أمثالي هذا الجبل المقدّس ليستطْلِعوا ما خبأه الأولون عنهم، دون أن يعثروا على شيء. لأن العاقل يأخذ ما خبّأه معه عندما يذهب. وحده، الأحمق يترك أسراره عرضة للنَّهْب والتبذير. في أعلى القمة الريح ساكنة. الشمس تختفي خلف غمام كثيف. غيوم بعيدة تجوب الآفاق التي بالكاد نرى سماتها. حولي يتحرّك الناس في دوّامة مستمرة مذهولين، وأنا أقف وحدي فوق حجر المعبد المكَدّس فوق الأرض. أكتب بنَزَق عن مشاعر تتلاحق في رأسي كالأمواج العارمة دون أن أستطيع لها لَجْماً. كاتماندو ستغيّرني بلا شك. وأنا جئت إلى هنا طالباً هذا. معبد القرود المقدّس عليك السلام.
***
في معبد « بودا الكبير» شرقاً، وهو الوحيد له في كاتماندو، والذي بُنيَ هو الآخر فوق هضبة عظمى (هنا لا وجود للسهول الممتدة التي نعرفها)، نرى عالَماً آخر مقارنة بالمعابد الأخرى. الحيطان نظيفة ومطليّة بالأبيض. لتمثال «بودا» عينان آسرتان أينما دِرْتَ تجدْهما ينظران إليك. لكأنه يريد أن يحمي الزائرين من عبث الزمان، أياً كان مذهبهم، ومن أي الأصقاع أتوا إليه. «بودا» المهيب يبدو هادئاً وعميقاً. لا يحثّ على الحركة، وإنما على الصمت. لكأنه يدعو الزائر إلى التوقّف أمامه هنيهة، إنْ لمْ يكن إلى الجلوس، لإعادة النظر في حياته التي لا تكفّ عن المرور. ولكن مَنْ مِنْ هؤلاء العابرين يملك نعمة الصبر؟ بالرغم من كثافة المشاعر التي يولِّدها «بودا» في نفوسنا، نمرُّ به بعجالة، مثلما نمرّ بتمثال جميل. لا بدّ أن ذلك يزعجه كثيراً. ولكن مَنْ يقرأ ما تكتبه الأحجار على صفحاتها القاتمة؟
بعد أن نتعب من الدوران في فناء هذا المعبد الباذخ، نجلس في مقهى «العين الذهبية». وهو مقهى يسيطر من علوّه الشاهق على مدى الكون الذي نحن فيه. هكذا نصير نرى الانخفاض الأرضي العميق الذي تقع فيه كاتماندو. لكأنها تسقط في قلبه دون أن تدري. ولا بد أن الجبال العملاقة التي تُسوِّر الفضاء حولها تزيد انبهار الناظر إلى هذا المزيج الجيولوجي المتخم بالغرابة. في البعيد نرى، كذلك، غمام جبال «الهيمالايا» الأزليّ. حتى الغيم يبدو وكأنه في متناول أيدينا، وعَمّا قريب سنلمسه. عالم لا مثيل له فوق الكوكب الأرضي، هذا الذي أراه الآن. ولربما كانت هذه هي حال العوالِم الأخرى التي لم أرها، بعد. واقفين، هنا، في هذه النقطة التي نحن فيها، الآن، فوق قُبّة الكون، يغدو النظر سيّد الوجود، وملهم الرغبات. هو الذي يقودنا إلى المجهول. يقذف بنا إلى أبعاد خرافية الجمال نراها دون أن نتمكَّن من التحقق ممّا نرى. واكتشاف هذا المجهول الذي يحطِّم قلوبنا من الشوق، سرعان ما يغدو، هو الآخر، رغبة لا تُقاوَم. وفجأة، تبدو الحياة ممتلئة وسعيدة. ولا نعود نحس بضغط نفسيّ كبير، ونحن نحاول أن ندرك ما لا يمكننا إدراكه: الروعة الباهرة التي تملأ عيوننا، الآن.
***
هذا المساء العالَم، كله، في كاتماندو: المشاة والحُفاة وراكبو الدراجات ومتسلِّقو الجبال وحاملو الرُّقَع والهدوم والزاحفون على القاع والآخرون، وأنا. أنا أمشي بهدوء، وكأنني أدركت، أخيراً، نهاية الكون. أتحرّى الوجوه. أتابع الحركات. أتصوّر الكثير من المواضيع بصمت. في قلب الجَمْع المتلاطِم أقف مفكِّراً في أحوال مَنْ أرى: ينظِّفون القاع حول دكاكينهم البائسة وكأنهم يسكنون قصوراً فاخرة. يعتنون بذرات الغبار المتطايرة، وكأنها التِبْر. يرشّون التراب بالماء الخفيف لئلاّ يزعجوا وجه الأرض التي سيَقْعون فوقها مثل طيور منهكة. الغبطة بالنسبة إليهم، كما بدا لي، هي نظرة إعجاب ممّنْ يمرّون بهم عابرين. هُمْ يحبون حياتهم بقَدْر ما نكره نحن حياتنا. هذا ما خطر لي واقفاً في النقطة، نفسها. ولكن، منذ متى؟
نحن نتكلم كثيراً، وهم لا يتكلمون. يسمعون بعيونهم أكثر مما نسمع بآذاننا. وأدرك، بشكل واضح، أننا «بعد أن تعلَّمْنا الكلام، علينا أن نتعلَّم الصمت». ولأول مرة، أفهم، أو أكاد، مغزى هيئة بودا المُتَكتِّمة، وسُكوته الأزليّ، وغموضه العميق. ويلوح لي، عَبْر هذه الأبعاد المختزنة في تماثيله، دوره الكبير في هذه العملية الأساسية في الوجود: الصمت! فجوهر الوجود يتأرجح، مهما فعلنا، بين الصمت والكلام. وهو ما يجعل، ربما، شكل الحياة عندهم على غير ما هو عليه عندنا. هنا يعيشون ببساطة، وبقَدْر ما يستطيعون. لا بهرجة، ولا زخارف، ولا أقانيم. تأتي الحياة على راحتها، وتذهب كما تأتي. يصرفون ما في الجيب، وهم يعرفون أن ما في الغيب لن يأتي. ليس في عرفهم أساطير غيبية. ما يملكونه هو وحده الممكن. ولذا عليهم دائماً أن يطلبوا المزيد.
في كاتماندو مرَّتْ أيامنا بسرعة مثل برق لامع في ظلام الوجود. غداً سنرحل عنها، ذاهبين باتجاه « بوكارا»، أو «بخارى» النيبالية في الشمال العالي، حيث الجبال الأسطورية تتحَكّم في مصير الكون. ولَكَمْ يؤلمني أن أترك كاتماندو وحيدة.
***
السادسة صباحاً، نصل الباص الشعبي الذاهب إلى «بوكارا». باص مُكلَّل بالصور والتخاريم، يقف بين عشرات من الباصات الأخرى الذاهبة، كلها، إلى نفس المكان. كلها، تنطلق متتابعة في نفس اللحظة، ولكن دون تسابق أو فهلوة أو ألاعيب. الرصيف ممتلئ منذ الفجر بالباعة الجوّالين، والمطاعم المتحركة، والمقاهي المحمولة، والورود الاصطناعية، والهدايا البلاستيكية «صُنِع في الصين». كل شيء صُنِع في الصين بما فيه الكائنات! هذا ما تكاد تؤمن به هنا. لكن تلك مجرد أغراض، أغراض حياة يومية ستذهب هباء أينما صُنِعتْ. يكفي أن تعتمد على خيالك المتحفِّز لترى الكثير مما لم يصنع في أيّ مكان. هنا ستكتشف سرّ الوجود الذي يخترع وسائل ديمومته. وكما في أمكنة أخرى، من قبل، ستدرك، أن للوجود أنماطاً متعددة، وأبعاداً. ففي الوجود، وهو الوجه الآخر للحياة، كل شيء ممكن، بما في ذلك ما لا نتخيله، ولا نعرف صَانعه.
على الطريق القصير جغرافياً، ولكن الطويل جداً زمنياً، سنعيش «على قلق» كبير، إذْ يلزمنا 14 ساعة، لِكيْ نقطع مسافة 200 كيلومتر، تقريباً. على هذا الطريق المعلّق في الريح ستتتابع، وتتعاقب، مجرّات من البشر والتلوّث والغمام. وأنت تمر في هذا القُمْع المحشو بما تعرف وما لا تعرف، تكاد تتساءل عن معنى النظافة وضروراتها. عن لزوم إشارات المرور المعدومة كلياً، هنا. عن مسوِّغات الطرق السريعة، والباص بالكاد يزحف كالأفعى الجريحة، عاوياً من شدّة الإرهاق، وهو يتَهزْهَز فوق الصخور صاعداً نحو السماء. طريق الرعب هذا يدَوِّخ الناظر حوله: مسافات «ميليمترية» بين باصات مفعمة بالبشر الصامتين، وكأنهم ينتظرون حتفهم. ممرات ضيقة لا تتسع للماشي، فكيف بباص مملوء بالمسافرين، وهو يترَجْرَج كالسكران. التواءات أجنحة السفوح الأسطورية بلا إشارات تدل عليها، تجعل السقوط في أعماق الكون محتمَلاً كل ثانية. تجاعيد قمم الجبال الخارقة تكاد تدفع الباص نحو الحضيض. و… وأخيراً، انعدام أي إمكانية للإنقاذ عند الضرورة. كل ذلك يجعلنا نحس أننا نرقص فوق «رؤوس ثَعابين» الجبال.
الجبال لا تُغيّر منظر الفضاء الذي يحيط بها، فحسب، وإنما تفرض على مَنْ يغامر بارتيادها معرفة قوانين اجتيازها. هي، أيضاً، تُحدِّد السرعة الممكنة للعابرين، وتملأ نفوسهم بغواية التَهيُّب والصبر. تعلّمهم، كذلك، اختبار المشقّة. إنها سيدة الوجود في عالَم، مثل هذا،لا يتحمّل الخطأ، ولا يناسبه التسرّع وقلّة الحيلة. يذهلني طريق الجبال الملتوي، هذا، مثل ظهر ثعبان ينام. يذهلني لأسباب كثيرة تتعلّق بالصحراء الأولى ربما. يذهلني من ضيقه، ومن علوّه، ومن هشاشته، ومن نُقَره المخيفة وكأن فُؤوساً عملاقة حَفَرَتْها. وكذلك من انهدام حواشيه، وتَهَشُّم أطرافه، ومن الموت المحتَمل عند أيّ هفوة يرتكبها «الباص» المعذَّب، مهما كانت صغيرة.
فوق هذا الطريق الذاهب إلى السماء رأساً، تتتابَع الباصات المطهّمَة مثل خيول أصيلة، وتتمارر بجلال. وأحسُّني أنغمس في دوّامة الوجود الجبليّ الآسرة، هذه، حتى لأكاد أنسى أنني لست من أهل هذه الأرض. وأنني ليس إلاّ أحد العابرين. ولست هنا إلاّ من أجل الوصول إلى حيث أريد. لكن مقولات العالم، كلها، لا تجدي شيئاً في حضور هذه العنجهية الكونية التي بلا حدود. وأحس أنني أنسى كل شيء. كل ما كنته، ذات يوم، ومَنْ. وأصير أراني جزءاً من المشهد العام. أبدأ الالتزام بما يتطلّبه الوضع من حذر ونباهة، وإنا أحبس أنفاسي المتسارعة، واضِعاً كفّي على فمي لئلاّ أشهق عندما نسقط من علٍ. وفجأة، أصرخ صامتاً: أُنظُرْ! أُحَرِّض نفسي على الإبْصار! وأجدني أهجم على آلة التصوير لأخلِّد المشهد. وسريعاً أدرك الفرق الشاسع بين الواقع والصورة. فأكفُّ عن التصوير، فوراً، حتى لا أُشوِّه ما أرى، وأعود إلى «كتابة الكون» كما أحسّه وأراه.
***
أخيراً، ندخل في الروعة. ندخل في قلب الوادي العميق. الوادي الخاتل بين القمم، وتحت الصخور العملاقة، حتى ليبدو مثل بول البعير في بادية الشام. شيئاً فشيئاً نخلِّف الجبال الأسطورية وراءنا، ونراها تطير بعيداً مع الغيم. عندما نحط في قلب القاع، نصير نرى أحجار المسيل البيض ترتصّ بأناقة وسكون، ليترقْرق فوقها الماء. الماء أبيض. التربة بيضاء. وسفوح الجبال التي غدت بعيدة حُمْر ومشوية. ولأول مرة، منذ أن بدأنا الطريق، أحسسنا، بالقرب من المسيل، أننا عدْنا بشراً بعد أن كنا طيوراً.
من قلب الأرض أتطلّع إلى الجبال التي ارتفعت إلى السماء بعد أن هبطنا إلى الحضيض، وأرى جَمالها الذي لا يُقارن. تُدوّخني روعتها عن بعد، أكثر مما فعلت بي من قرْب. لماذا الجبال؟ لأن السهول تكاد تكون معدومة في نيبال. ومنذ هبطنا القاع، أصير أرى، ليس بعيداً عن مسير الباص، أرى النُهَيْر الصغير يجري بهدوء أصمّ، ونحن نتابع بمحاذاته سيرنا البطيء. وفي خُتولي، أمعن النظر الصامت إلى كتلة الماء المتلألئة وهي تتكَسَّر على الصخور التي تعترض جريانها دون أن تستطيع قهرها. وأدرك أن الماء أقوى عناصر الطبيعة على الإطلاق. الماء الذي سيغيّر مزاجي وأخلاطي، سيجعلني أتَقرّب إلى الكون أكثر ممّا كنت أفعل. مجرّد رؤية النهر المتهادي بغبطة نحو مصبّه، ستملؤني بشغف آسر للعودة إلى حيث كنتُ. فأحسُّ أن الدم تَغيَّر في قلبي، وغدا النوء رطباً ونعوشاً. فضاء مذهل فضاء نيبال هذا الذي لا شبيه له. وأنا أقول هذا أشعر بالعجز والأسى، لأنني لا استطيع أن أنقل المشهد الذي أراه بما يستحق من الجلال والروعة. وأجدني أتساءل بخيبة أمل كبيرة: لماذا ليس للكلمات عيون؟
***
نحن الآن في «بوكارا»، في أعالي جبال «الهيمالايا». «بوكارا» كانت مقطوعة عن العالم حتى عام 1920. من قبل لم يكن الوصول إليها ممكناً إلاّ سيراً على الأقدام، أو برفقة حيوانات النقل الحصيفة: الحمير والبغال. «بوكارا» مدينة تختلف عن مدن النيبال الأخرى. تحدّها من الجنوب بحيرة «فيوا» الرائعة، ومن الشمال سلاسل الهيمالايا المخيفة المتعددة الارتفاعات. إذْ ننتقل من 1000 متر فوق سطح البحر بالقرب منها، إلى ارتفاع مذهل يقارب 7500 م، كما في قمم جبال «دهولاجيري»، على بُعْد عشرين كيلومتراً منها. حول البحيرة الهادئة والجميلة سنمشي ساعات. وعندما نصعد الجبل العالي فوقها ستبدو تلك البحيرة الواسعة مثل نقطة في بحر من اليابسة.
السيارة الصغيرة التي نستقلّها لكي نصل إلى القمّة من ماركة «تاتا» الهندية. وهي سيارة «كرتونية»، في الحقيقة، لكنها تدرج برغم كل الصعوبات التي في طريقها. ستنقلنا من بطن الأرض إلى ظهر الجبل العالي، حيث «المعبد البوذي» الساطع البياض، «معبد السلام»، يطل من السماء على جورة «بوكارا». معبد آسر، آيته التواضع والصمت، يهيمن بأبَّهة فوق العالَم. أحسُّ أن عالم النيبال يستحق أكثر مما أقول، لكنّني أعترف بأن الكتابة عاجزة عن التعبير عمّا أشعر به في كل لحظة. لا بد من مسافة ما تساعدني على تمثّل الروائع التي هي الآن في عينيّ. سأحاول، إذن، بكل طاقتي، أن أقترب أكثر ما يمكن من مشاهد هذا العالم الشديد الإثارة.
غداً صباحاً سنغادر «بوخارا»، أجمل المدن في نيبال. سنترك خلفنا البحيرة الهادئة المليئة بالأسرار. ستغيب عنا وجوه النيباليين المبتسمة باستمرار. ولا نعود نرى أسراب الغربان التي تحوم في فضائها سعيدة، وهي تصرخ في الأعالي معلنة عن غبطتها بالوجود. سنفتقد الأبقار الوقورة وهي تستلقي بجلال فوق أسفلت الطريق الساخن، تنظر المارة بعيونها المدوّرة العريضة بلا اهتمام. تراقب الفضاء وهي تجتَرّ بحركات آلية مَوْزونة، ما خبَّأتْه في بطونها من قبل. السيارات تتحاشاها، ولا يزعجها أحد. هي سيدة المكان بامتياز، حتى ليكاد العابر أن يتمنى لو كان مبجّلاً مثلها.
***
أسافر بكامل أناقتي وكأنني ذاهب إلى لقاء آسر. غداً سنبدأ الرحيل، من جديد. سنستقلّ الباصات العملاقة ذات الأنين الرخيم، وهي ترقى الجبال جاهدة. ترقاها واحداً إثر آخر. من بطن الأول إلى سفح الثاني، إلى ظهر الآخر، ومن بعد، إلى قمّة الأخير. تتَشَلْبى الأعالي مثل ثعبان خرافي من حديد. تمرُّ من مخارز الجبال، تجتاز أطواق السفوح، لتصل إلى أعلى قمة في البلاد. لقد تعلَّمَتْ من الحمير كيف تَدْبي، نافخة دخان صدورها وهي تتَجَشّأ من ثقل الحُمول. حُمول ملوّنة وثقيلة تكفَّلتْ بإيصالها إلى أمكنتها المأمولة مهما تكن الظروف. تحسّها، وأنت فيها، تفهم ما أنت فيه. تفهم حالة التوتّر والهَيْب عندكَ منذ أن تَتبدّى لك الدروب المحفورة في الحجر والطين. تكاد تلقي عليها السلام قبل أن تدخل في أحشائها المحشوّة بالبشر والهُدوم، لكنك قبل أن تزفر الكلام تبْلع الصوت مع ريقك الذي جفّ من الخوف. فتأخذ مكانك صامتاً، وأنت تستحضر «بوذا» قدّس الله سرّه، راجياً ألاّ يسقط الباص في الحضيض عند أول زلَّة من إطاراته المهترئة. ومنذ أن تجلس، تغمض عينيك، وأنت تملأ رئتيك هواء، قبل أن تقتحمها عندما يتحرّك الباص لئلاّ يفوتك شيء من الطريق.
سنمرّ تحت الغيم بقليل. وسيبدو لنا، من السماء، عالَم القاع صغيراً، مبعثراً، لا قوام له. مشاهد السفر الذي تسقط في عيوننا، الآن هي، وحدها، التي نراها بمتعة ووضوح. ومنذ أن تمرّ، تغدو ذكرى، على الفور. ذكرى بعيدة حتى ليمكننا أن نكتب حولها شِعْراً. العالَم في السفر لا يتوقف عن المرور، وهو ما يبعث على الكآبة، والأسى. لكأنك وضَعْتَ، منذ لحظة، حياتك كلها فيه، وها أنت ذا مضطرّ إلى هَجْرها بالرغم منك. ماذا سيحدث لو توقَّف الكون لمحة، لنملأ نفوسنا منه قبل أن نفقده إلى الأبد؟ لكن ذلك هو المستحيل. وهو ما يدفعنا لكَيْ نسافر، باستمرار، مستَكْشفين الكون صورة تِلْوَ أُخرى، إلى آخر الوجود. ألهذا أجدني مدفوعاً بقوة لكي أصوِّر الأمكنة والكائنات التي تشدّنى، وكأنني أريد أن أضعها في قلبي؟ وعندما لا استطيع يملأ الحزن نفسي، وكأنني فقَدْتُ شيئاً عزيزاً.
***
السفر عرس كوني.
فيه تتغيّر خلائطنا. كل مكوّناتنا العميقة تتغيَّر في السفر: الرؤية، والمعرفة، والأخلاق. وكذلك، تتغيّر ألْسِنتنا، ومشاعرنا. عندما نسافر، نحسّ أن مداركنا تَتَفَتَّح على الكون، وفيه، مثل زهرة بلَّلَها ندى الفجر في الجزيرة، نشعر أن العالم ينفرش أمامنا، تلقائياً، مثل كتاب ثمين، لا لنقرأ أسراره، فحسب، وإنما لنكتب على صفحاته ما لم يكن يخطر لنا، ونحن في ديارنا، على بال. وعندما لا نسافر، ننغلق على ذواتنا، نصير منذورين للثرثرة، والمماحكة، واللَّغْو. «السفر»، إذن، ليس مسافة تُقْطَع، فقط، إنه تلقيح وَعْي المسافر بمكوِّنات جديدة، لا ِقبَل له بها، مقيماً. والكتابة عنه، عن السفر، وبتأثيره، ليست كلمات، فحسب، إنها شَغَف، ومعرفة، وأحاسيس. بواسطته، وعَبْره، نكتشف «ميتولوجيا الأمكنة»، أو لنقُلْ تتجلّى لنا أبعادها الميتافيزيقية الكامنة في ثناياها، في ثنايا الأمكنة التي كنا نجهلها، تماماً، إلى أن رأيناها. وهي ميثولوجيا حسيّة، ذات أبعاد آسرة، لا تُدرَك خارج فضائه، ولا يمكن الإلمام بخفاياها بمعزل عنه. السفر، من هذه الزاوية، جدير، أو هذا هو المأمول منه، بأن ينقل الكائن من حال إلى حال، مهما بالَغْنا بأهمية القراءة مقيمين. فكما يقول «الهمداني»: «مَنْ أضحى سائراً في الأرض، أمسى إماماً».
سافروا! تَروا العالَم كما لم تروه أبداً، من قبل.
كاتب وجراح من سوريا مقيم في باريس والنص من كتاب قيد الطبع تحت عنوان: «أنـــا مكـــان»