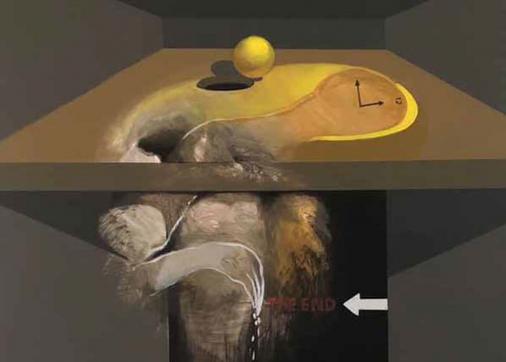عندما يتحول الشعر إلى معبد والناس إلى مصلين

كنت في سهرة في بيت رئيس حكومة السودان محمد أحمد المحجوب في الخرطوم، وكان معظم من فيها من الكتاب والصحافيين والشعراء، وحتى الوزراء الذين كانوا أعضاء في حكومته كانوا شعراء: يحيى الفضلي وزير التربية، عبدالماجد أبوحسبو وزير الإعلام، محمد عبدالجواد وزير الأشغال العامة، وكان من أصبح وزيرا للخارجية اللبنانية جان عبيد، جاؤوا على ذكر نزار قباني (فتنطح) المحجوب الذي عادى الشعر الجديد معاداة شديدة مثله مثل العقاد، وصالح جودت، وكامل الشناوي -صديقه الأثير- وقال لا يعجبني شعره، يعجبني نثره، فهبّ الحاضرون دفاعا عن نزار حتى وزراؤه، وحتى محافظ البنك المركزي السوداني الذي كان بين الحضور، ومعه الممثل الشخصي للملك الحسن ملك المغرب أحمد بن سودة، الأمر الذي جعل المحجوب يرفع كلتا يديه مستسلما وهو يقول: سوف ندعوه لزيارة السودان لعلني أرى فيه ما ترونه، وأردف قائلا: محمدية تول أنت الأمر واحمل الدعوة إليه مع صلاح محمد صالح. (صلاح شاعر ووالده هو الشاعر الذي وضع النشيد الوطني السوداني وكان صلاح سفير السودان في بيروت وقتذاك) وتم الأمر بسرعة، وأخبرت نزار فور وصولي إلى بيروت، وقلت إن السفير سوف يحمل الدعوة إليك خلال أيام، وهذا ما تم، وحزم نزار حقائبه وسافر إلى السودان، وقد سبقته بيوم إلى هناك.
وفي السودان كانت فرحته الكبرى، وكانت البهجة التي غمرت كيانه كله، ولو حكى لي نزار ما حدث له لما صدقت، ولكنني شاهدت ذلك بأمّ عيني هذه، كما يقولون.
استقبل نزار بحق استقبال الفاتحين، وأعتقد أن نزار لم يشهد طوال عمره شيئا مما رآه في السودان، كنت أتمنى أن يكتب نزار شيئا في مذكراته عن هذه الرحلة، ولكنه كتب غزليات نثرية في الخرطوم من أجمل ما كتب، لأنه أُعجب بالسودان أيّما إعجاب لا سيما وأنه وجد الشعب السوداني معطونا في حب الشعر والغناء والطرب، فكتب في حق السودان كلاما جميلا لم يكتبه أحد غيره، حيث قال:
“نصف مجدي محفور على منبر “لويس هول” و”الشابل” في الجامعة الأميركية في بيروت، والنصف الآخر معلق على أشجار النخيل في بغداد، ومنقوش على مياه النيلين الأزرق والأبيض في الخرطوم، طبعا هناك مدن عربية أخرى تحتفي بالشعر وتلوّح له بالمناديل، ولكن بيروت وبغداد والخرطوم تتنفس الشعر وتلبسه وتتكحّل به، إن قراءتي الشعرية في السودان كانت حفلة ألعاب نارية على أرض من الرماد الساخن.
في “دار الثقافة” في أرض أم درمان، كان السودانيون يجلسون كالعصافير على غصون الشجر، وسطوح المنازل، ويضيئون الليل بجلابياتهم البيضاء، وعيونهم التي تختزن كل طفولة الدنيا وطيبتها.
هذا الذي يحدث لي ولشعري في السودان شيء خرافي، شيء لم يحدث في الحلم ولا في الأساطير، شيء يشرفني ويسعدني ويبكيني، أنا أبكي دائما حين يتحول الشعر إلى معبد والناس إلى مصلين، أبكي دائما حين لا يجد الناس مكانا يجلسون فيه فيجلسون على أهداب عيوني، أبكي دائما حين تختلط حدودي بحدود الناس فلا أكاد أعرف من بنا الشاعر ومن بنا المستمع، أبكي دائما حين يصبح الناس جزءا من أوراقي، جزءا من صوتي، جزءا من ثيابي، أبكي لأن مدينة عربية، مدينة واحدة على الأقل لا تزال بخير، والسودان بألف خير، لأنه يفتح للشعر ذراعيه، كما تفتح شجرة التين الكبيرة ذراعيها لأفواج العصافير الربيعية المولد.
السودان ينتظر الشعر كما تنتظر الحلوة على النافذة فارس أحلامها، يأتي على صهوة جواده حاملا لها قوارير العطر وأطواق الياسمين، ومكاتيب الغرام.
السودان يجلس أمام الشعر كما تجلس الأم أمام سرير طفلها تغمر خديه بالقبلات وتطمعه حلاوة اللوز والسكر.
السودان يلبس للشعر أجمل ما عنده من الثياب ويذهب للقاء الشعر كما يذهب العاشقون إلى موعد غرام.
السودان بألف خير، لأنه ربط قدره بالشعر، بالكلمات الجميلة، الكلمات جنيات رائعات الفتنة، يخرجن مرة من عتمة الظنون، ومرة من عتمة الدفاتر، الكلمات طيور بحرية تخترق زرقة السماء دون تأشيرة، ودون جواز سفر، لم أكن أعرف -قبل أن أزور السودان- أي طاقة على السفر والرحيل تملك الكلمات، ولم أكن أتصور قدرتها الهائلة على الحركة والتوالد والإخصاب، لم أكن أتخيّل أن كلمة تكتب بقلم الرصاص على ورقة منسية قادرة على تنوير مدينة بأكملها، على تطريزها بالأخضر والأحمر، وتغطية سمائها بالعصافير.
أشعر بالزهو والكبرياء حين أرى حروفي التي نثرتها في الريح قبل عشرين عاما تورق وتزهر على ضفاف النيلين الأزرق والأبيض.
هذا الذي يحدث لي ولشعري في السودان شيء لا يصدق، وهو شهادة حاسمة على نقاء عروبتكم، فالعربي يرث الشعر كما يرث لون عينيه ولون بشرته، وطول قامته، ويحمله منذ مولده ويحمله كما يحمل اسمه وبطاقته الشخصية.
مفاجأة المفاجآت لي كانت الإنسان السوداني، الإنسان في السودان حادثة شعرية فريدة لا تتكرر، ظاهرة غير طبيعية، خارقة من الخوارق التي تحدث كل عشرة آلاف سنة مرة واحدة، الإنسان السوداني هو الوارث الشرعي الباقي لتراثنا الشعري، هو الولد الشاطر الذي لا يزال يحتفظ دون سائر الإخوة بمصباح الشعر في غرفة نومه، كل سوداني عرفته كان شاعرا أو راوية شعر، ففي السودان إما أن تكون شاعرا أو أن تكون عاطلا عن العمل، فالشعر في السودان هو جواز السفر الذي يسمح لك بدخول المجتمع ويمنحك الجنسية السودانية، الإنسان السوداني هو الولد الأصفى والأنقى والأطهر الذي لم يبع ثياب أبيه ومكتبته ليشتري بثمنها زجاجة خمر، أو سيارة أميركية، هو الإنسان العربي الوحيد الذي لم يتشوه من الداخل ولم يبع تاريخه بفخذ امرأة أبيض تسبح على شاطئ “كان” أو “سان تروبيز″.
ها أنذا مرة أخرى في السودان، أتعمد بمائه، وأتكحّل بليله، وأسترجع حبا قديما لا يزال يشتعل كقوس قزح في دورتي الدموية، عرفت في حياتي وفي رحلاتي كل أنواع اللآلئ البحرية، عرفت اللؤلؤ الأبيض، واللؤلؤ الرمادي، وعرفت اللؤلؤ الأخضر، واللؤلؤ الوردي، وعرفت الأوروبي والآسيوي، واللؤلؤ الذي يوزن بالقيراط، واللؤلؤ الذي يوزن بالقصائد والدموع، واللؤلؤ الذي يتدلى على صدور الكواكب و… و… واللؤلؤ الذي يتدلّى على صدور الجميلات.
بعد ثلاثين سنة من الغطس تحت سطح الماء، والغرق في بحار النساء اكتشفت أن اللؤلؤ الأسود هو الأغلى، والأحلى والأكثر إثارة، كما اكتشفت أن الذي يملك مثقالا واحدا من اللؤلؤ السوداني، يمتلك كنوز سليمان، والحور المقصورات في الجنات، ويصبح ملك الإنس والجان.
الحب السوداني ليس جديدا عليّ، فهو يشتعل كالشطة الحمراء على ضفاف فمي، ويتساقط كثمار المانغو على بوابة قلبي، ويسافر كرمح أفريقي بين عنقي وخاصرتي، هذا الحب السوداني لا أناقشه، ولا أحتج عليه، لأنه صار أكبر من احتجاجي، وأكبر مني، صار وشما على غلاف القلب لا يغسل ولا يمسح.
قبل عشرة أعوام جئت إلى السودان ومعي وردة الحب، وقنديل الشعر الأخضر، بعد عشرة أعوام لا أعرف ماذا أحمل للسودان؟، فوردة الحب التي كنت أشكها في عروة ردائي أكلوها، وقنديل الشعر الأخضر الذي كنت أضيء به ليل العرب كسّروه، حتى كلمات الغزل التي كنت أكحل بها عيني وطني صادروها، فالكلمة العربية أدخلوها إلى “الكرنتينا” لا لأنها تحمل جرثومة الكوليرا والملاريا، ولكن لأنها تحمل جرثومة الحرية، والكلام العربي أصدروا بحقه مذكرة توقيف، أحالوه إلى محكمة تهريب المخدرات، حتى الأفعال، والأسماء، والضمائر أخذوها إلى أقبية المخابرات، حتى نون النسوة، أدخلوها سجن النساء.
ها أنذا مرة أخرى في السودان، أبحث عن دفاتر حبي القديمة، ولكن ماذا تنفع العودة إلى دفاتر الحب القديمة، ما دام العاشق قد تغير، والمعشوق قد تغير، والعشق ذاته قد تغير.
ها أنذا مرة أخرى في السودان، فهل يمكنني أن أصرخ هنا كما أشاء وأنزف كما أشاء؟، أنا أعرف السودان جيّدا، وأعرف السودانيين جيدا، وأعرف أن صدورهم كغاباتهم مفتوحة للأمطار والريح، وللبرق والرعد والحرية، لا تؤاخذوني على هذه المقدمة المكتوبة بالحبر الرمادي، فهل لديكم دواة خضراء أو زرقاء أو بنفسجية، تعيروني إياها؟، ومع هذا سأحاول أن أخرج من الصخر ماءً ومن الأرض العطشى عشبا، ومن العتمة نجوما، وسأحاول في قراءاتي الشعرية أن أركز على شعر الحب، لأن الحب في الوطن العربي، هو هذا الطفل اللقيط الذي لا يعترف به أحد، ولا تفتح أمامه الأبواب، ومن يدري ربما أشعل لي السودان قناديل الأمل، وأرجع لي حبي الضائع، وحبيبتي التي ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.
وفي زيارته الثانية للسودان عام 1970، أقام ليلة شعرية بنادي قوات الشعب المسلحة “شارع النيل”، فبعد زيارته الأولى للسودان عام 1968، وعودته إلى بيروت قال لإذاعة “مونت كارلو” إنه بعد لقائه بالشعب السوداني والحفاوة التي قوبل بها لدرجة تسلق العديد من الناس الأشجار ليتمكنوا من سماعه، ظل يبكي طوال الليل لأنه لم يكن يصدق أن هنالك من يقدره مثل هذا التقدير مما زاد من مسؤوليته تجاه الشعوب العربية، وفيما يأتي بعض مما قاله في مقدمة الليلة:
“إنني أعود لآخذ جرعة ثانية من هذا الحب السوداني اللاذع الذي حارت به كتب العرّافين ودكاكين العطارين، إنني أعرف عن الحب كثيرا، سافرت معه وأكلت معه وشربت معه وغرقت معه وانتحرت معه، ونمت عشرين عاما على ذراعيه، ولكن الحب السوداني قلب جميع مخططاتي عن الحب وأحرق جميع قواميسي.
منذ سنتين أتيت إلى السودان حاملا حقائب الشعر والحب، وبعد أن ودّعته وفتحت حقائبي في بيروت اكتشفت ألف عريشة عنب داخل ثيابي واكتشفت على ضفاف فمي ألف ينبوع ماء وألف سنبلة قمح.
حين عدت من السودان منذ سنتين لم يعرفني الناس، كان جسدي قد تحول إلى غابة وكلماتي إلى أغصان وحروفي إلى عصافير.
يسمونني في كل مكان شاعر الحب، ولكنني هنا أشعر أنني أسقط في الحب للمرة الأولى، فالسودان بحر من العشق أغرق جميع مراكبي وأسر جميع بحّارتي.
العشق السوداني يحاصرني من كل جانب كما يحاصر الكحل العين السوداء فأستسلم له وأبكي على صدره وأعتذر له عن صلفي وغروري.
هذا عن العشق فماذا عن الشعر؟، في المرة الماضية اكتشفت أن السودان يسبح في الشعر كما تسبح السمكة في الماء وأن السودان بغير الشعر كيان افتراضي ووجود غير قابل للوجود.
ثمة بلاد تعيش على هامش الشعر وتتزيّن به كديكور خارجي، أما السودان فموجود في داخل الشعر كما السيف موجود في غمده وملتصق ومتغلغل فيه كما السكر متغلغل في شرايين العنقود.
صعب على السودان أن ينفصل عن الشعر كما صعب على الشفة أن تنفصل عن إغراء القبلة.
إنّ قدره أن يبقى مسافرا نحو الشعر وفي الشعر إلى ما شاء الله.
فأين نحن من مشروعات تفريخ فنان لكل مواطن والسودان ملئ بالمواهب الأخرى.
جميع من كلّمتهم عن زيارتي الأولى للسودان تصوروا أنكم أطعمتموني عشبا أفريقيا خاصا وسحرتموني، وأنكم بمياه النيلين الأبيض والأزرق عمّدتموني، وأن كهّانكم بالمسك والزعفران قد مسحوني.
والواقع أن شيئا من هذا قد حدث، والسحر السوداني الذي حاولت أن أنكره في بادئ الأمر بدأ يتفاعل في جسمي وينتشر كبقعة الحبر الكبيرة على وجهي ووجه دفاتري.
وها أنذا أعود مرة ثانية إلى السودان بشراسة مدمن مهزوم الإرادة يعود إلى كبريته وعلبة سجائره، وبشوق مسحور يعود إلى مغارة ساحره.
أيّها الأحباء:
هذه الليلة الشعرية موهوبة للقوات المسلحة السودانية؛ وتتساءلون ما صلة الشعر بالسلاح ومن يحملون السلاح، وبكل بساطة أقول لكم إن الكلمة لا تكون كلمة حقيقية إلا حين تأخذ شكل السيف، وأنا لا أحترم كلمة تظل ساكنة ومتخاذلة على الورق كأنها أرنب جبان.
إن الثورة والشعر يلتقيان في نقطة أساسية وهي إرادة التغيير، تغيير الأرض وتغيير الإنسان.
وفي عالم كعالمنا العربي يحاول أن ينفض عنه غبار الجاهلية وغرائز الجاهلية وعقلية الجاهلية ويثور على مؤسسات السحر والخرافة وكل مخلّفات الإقطاع والاستغلال والظلم والجهل والإنكشارية.
في عالم كعالمنا العربي خرج من حرب حزيران ثائرا على كل شيء، وكافرا بكل شيء، وساخطا على رداءة التمثيلية ورداءة الممثلين.
في عالم كهذا العالم العربي الغارق في دموعه وأحزانه حتى الرقبة تجيء الثورة والشعر ليكنسا كل بقايا العصر الحجري وكل حصون التخلف وينسفا مسرح الفكاهة القديم بكل ما فيه ومن فيه.
وهكذا يلتقي الشعر والثورة في توليد إنسان عربي جديد وفي صناعة عقل عربي جديد وفي زرع قلب جديد لإنسان هذه المنطقة بعدما حوّل بياطرة السياسة والحواة والدجالين قلبه إلى حطبة يابسة لا تثور ولا تنبض.
وبعد أيّها الأحباء:
في قراءتي الشعرية هذه الليلة سيكون هناك مكان كبير لشعر الحب ومكان كبير لشعر الثورة، فأنا كما عرفتم لا أقيم تخوما وحدودا بين الحب وبين الثورة فكلاهما في نظري يتدفق من ينبوع واحد هو الإنسان.
وكما لا أستطيع أن أتصور إنسانا لا يحترف الثورة، فإنني لا أستطيع أن أتصور إنسانا لا يحترف العشق.
إن الحب هو النار التي تضيء كل الأشياء وتطهّر كل الأشياء؛ وأنا عندما أتحدث عن الحب فإنما أقصد به هذه النـزعة الفطرية في الإنسان لاحتواء الكون ومعانقته ومن هنا يتلاقى حب المرأة وحب الأرض وحب الحرية وحب الحقيقة وحب الإنسانية على أرض واحدة.
إن الثورة الكبيرة في تصوري لا تكبر إلا بالحب الكبير، والبندقية العاشقة هي أحسن أنواع البنادق.
فلتكن هذه الليلة ليلة الثورة وليلة الحب.
عندما زار الشاعر نزار قباني السودان لأول مرَّة، لم تواجهه صحافة فنية بالطعن، مثلما حدث في مصر، بل ملأ السودانيون في الخرطوم المقاعد في المسارح والقاعات وملأوا الأشجار، وهم يستمعون إليه بمحبَّة.
وقد تركت تلك الحفاوة السودانية الشاعرية في الاستقبال أثرا عميقا في قلب نزار، فأصبح يسمِّي السودانيين “العنب الأسمر”.
وكتب نزار عن زيارته تلك إلى السودان، ومن بعد الخرطوم زار نزار قباني مدينة الشعر والفن والسياسة ود مدني، ليلقى حفاوة فيّاضة.
ليلتها وقف نزار في “نادي الجزيرة” الأرستقراطي الأنيق على النيل الأزرق يلقي أشعاره، فيضج المكان بالتصفيق.
ثمَّ يجلس نزار بين الحضور ليصعد المنبر مصطفى عدلان الطالب بمدرسة مدني الثانوية ليلقي في إبداع قصيدة نزار الذائعة الصيت “متى تفهم.. متى يا سيِّدي تفهم.. أيا جملاً من الصحراء لم يُلجَم.. كأنَّ حرابَ إسرائيلَ لم تجهِضْ شقيقاتك”، ليقول نزار بعدها إن الطالب مصطفى عدلان ألقى هذه القصيدة بطريقة رائعة أفضل مني.
المهندس الميكانيكي مصطفي عدلان تخرَّج في ما بعد من كلية الهندسة جامعة الخرطوم.
وقد زار مجموعة من الشعراء العرب الكبار السودان غير نزار قباني غير أنه يظل أكثرهم في التعبير عن حبّه للسودانيين.
من أقوال (نزار) في حب السودان والسودانيين:
“أنتم السودانيون بستان من الأحاسيس وقارورة من العطر”، لذلك ما أحلى الرجوع إلى أشعار نزار شاعر الحبّ والياسمين والثورة.
وقد أقام الشاعر الكبير ليلة شعرية في نادي الخريجين بالأبيض، أبدع فيها أيما إبداع وكان هناك من تسلق الشجر لمتابعة إلقائه الأنيق، وكان تفاعل الجمهور معه هائلا، وتروي حادثة صغيرة حدثت في الأبيض، فعندما حضر نزار برفقة محافظ الأبيض آنذاك الإداري القدير عباس فقيري، وبعد انتهاء الليلة ولما كان نزار والمحافظ يتأهبان لمغادرة نادي الخريجين اندفع أحد الشباب ومن شدة انفعاله وإعجابه بنزار بدأ بالضرب على مقدمة السيارة بيده بشدة عدة مرات.
علما وأن تفاصيل هذا السَّرد مأخوذة من تسجيل صوتي كان يحتفظ به الأستاذ عبدالمجيد خليفة خوجلي، وقد أفرغها كتابة في ما بعد ونشرها في ذكرى وفاة الشاعر الثانية عام 2008.
لا شك أن نزار قد خرج من دنيانا حزينا محبطا من عالم وصفه بقوله:
أنا منذ خمسين عاما أراقب حال العرب، وهم يرعدون ولا يمطرون وهم يدخلون الحروب ولا يخرجون، وهم يعلكون جلود البلاغة علكا ولا يهضمون.
وقد أحسن عادل حمودة عندما قال:
“إن نزار من أهم الشعراء والزعماء في العالم العربي وأكثرهم شعبية وحساسية”.
أما بالنسبة للسودان فقد ثبت لنا أن نـزار مسكون بحبه، كما أن السودانيين يبادلونه نفس الحب.
ومما أزعجني جدا أن السودان الذي حاز على كل هذا القدر من المحبة عند الشاعر الكبير نزار قباني، لم تتم الإشارة إليه في أهم الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها تجسيدا لحياته، والتي تم عرضها في معظم الفضائيات العربية وشاهدها الملايين من عشاقه بمن فيهم السودانيون أنفسهم، ولا أدري لماذا؟
وهكذا كان السودان بارقة أمل، وعنوان حرية ومحطة هامة في تاريخ نزار قباني وإن كانت محطة صغيرة إلا أنه قد تعلّم فيها الشيء الكثير، تعلّم الطيبة، تعلم الوداعة، تعلم صدق المعاملة، تعلم الاستقامة في المعاملة، تعلم حرية الكلمة، حيث اعتقلت الكلمة في أغلب الدول العربية وانتهكت حرمتها.