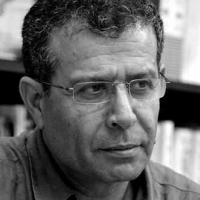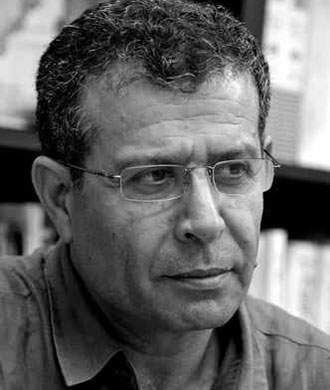الشعر والوجود الشعري
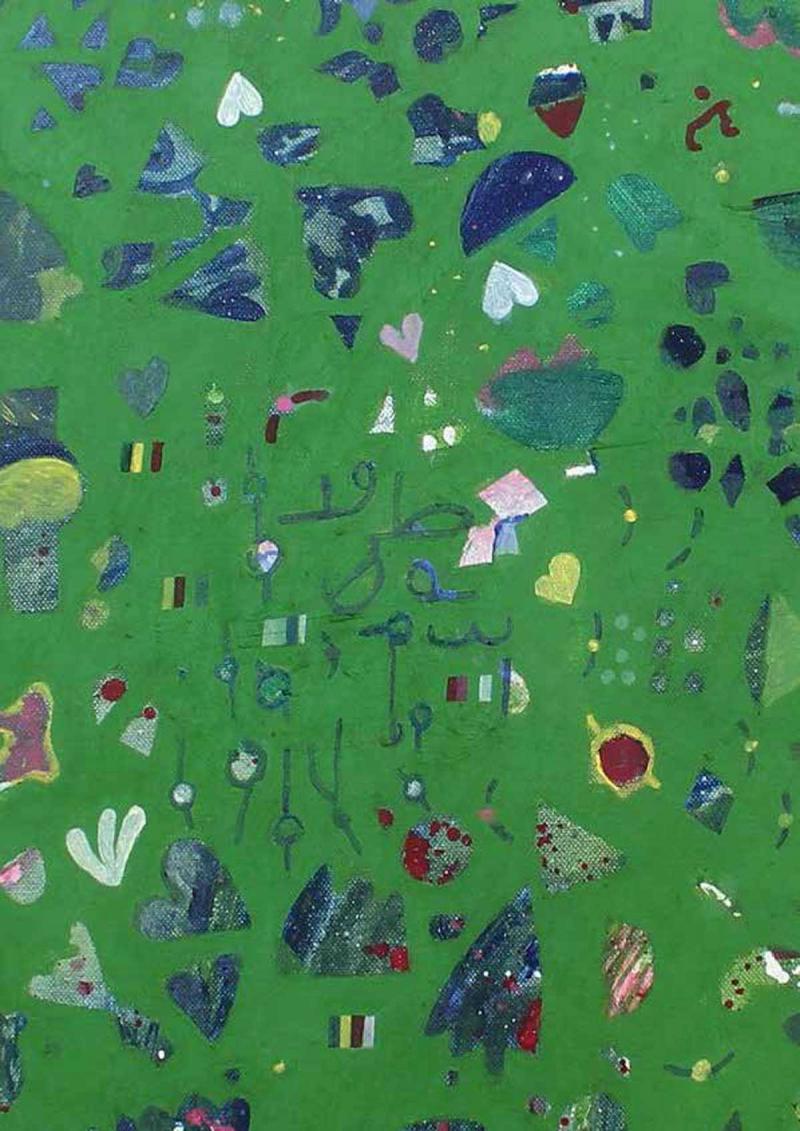
الشعر واللغة
لا شعر من دون مغامرة مفتوحة ومتجددة مع اللغة، كل قصيدة جديدة هي أولا وأخيراً ثمرة عمل مع اللغة من نوع مختلف، ولا جديد شعريا في رحلة شاعر من دون اكتشاف سبل غير مطروقة في الكتابة، ليمكنه ابتكار عالم جمالي خاص، ولكن هل يمكن لهذا أن يتحقق من دون موهبة كبيرة صقلتها دربة في العلاقة مع اللغة، وثقافة موسوعية، وخبرة خاصة في العلاقة مع الأشياء؟ وموقف صريح من قضايا الإنسان في العالم. هل يكفي أن نحب الشعر حتى نكتب قصيدة؟ للأسف هناك آفة تنتشر اليوم في تصورات فئة غير قليلة من كتبة الشعر تفيد بأن الكتابة الأدبية والشعرية لا تحتاج إلى موهبة وإنما إلى معرفة! وعلى هذا فإن كل من يملك شيئاً من شهوة الحضور ومعرفة ابتدائية باللغة يمكن أن تسول له نفسه أن يكون شاعراً.
ما يكتب اليوم من نظم وأراجيز وحتى نثر يومي وصفاً للحال في بؤسها الفردي أو الجماعي، وينسب نفسه إلى الشعر، يفتقر حكماً إلى طاقة الشعر وأسبابه، ومنها الخيال الشعري، فضلا عن ضعف مواهب أصحابه، لكنه، في ظل الفوضى الضاربة أطنابها في المدينة العربية المقيمة واللاجئة، لا يعدم من يدرجه تحت يافطة الشعر، وما هو حقيقة سوى ضرب من تسول الشعر ليس إلا.
بعيدا عن فكرة الشكوى من بؤس هذه الصورة ومما يجري أقول إن تاريخ الشعر العربي حتى في عصور ازدهاره عرف كثرة “الشعراء” وقلة الشعر. فإذا كان الشعر تجربة وجودية عميقة بالنسبة إلى البعض فهو موضة استهلاكية بالنسبة إلى الكثرة.
الجديد إزاء هذه الظاهرة المتفاقمة عربياً أن انتشار السوشيال ميديا فتح الباب واسعا لكل من يرى في نفسه شاعرا، أن يجرّ لنفسه مقعداً ويجلس بين الشعراء. لا حل لهذه الظاهرة لكونها مرتبطة بحرية الاشخاص في اختيار ما يريدون أن يكونوا.
أكثر من ذلك، بتنا نرى في خربشات الأكاديمي شعراً، وخواطر السياسي المعارض شعراً، وفلاشات الإعلامي وبوح اللاجئ شعراً، وغداً ربما نجد الاقتصادي، والصيرفي والشرطي يكتبون الشعر، فضلاً عن ناشري الدواوين وكثرتهم من الأميين، هؤلاء أيضا سيكتبون الشعر ما داموا شركاء في هتك أسرار القصيدة، ونزع الأستار عن مملكة الشعر، وقد باتت للقصيدة العربية من المحيط إلى الخليج، ومن قرى الميليشيات إلى مخيمات الهجرة، المفردات نفسها، والتراكيب نفسها، والموضوعات نفسها، يلتزم بها الشعراء جميعاً كما لو كانوا أعضاء في حزب له دستور لا يخالفه مخالف إلا ويكون مصيره الطرد من مدينة الوهم الذي يسمّونه الشعر.
أخشى أن جُلّ ما يكتب من شعر اليوم، وهو يكتب بمفردات مشتقة من قاموس لغوي ضئيل وشحيح، إنما وقع تحت تأثير ما ترجم من شعر، فكتب بلغة هي اللغة المتاحة، وليس بلغة هي اللغة القصوى، كما ينتظر من لغة الشعر أن تكون. وعليه فهو شعر يستهلك مفردات وتراكيب وموضوعات درجت وشاعت ولا يبتكر لغته، ولا يخلق اللغة كما يجدر بالشعر أن يفعل.
بقي أن أضيف أن ما استحدث من ذرائع في العقود الأخيرة عن صعوبة إخضاع القصيدة الحديثة للقراءة النقدية وفق معيار جمالي متفق عليه، أو استحالة أن نستنبط منها معياراً للشعر، إنما هو تسويغ للكسل النقدي والبؤس المعرفي، أما الترويج النقدي لهذه الفكرة فهو ضرب من الهرطقة.
جديد بلا جديد
الكتابة الشعرية اليوم تدرج على سابق في منجز جمالي عمره الآن أزيد من نصف قرن، تمثل في موجتين كبريين، واحدة في الستينات (مع صايغ وأنسي والماغوط أساساً) والثانية في الثمانينات مع كوكبة من الشعراء منهم تمثيلا لا حصراً (بول شاؤول، سركون بولص، بسام حجار، عباس بيضون، أمجد ناصر، سيف الرحبي، وآخرون) ما يكتب اليوم من شعر يدرج على ما أنجزته القصيدة العربية لدى شعراء الموجتين المشار إليهما. ولا أجد أيّ إضافة جمالية على البنية الفنية للقصيدة العربية كما أنجزت في المرحلتين المذكورتين، فقد بلغ التجريب لدى هؤلاء الشعراء من الجرأة والابتكار، إن في لغة القصيدة وموضوعاتها وتراكيبها الفنية، أو في الموقف من العالم والأشياء، مناطق بات من الصعب تجاوزها لدى الشعراء اللاحقين، وهكذا فإن السمات الأبرز حتى الآن في شعر الشعراء اللاحقين على شعراء الموجتين المذكورتين تفيد بأن ثمة استهلاكا للصيغ وتنويعا على الموضوعات نفسها، وليس هناك ابتكار أو اختراق يؤسس لموجة جديدة.
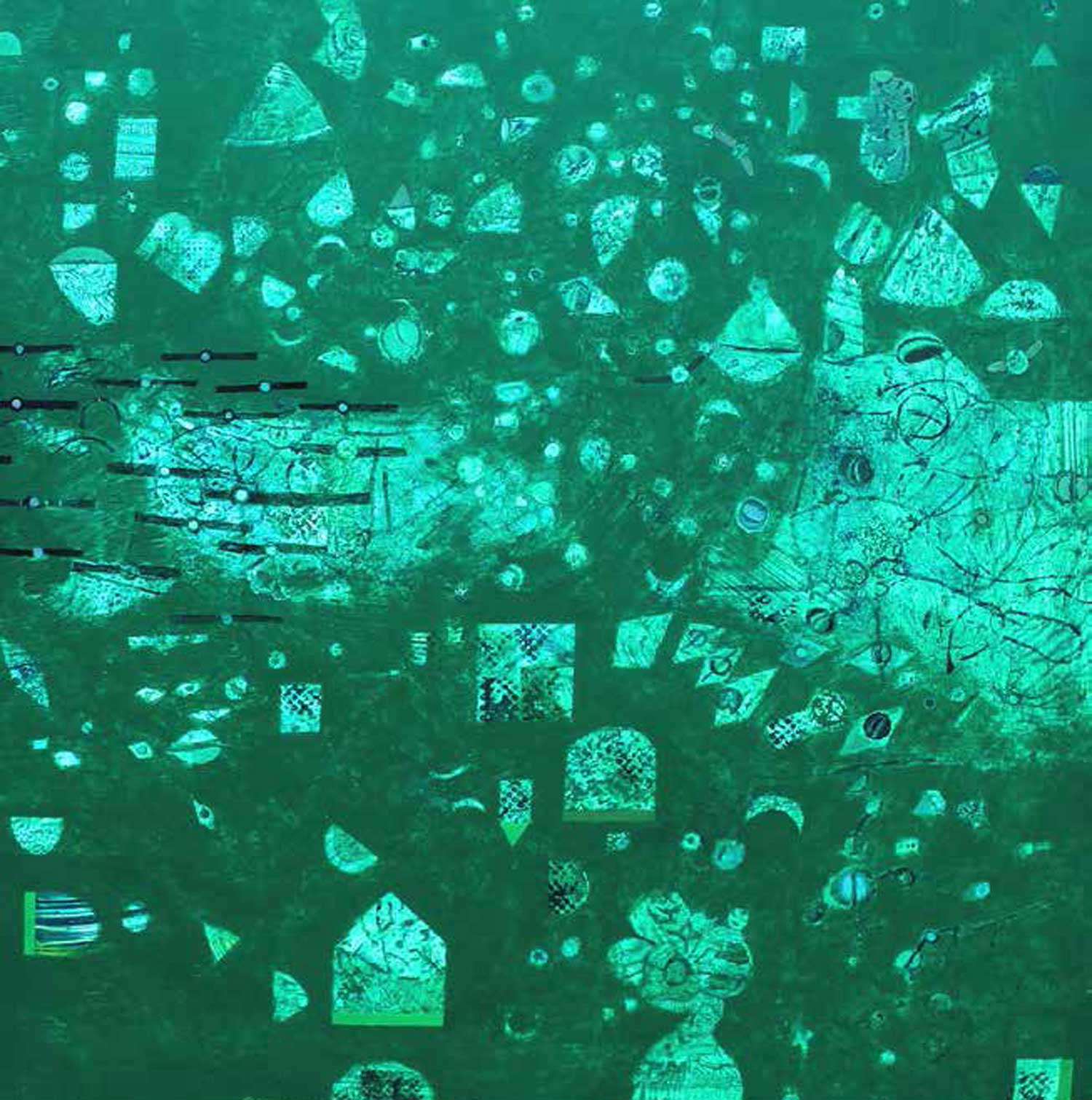
المحطات الفارقة في تاريخ الشعر عادة ما تسبقها مقدمات يبدو أنها لم تتوفر بعد بالنسبة إلى الشعرية العربية في عقودها الأخيرة. علماً أن ملاحظاتي هذه لا تختص بالشعراء الجدد وحدهم، بل وتنسحب على منجز غالبية الشعراء الأحياء ممن ينتمون إلى الموجتين المشار إليهما، فالأعمال التي يطالعوننا بها اليوم، غالباَ ما لا تقدم جديداً خارقاً للعادة. والشعر إن لم يكسر التوقع، ويأتي بما هو عجيب ومدهش لا يمكن اعتباره جديداً، ولن يكون له حضور مؤثر في الذائقة الشعرية.
الشاعر/الناقد
رؤية الشاعر
من البديهي القول إن كل طور من أطوار تجربة الشاعر يؤهله معرفيا لتجديد نظرته إلى الشعر. وكلما نضجت تجربة الشاعر نضجت معها نظرته إلى الشعر. ولكن هل يستطيع الشاعر الإحاطة بذاته، من باب استكشاف ما تغيّر وتبدّل فيه، وفي صنيعه الشعري ومن ثم في نظرته إلى الشعر، بينما هو منصرف، بكل ما يملك من وعي مغامر ونباهة شعورية، ليكتب قصيدته؟
***
الشاعر في علاقته بكلماته مثله مثل مريض بالعشق. وكل قصيدة جديدة للشاعر هي محبوبة جديدة. ويا لها من مهمة مستحيلة يطلب من شاعر القيام بها: الحديث عن شعره.
مرة سمعت شخصا يردد: أرجوكم، لا أستطيع أن أصيح وأطلع الفجر في الوقت نفسه. إما أن أصيح، وإما أن أطلع الفجر. أعجبني التعبير.
ما أراه أن مهمة الشاعر أن يكتب، أما تحليل الشعر واستكشاف جمالياته ومضامينه وأسراره، وكذا استخلاص العبر والمعاني فهي مهمة منوطة بقراءات ذواقة الشعر والنقاد.
***
في مغامرة الكتابة، الشاعر مبدع وناقد معاً، إنما في ما بعد، عندما يذيّل الشاعر القصيدة باسمه، إذ ذاك يتوارى الشاعر وتتقدم القصيدة. القراء مهما كانوا ألمعيين يحتاجون إلى القارئ الناقد ليطوف بهم على القصيدة بشعلة نباهته، ويبني للقصيدة جسرا بينها وبين القراء. هذا لا يعني أن قراءة الناقد هي الوسيلة المثلى للعبور إلى عالم القصيدة. أبداً، لكنها اقتراح حر لا يلزم من يريد أن يغامر على طريقته في تذوق القصيدة. يجب ألاّ ينسينا اعتدادنا بملكاتنا الخاصة أن تاريخ الشعر عرف نقاداً عظاما أثروا قراءتنا للشعر.
***
وعندما نتحدث عن الشعر والنقد اليوم ننتبه إلى حقيقة غياب شيء اسمه حركة نقد أدبي، هناك كتبة مياومون يسمون أنفسهم نقادا، ولا يعوّل كثيراً على قراءاتهم ومراجعاتهم لدواوين الشعر في إنتاج معرفة عميقة به. النقاد جلهم في حالة عطالة، انصرفوا عن الشعر، ضجراً، أو يأسا ربما من فوضى الحياة الشعرية، حتى لا أقول من لاجدوى الشعر. هناك ندرة من النقاد الذواقة الذين يعول على قراءاتهم للشعر، لكن هؤلاء في ظل غياب المجلات الشعرية والأدبية الطليعية لم تعد لديهم منابر ينشطون من خلالها، نراهم ينشرون، من وقت إلى آخر، قراءة هنا وأخرى هناك، فالصحافة السيارة تعتبرهم ضيوفا غير مرحب بهم. هم في الحقيقة أشبه بقابضي الجمر.
لمن يكتب الشاعر؟
إن تعبير الشاعر عن نفسه، إذا ما كان صاحب موقف من قضايا الإنسان، هو بالضرورة تعبير عمّا هو أبعد من ذاته، ففي أشواق الشاعر وتطلعات شعره نعثر على تطلعات زمن وجيل، وربما عصر بأكمله.
في نقد الصورة
من الطبيعي أن تساعد الحركات والاتجاهات في الشعر وانتماء الشعراء إلى تيارات معينة حضورهم الشعري في الوسط الأدبي ولدى جمهور الشعر. وليس في الأمر غضاضة. فالمراجعات النقدية بين عقد وآخر، وبين حقبة شعرية وأخرى كفيلة بتركيز مكانة الشاعر، وتحديد القيمة الشعرية. وليس خافياً على أحد أن بعض أشهر الأسماء التي لمعت في خمسينات القرن الماضي وستيناته تحققت لها تلك القيمة الشعرية الجديدة إلى جانب اعتبارات ترتبط بالاستقطابات الأيديولوجية شعراً وفكرا، وتبلورت من خلال السجال والصراع بين ما سمّي بشعراء التجديد ومن أمامهم مجلة “الآداب”، وشعراء الحداثة تتقدمهم مجلة “شعر” ومؤسسها يوسف الخال. واليوم بعد نصف أقرن على انطلاق هذه الحركة فإن جل هؤلاء وأولئك من شعراء الاتجاهين قد زال الاهتمام بهم برحيلهم عن عالمنا، فمن يحتفي اليوم، حتى لا أقول، من يقرأ شعر يوسف الخال، أو البياتي، أو فؤاد رفقة، أو بلند الحيدري، أو محمد الفيتوري.. إلخ، بل إن البعض من هؤلاء يكاد لا يذكر إلا لماما، وهناك بين الشعراء الطالعين من يتندر على نحو قاس بجل الأسماء التي نسبت إليها الريادة.
واليوم من بين الشعراء الأحياء من كان نجم نجوم، أشبه ببطريارك يتقاسم وشركاء له معدودين وذائعي الصيت فكرة الحداثة بوصفها غنيمة، وقد تكون كتبت في أعماله وأفكاره أطاريح جامعية، ودأبت الصحافة السيارة على الاحتفاء بحركاته وسكناته، من دون أن تتبع تطوره الشعري، فهي تكاد لم تعد تعنى بأشعاره ليتحول إلى ظاهرة صوتية يسارع من ظهرت عليه من الشعراء الجدد والمريدين شهوة الحضور إلى التقاط الصور معه ونشرها بتباه على الملأ الأزرق، لعل الظهور برفقته أن يكون انتساباً لمحفل الحداثة وتطويباً.
المحزن أن هذا الطراز من الشعراء قبل على نفسه أن يتحول إلى طوطم ولكن من دون أن يمتلك عفة الطوطم، فهو لا يكف عن منافسة الشعراء الشباب في الظهور مشرقاً ومغرباً وفي جلّ مهرجانات الثقافة في قارات المعمورة، غير آبه بحقيقة أن الطبعة الواحدة من ديوانه لا تبيع أكثر من ألف نسخة، وأن الناشرين يشكون من كساد كتبه التي ينشرونها “تبركا باسمه”. فيا للمفارقة ألاّ يعود جذابا ولا مغريا شعر كان حتى قبل عقدين من الزمن يقرأ بشيء من الشغف، على الأقل، من قبل الشعراء.
واليوم لا يقرأ شعر هذا الشاعر سوى بعض المأخوذين بالاسم، وزمرة من المريدين، وحفنة من الفضوليين من باب “اعرف عدوك”.
حتى لا نذهب في متاهة الكلمات الهاربة من معانيها. أقول إن هذا النموذج من الشعراء بات صورة من صور مسخ الكائنات، فقد ظهر في أواسط القرن الماضي في جوار عصبة صقورية من دعاة الحداثة نادت بتقويض القديم في الشعر والفكر والاجتماع، وقرنت دعاواها الحداثوية بحركات التغيير الاجتماعي والسياسي ومناصرة الثورات، حتى الدينية منها (الثورة الإسلامية في إيران) واكتسبت نجوميتها لدى الأجيال الجديدة من بلاغتها المتمردة التي ترددت أصداؤها في الجامعات والمنتديات والمؤتمرات المطالبة بالثورة على كل شيء قديم، وانتهى بها الحال مع مطلع العقد الثاني من القرن الحالي منقلبة على دعاواها وخطاباتها في الشعر والفكر والاجتماع، ومنكرة على الشارع المنتفض على الطغيان توقه إلى الحرية وطرائقه في التعبير.
نكوص مروّع، لم يعبّر عن نفسه في أفانين من الزوغان والغموض اللغوي في الموقف من القمع والطغيان السياسي وحسب، ولكن في اصفرار غصن الشعر بعد جفاف نسغه وتحوله إلى حطب. فالقصيدة لم تعد حصانا جامحاً، ولكن سكرتيرة ماهرة في تجميل حضور الشاعر، وممالأة من بيدهم مفاتيح الأبواب. وهو ما اقتضى من الشاعر الانتقال من موقع المخالف المُعرض أو “الحردان”، إلى موقع قناص الفرص وقد جدت ظروف تتيح له امتداح ظواهر في الثقافة ومؤسساتها سبق أن هجاها. لعل نقد هذا المصير في تحول الشاعر الحداثي إلى مومياء، من قبل الحياة الثقافية العربية إنما يحتاج إلى وعي نقدي جريء، ونفاق أقل.
قوة الشعر
شعرية الوجود
هل لما هو شعري في الوجود أن يزول؟ هل يمكن للوردة أن تتوقف عن بث جمالها في الوجود؟ هل لعطر وردة الكون أن ينفد؟ وهل للجمال في منظومته الكلية وقد أشاعت نفسها في الطبيعة والطبائع وعبّرت عن نفسها في لطائف الأشياء أن تزول، ألاّ يعود لها وجود في المرأة والطفل والرجل والشجرة والغيمة والنهر الدافق، وحتى في عين الحيوان المحدقة في الوجود. فقط عندما يكف الجمال عن أن يكون مرئياً في العالم، عندما يختفي الجمال وتختفي الدهشة به، عندما يموت الشعور بتلك اللطائف التي يسبغها علينا الوجود، يمكن للشعر حينئذ أن يموت، وبموته ندرك أننا بتنا حطبا خاليا من كل شعور، وأن موت حاجتنا إلى الشعر هي علامة موتنا.
الشعر لا يعبّر عن واقع ما، إنه واقع مواز، عالم حلمي قائم في ذاته. وهو لم يعبر الأزمنة ويصل إلينا في كل زمن إلا لأنه تفوق على الواقع بأجنحة الحلم، وصارت له كينونته ومعها زمنه الخاص.
الشعر موقف رؤيوي مضاد لكل ما ينتهك حرية الإنسان وكرامته، مغامرة جمالية في العالم وفي الماوراء، وبحث لا يتوقف عن منبع أسرار النفس وأسرار الوجود، وليس تقريرا أو تعبيرا أو تفسيرا لواقع، ولا معركة معه. مغامرة الشعر مساحتها الكينونة الوجودية للإنسان والطبيعة، أما القصيدة فهي لا تتحقق ولا تتكشف قيمتها في مجرد تفسير الكلمات، ولكن في إنشاد الكلمات بلا نوايا مسبقة، والسفر الحر في ظلال الكلمات ومراميها البعيدة.
مستقبل الشعر
لا أحد يستطيع أن يجزم في شيء يتعلق بالمستقبل في زمن يقترح أربابه طرد الشعراء من المدينة وتوظيف الروبوتات لكتابة الأغاني والقصائد العاطفية. إن توظيف برامج الذكاء الاصطناعي لتنقيح فلسفة عصر الأنوار وإعادة كتابة دساتير الدول، وتكريس البلادة الإنسانية بوصفها ما بعد بعد الحداثة، سوف لن يبقي ما يسود في الكوكب سوى الغباء البشري. هل يمكن أن نتحدث عن المستقبل بثقة مفرطة في وقت تقود فيه العالم حفنة من الطغاة والمهووسين الراغبين في الهيمنة أكثر فأكثر ليس على الكوكب وحسب بل ويجربون أن يمتد سلطانهم إلى كواكب أخرى، إن البعض من هؤلاء المهووسين يريد احتلال الزمن اًيضا بتأبيد وجوده عبر السفر في ثلاجات ذكية، في وقت يخوض زبانية من الطغاة المشتغلين عند أرباب كونيين في دماء شعوب حُفرت لها قبور جماعية في جوار أسواق امتصت أدمغتها ودماءها، ولم تترك لها سوى أجساد هزيلة، حصة باقية لمسالخ الموت.
السؤال، إذن، لم يعد محصوراً بمستقبل الشعر العربي، بل بمستقبل الشعر والإنسان في الكوكب، وأكاد أقول مستقبل الوجود البشري.
الشعر والترجمة
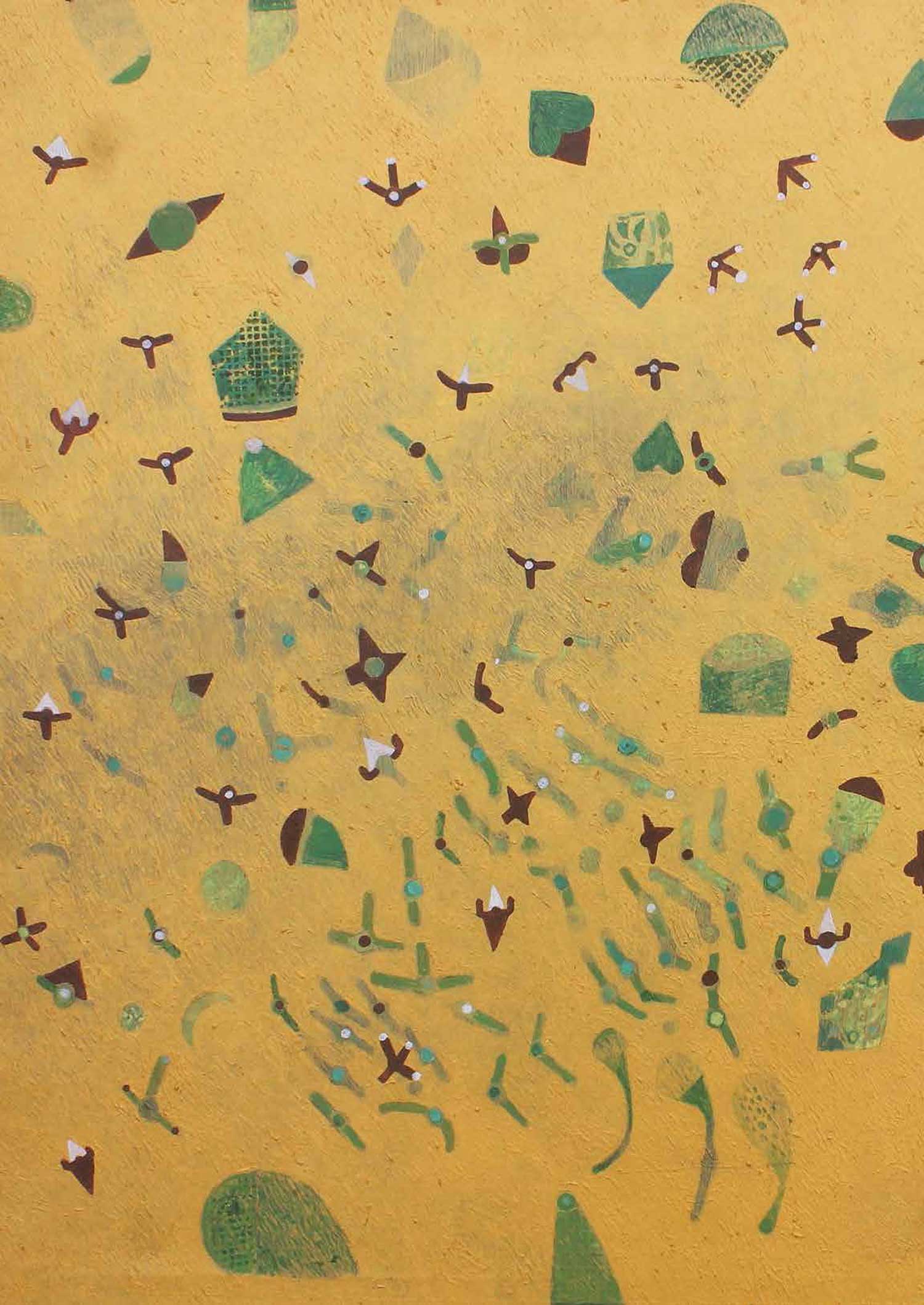
ديوان الشعر العربي، الكلاسيكي منه والحديث، هو بلا شك من أعظم المدونات الشعرية في العالم، وهو في أطواره الحديثة ينتمي إلى جغرافيات ذات خصوصيات متجاورة ومتصلة، وتجاربه وأسماؤه على ما تشترك به وتختلف لا تقتصر على حفنة من الشعراء الذين ترجموا حتى الآن. نعم، لا بد من مشروعات عدة للترجمة، فردية ومؤسسية للنهوض بهذه المهمة الحضارية، فليس كمثل الشعر معبّر عن روح الأمم وثراء الثقافات.
تعارفت الثقافات في ما بينها عن طريق الترجمة، فلا مناص، إذن، من الترجمة لتحقيق التواصل الأسمى بين ثقافات العالم وفي القلب منها شعرياته. أعتبر مترجمي الشعر، الأكفاء منهم، مغامرين يتنكبون نقل الجمال الفني بروح رسالية. ترجمة الشعر عمل شاق لا يقدر عليه بجدارة إلا الندرة من المترجمين، لذلك يكاد يكون، مع أفضل التجارب، عملا خلاقا. ليس سهلا أن تمنح حياة أخرى للشعر، ليسافر أبعد في وعي العالم ووجدانه، ويتفتح كما تتفتح الأزهار في حدائق العالم.
أشعر بالامتنان للذين أقبلوا على ترجمة شعري، لولا هؤلاء النبلاء لما رأيت أزهاره تتفتح في جنائن بعيدة.
وهذا يجعلني أقول إن الاحتفاء بالشعر إنما يجدد الأمل بإنسانية الإنسان، بإيثاره الجمال على القبح، والحب على البغض، وحرية الخيال على ضيق الأفق. لا بد أن نتمسك بالشعر لنصون إنسانيتنا بأسمى تجلياتها، لاسيما في هذا الزمن الصعب، زمن الصورة الفارغة، والسرعة الجنونية، وشيوع الأنانية الفردية، وانتشار التفاهة العمومية، وكل ما يولّد غربة المرء عن وجدانه.
الشعر يحرس الأمل بالقيم النبيلة، يمنعها من أن تفسد، ويمنح الإنسان القوة الروحية في مواجهة آلات الزمن الجامح المباهي بقدرته اللامحدودة في السيطرة على العقول والأرواح، زمن التكنولوجيا العمياء المبشر بفكرة “الما بعد”؛ ما بعد العقائد وما بعد الأخلاق، ما بعد كل شيء عرفناه وألفناه وآمنا به، ما بعد كل تعريف تواضع عليه البشر للقيمة الإنسانية، وقد شارف هذا “الما بعد” على إخضاع البشر، وتحويلهم إلى عبيد وضحايا لحفنة من المتوحشين المسيطرين على الكوكب.
حتى فكرة الذكاء الاصطناعي يريدون لها في النهاية أن تصنع الغباء البشري، عن طريق تبليد الشعور الطبيعي بين البشر ونحو الأشياء، وتحويل الجموع إلى جزر من المنوَّمين الذين لا يعنيهم من وجودهم سوى تلبية أسبابه البيولوجية، أسرى نهائيين لمنظومة الغرائز وعلى رأسها غريزة البقاء مقابل إغراءات السفر الافتراضي في متاهة الأشياء التي تشبه الأشياء، وهو ما يجعل الكائن عاريا وضعيفا وغريبا تماما عن الفطرة الذكية وعن حقائق الوجود.
نقل الشعر من لغة إلى لغة إنما يمنح حياة موازية للقصيدة.
كائنات حية
كل قصيدة جديدة هي بالضرورة ثمرة إقرار من شاعرها بفشل ما في قصيدة سبقتها، وبالتالي هي نوع من تمرد جمالي على تلك القصيدة.
القصيدة والمكان
هل يمكن للقصيدة أن تولد في فراغ العالم؟ أعني في فراغ بلا مرئيات وعلامات تنسج نفسها من مادتها الثرة، ومن ثم فضاء تتخلق في حيز منه يحيط بها ويدل عليها؟ القصيدة بنيان من الكلمات، والكلمات بداهة أسماء لموجودات وأفعال في المكان، وعلاقات بين الأشياء الموجودة في العالم.
لا وجود للشعر خارج المكان، أما زمن الشعر فهو زمن الأحلام، أحلام النوم العميق وأحلام اليقظة. وعندما نتساءل عن الكيفية التي تتخلّق فيها هوية النص بأثر من علاقته بالمكان، بحيث يمتلك الشعر سمات خاصة بهذه العلاقة فهنا تحديدا تكمن وظيفة الناقد. وظيفة الشاعر أن يكتب القصيدة. أن يتقن صنعة الشعر، بحيث ينتزع لقصيدته حيزا في تاريخ هذا الفن. أما المكان بموقعه ومواصفاته ومسمّياته الجغرافية فهو فضاء الشاعر، كلما اختبر مساحة أو حيزا فيه، انعكس ذلك في شعره على نحو ما، وتحققت من خلاله سمة من سمات قصيدته، إنما ليس شرطا أن يكون لأثر المكان أو ظهوره في مرايا الشعر حضور مباشر. طبعا ليس جديداً القول إن المكان في القصيدة أحد مصادر هويتها الفنية والحضارية.
مدن وأماكن
كل الأمكنة آسرة بعمرانها وبشرها وتواريخها، بتكوينها وجماليات هذا التكوين، وبعوالمها الخفية وأسرارها الدفينة، والشعراء هم الأقدر على خوض مغامرة السفر في الأمكنة والولع بأسرارها إلى حدود لا نهاية لها. إنما ما من حرية كبرى للشاعر إلا في قصيدته. ولطالما كانت رحلات الشعراء عبر العالم مصدراً ثراً من مصادر المعرفة والإلهام. بل يمكن الجزم أن ما من شاعر إلى أيّ ثقافة انتمى إلا وكان السفر جزءا من وجوده الشعري.. وإذا كانت الطبيعة والوجود الطبيعي أساسيان في الإلهام الشعري لدى قدامى الشعراء، فإن المدينة بالنسبة إلى شعراء الأزمنة الحديثة تشكل قِبلة أنظارهم وموئلا للحركات والتيارات والعلاقات بين الشعراء.
الشاعر وإن يكن حبيساً في المكان فهو طليق في القصيدة.
لندن في تموز/يوليو 2025