أن تكون هنا وهناك ولك هذا القدر
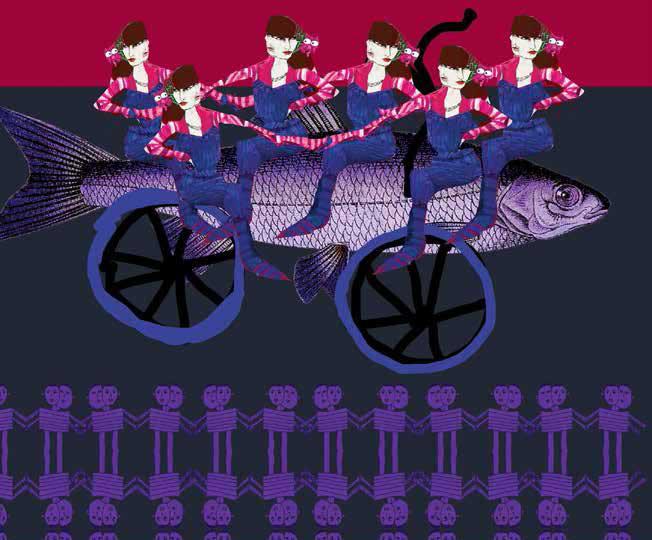
حكايةُ السّمكة
قرع الباب فيما الساعة تجاوزت الحادية عشرة ليلاً، وأطلت جارتي، تحمل وعاءً زجاجياً وناولتني إياه، وعاء ارتج فيه ماء ونفرت سمكة صغيرة، وبينما رحت أنظر ما بين يدي، كانت جارتي قد خفّت إلى بيتها لتعود ومعها علبة فيها طعام خاص بالسمك.
لن ألمس سمكة حية، أنا لا أحب الحيوانات، أخاف هذه الكائنات، في أفضل الأحوال لا أتقن التصرف معها، على أن هذا التعميم قد لا يشمل السمك، ولن أمانع رعاية هذا الكائن الأمانة، فجارتي ستسافر مع أولادها في الفجر.
قالت مسرعة: “وضعت لها طعام اليوم، أي كمية إضافية ستؤذيها”.
أول ما فعلته في الصباح هو تفقد السمكة للاطمئنان عليها، وبي شعور من راحت تطمئن على طفلة استضافتها للمبيت عندها، صدمتني المفاجأة.
كانت السمكة البرتقالية الصغيرة في قعر الإناء، بلا حراك، هززت الإناء.. لعلها نائمة، انتظرت أن أراها تتحرك، نقرت لها على الزجاج، لكنها لم تستجب، أيقنت أنها ميتة.
لم أعرف السبب، ربما ألم الفراق، من يدري سرّ هذه الكائنات الصغيرة. هل شعرت بأن أصحابها غادروا بعيداً؟ أم أنها غيرت مكانها فلم تحتمل ما لم تألف؟
أربكني شعور داهم بالمسؤولية، وشيء من الكآبة تسلل إلى نفسي، لم أعرف ما أفعل، حرت كيف أتخلص منها؟ أريد لها على الأقل أن تلقى بعض التكريم في مثواها الأخير، لعلي أعوض وزر موتها في بيتي.
ماذا يفعل الناس بأسماكهم الموتى؟ لم يخطر في بالي أن أسأل جارتي هذا السؤال، أو لأكن أكثر دقة، لم يخطر لي أنها بهذه السرعة يمكن أن تموت.
ثم أن الناس في هذه الأيام لا يجدون مأوى لموتاهم من البشر، فلا حسرة على الأسماك، هكذا فكرت بحثاً عن شيء من راحة الضمير.
بعد أخذ ورد بيني وبين نفسي، قررت اللجوء إلى ناطور البناء، لا أحد غيره سيحل المعضلة، لا أريد لابنتي داليا أن تشعر بأي أذى نفسي من هذا الموقف، فالأمر طبيعي، سمكة ماتت، هذه حال الدنيا.
اتصلت بأبي هاشم، رنة الهاتف أغنية، لا أعرف كيف تصنف، لكنها غالباً ما كانت تستخدم في المناسبات الوطنية تمجيداً للجيش: “خبطة قدمكن عالأرض هدارة”، يدفع مقابلها ليستمتع المتصل! ريثما يجيب المتلقي، الرنة التي سبقتها كانت مقطع من خطاب لحافظ الأسد: “الوطن غال الوطن عزيز”، يلجأ الناس في هذا البلد المقهور إلى حيل كهذه لدرء الشبهات، فالخوف يقطع الجوف، وأنت مضطر لتثبت ولاءك، على مبدأ ” لا بدي نام بين القبور ولا شوف منامات وحشة”.
رد أبوهاشم أخيراً، رجوته أن يصعد إليّ.
أخبرته ما حدث مشفوعا بالتبريرات اللازمة، ـ قلت لم أتسبب بموتها، لم أطعمها لا زيادة ولا نقصان، ربما لمجرد قضائها ليلة خارج بيتها توقف قلبها عن الخفقان، وكأني أبرر لنفسي ولداليا أكثر من تبريري له.
تناول أبو هاشم الإناء بما فيه من يدي ومضى من دون أدنى فضول مني لأعرف كيف سيكون مصيرها.
قلق
القلق الذي انتابني كان أكبر من موضوع السمكة، فسفر جارتي رغم أنه لم يأت بغتة، إنما يعني أن لا أحد غيري، أنا وابنتي، يسكن في هذه الجهة من البناء، تسعة طوابق خالية أو هي خلت، وفي الجهة الأخرى هناك عائلتان، وفي الكراج يعيش الناطور وعائلته، وعائلة عائلته، من أخوة وأبناء أعمام وعمات، نزحوا من بيوتهم في الغوطة، وآواهم قريبهم في أجزاء من الشقق الفارغة غير المكتملة بعد، بموافقة من أصحابها.
ثم إنك كلما غادر أحدهم لا بد أن تراجع قراراتك، وتناقش أمر البقاء أو السفر، والاختيار صعب جداً، بين البقاء في بلد تجد أن روحك معلقة فيه لكنه دخل في أتون حرب لا يبدو أنها ستمر مرور الكرام، أو المغادرة إلى المجهول لتبدأ حياة جديدة لا تعرف عنها شيئاً إنما فيها أمان بت تفتقده أنت وعائلتك.
كنت أحاول ألا أفقد رباطة جأشي، أن أتظاهر بالتماسك قدر الإمكان، فلم أشأ أن ينتقل الخوف إلى داليا الخائفة أصلاً، منذ أيام سقطت قذيفة في البناء الذي انتقلت إليه المدرسة مؤقتاً داخل المدينة تجنباً لأخطار الطريق، وصلني أن انفجاراً قد حصل في المنطقة، كنت على وشك الانهيار إلى أن ردت “دارين” على الهاتف وطمأنتني، “لا تخافي مدام ما صار شي والطلاب بالباصات على الطريق”، لكن الطفلة أتت والرعب واضح عليها، سألتني: “هل سنبقى هنا؟” كان الكثير من أصدقائها قد غادروا البلاد.
كانت أعداد الشهداء تتزايد يوماً بعد يوم، وحصة دمشق وريفها كبيرة، وأصبح وارد جداً السماع عن تفجير سيارة هنا أو هناك، ورغم أن صورة نظام يقتل شعبه واضحة تماماً، إلا أن حوادث صغيرة كانت غير واضحة المسؤولية، ما بين الثوار في الغوطة أو تعمد النظام حقن الشارع ضد معارضيه، وهو كالراعي الكذاب، حتى لو كان الثوار مسؤولين عن بعض القذائف والصواريخ، إلا أن رأيي ورأي المحيطين بي كان يميل ضده دائماً.
أخبار الاعتقالات تتزايد، ولا أحد يذهب ويعود، من يعتقل تنقطع أخباره، رجال نساء، صغار كبار، كل من في يرفع رأسه معرض للجحيم، أو إذا صادف وكنت في الموقع الخطأ في الوقت الخطأ، كأن يمر شاب في شارع سمعت فيه هتافات ضد النظام، فيختفي في الباص الأخضر.
كانت قصص الأهوال تنتشر، بعضها ينشره المجرمون عمداً ليوقعوا الرعب في قلوب الناس، فلا يترك للجرأة مكانا، حتى على مجرد “لايك” تحت خبر أو صورة.
في الليل أصوات اشتباكات قريبة وأخرى بعيدة تتناهى إلينا، داليا تنام قربي ليطمأن قلبانا، لاسيما وأن الكهرباء مقطوعة أغلب الأوقات، والظلام يحيط بكل ما يحيط بنا. أسمع نباح الكلاب الشاردة، فأشعر كأنها على عتبة الباب، تتآمر مع المفروشات، التي يحلو لها أن تتمطط فتصدر طقطقة لا معنى لها سوى بث الذعر في أوصالي.
منذر كان في بغداد لتجديد جواز السفر، الأسبوع صار شهراً، والأمور في الشام إلى تدهور، لا ضوء في الأفق، صوت المروحيات والقصف والقذائف يزداد يوماً بعد يوم، ومعه يكبر الهلع.
***
نحن رجالك يا ..
كان قد حدث في أحد أيام ربيع 2012 أن كنا في زيارة لأقارب، استضافوا بوجودنا بعض أصدقاء أطفالهم، لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة.
كان الأطفال يلعبون بينما نتبادل الأحاديث، ولم تكن اللعبة تخرج عمّا يحدث في البلاد، فبعضهم أخذ دور الجيش فيما أخذ البعض الآخر دور الجيش الحر، ثم قام أعضاء الفريق الأول بإيقاع أعضاء الفريق الثاني أرضاً مع ركلهم بالأقدام، مرفقين ذلك بغناء نشيد كان شائعاً حينها “نحن رجالك يا بشار”.

كان المشهد مستفزاً للغاية.
وحين مروا أمامنا لم تتمالك ابنتي مية نفسها، فقالت بصوت خافت: “تضربوا انتوا وبشار”.
بعد قليل لاحظنا أن أحد الأطفال يتحدث بهاتفه منزوياً، يرمقنا بنظرات مرتابة.
علقت أنا مبتسمة: هل يشكونا مثلاً؟
بعد قليل غادر الأطفال وغادرنا عائدين إلى بيتنا.
كان أبنائي مية ومحمد في زيارة لنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويفترض أن يعودوا إلى بيروت في اليوم التالي.
ما إن وصلت إلى البيت حتى وجدت الهاتف الأرضي يرن، قريبتي منهارة بالبكاء تتوسل بي أن نخرج حالاً، لأن الطفل قد اشتكانا لوالد صديقه، وهو مسؤول كبير في الجيش، ربما هو الرجل الثاني في البلد حينها، وهناك من اتصل للسؤال والبحث عنا، ومعلوماتهم أن الأب عراقي، والأهل ضحكوا عندما سمعوا تعليق ابنتهم.
رعب ما بعده رعب.
اتصلنا بمكتب التاكسي وأجبرنا مية ومحمد على المغادرة فوراً إلى بيروت، رغم اعتراضهم وترددهم، وما إن عبروا الحدود حتى اطمأن قلبانا قليلاً.
لم نكن نستطيع المغادرة جميعاً، داليا تحتاج إلى فيزا لدخول لبنان.
ما العمل؟
ذهبت داليا للمبيت في بيت أخي، وقضينا الليلة أنا ومنذر نترقب من يقتحم بيتنا، وضعت مئات التوقعات أحلاها مر، كلما سمعت حركة بسيطة، تصورت أنهم قادمون.
في الصباح الباكر، أجرى منذر اتصالات مع بعض الأصدقاء لتأمين فيزا لداليا، وغادرنا إلى بيروت مسرعين، ما إن عبرنا الحدود حتى تنفسنا الصعداء.
ما حصل هو أن قريبي اتصل بالضابط المسؤول عن أبناء المسؤول وحاول تبرير الموقف، والاعتذار محتجاً أن الفتاة التي أخطأت هي طفلة لا أكثر، لكنهم كانوا يملكون معلومات كاملة عنا، وما أزعجهم أن هؤلاء “العراقيون” أساؤوا للدولة المضيفة لهم! إنما هذه المرة سيتجاوزون عن الأمر مقابل ألا يعودوا ريثما تهدأ النفوس.
من يصدق أن الأطفال باتوا شبيحة ومخبرين أيضاً؟
بقينا في المنفى ما يقارب الشهر، حتى شارفت السنة الدراسية على الانتهاء، فعدنا أنا وداليا وحدنا، لم يكن قلبي مطمئنا لعودة منذر بعد.
حين ذهبت داليا إلى المدرسة، كان الطلاب يتبادلون الهمز واللمز نحوها، “هي اللي أختها سبت السيد الرئيس”.
***
قدر عربي
في بداية العقد السادس من القرن الماضي كان شاب عراقي في بغداد ينتظر بشغف مجلة “الكواكب” ليقرأ ما كتبته تلك الصبية السورية، وحين وصله العدد الجديد أبدى إعجابه أمام صديقه بهذه الزاوية من المجلة. قرأ الصديق اسم الكاتبة، وأخبره أنه يعرفها، فهي قريبة زوجته، وهناك علاقات أسرية بين العائلتين. لم يتردد الرجل بالطلب من صديقه مرافقته إلى دمشق ليتعرف عليها. وهكذا ابتدأت قصة حب، ثم زواج. شاب عراقي وشابة دمشقية، لم تفكر يوماَ أن تترك دمشق، ما لبثت أن انتقلت للعيش معه في بغداد، وهناك أكملت دراسة الأدب العربي في الجامعة.
بعد سنوات قليلة عادت الأسرة للعيش في دمشق مع ثلاثة أطفال، نشأوا فيها وعرفوها كوطن، واحتضنتهم من جهتها في كل نواحي حياتهم، مدارس وأصدقاء وجامعات وأعمال، وحب وزواج، وعراقي وسورية مرة أخرى، عراقي يفتخر بانتمائه لكنه لا يحمل جنسية والدته لأن القانون لا يسمح.
وهكذا كان، تزوجنا وأنجبنا في دمشق أطفالاً “عراقيين” أيضاً. وباعتبار أن “بلاد العرب أوطاني” هي قصيدة لا أكثر، بقيت الأوراق الرسمية تشكل معضلة، لاسيما في ظل علاقات مضطربة بين البلدين غالباً، ما كان يستدعي معاناة في تجديد جوازات السفر، أو تسجيل المواليد الجدد.
خلال سنين طويلة لم يضطر منذر للذهاب إلى بغداد، وكانت أيّ معاملات يمكنها أن تنجز دون حضوره شخصياً، إلا هذه المرة، فقد جرت الرياح كما لا تشتهي سفني، احتاج أن يسافر إلى بغداد أثناء اضطراب في البلاد، جعل حياة الناس في قلق أقرب ما يكون إلى الهلع. ورغم أن التوقعات كانت أنه سينهي معاملاته خلال ثلاثة أيام، إلا أن الأمر امتد إلى شهر، مر عليّ كأنه سنوات.
***
نبقى أم نغادر؟
كان الحراك في مناطق ريف دمشق متأججاً، وباعتبار أن هناك “كوتا” يومية لأعداد الضحايا، كان الرقم في ريف دمشق يومياً أعلى من خمسين شهيداً في اليوم يقتلهم النظام، عدا عمن يقتل من طرفه، بمن فيهم جنود مجندون لا حول لهم ولا قوة. والاشتباكات متواصلة ليلاً ونهاراً، يصحبها أحياناً تفجير سيارة أو شيء من هذا القبيل.
ليكتمل موسم الرعب قُطعت وسائل الاتصال لثلاثة أيام، فلا هواتف مع الخارج ولا إنترنت، وانقطعت صلتي مع منذر في بغداد، والأولاد في بيروت، الوساوس أكلت رأسي، ماذا لو؟ مفتوحة على احتمالات لا نهاية لها، تبدأ من وصول الجيش الحر إلى منطقتنا، كونه أصبح متواجداً في جميع أنحاء ريف دمشق تقريباً، ولا تنتهي بالخوف من سقوط مفاجئ للنظام، تؤججه هواجسي وشيء من أمنياتي، لكن ذلك يعني أن الظرف لن يكون آمناً.
عند عودة الإنترنت كان وسم “من – هنا دمشق” يملأ فيسبوك، من بيروت، من القاهرة، من بغداد، من مونتريال، من باريس، من لندن، تعبيراً من السوريين المنتشرين في أنحاء العالم عن فقدهم التواصل مع البلد الأم، وحاجتهم للاطمئنان على أهلهم وأصدقائهم، كغيري وجدت عدة إشارات من صديقات يفتقدنني، أنت في وضع من الهشاشة يجعلك في حاجة إلى أي تعاطف، ما حال من تحت القصف إذاَ؟
أخيراً كلمني منذر هاتفياً، كان قد عاش قلقاً لا يحسد عليه، فهو لا يعلم ما يمكن أن يحصل لنا أنا وداليا، ولم يكن بيده حيلة، فجواز سفره لم ينجز بعد، ولا يريد لي البقاء وحدي وسط هذا الوضع المرعب، لم أخبره بسفر جيراننا، لئلا أزيد من معاناته.
الاشتباكات وصلت إلى قدسيا القريبة جداً، والوضع غير آمن البتة، قد أستيقظ قريباً لأرى المنطقة مطوقة، ولا طريق لخروج أو لتواصل مع إخوتي أو الوصول إليهم في منطقة أخرى، كلها “قد”، لكن يمكن لها أن تقع، داليا ابنتي لديها فيزا لدخول لبنان قاربت على الانتهاء، يصبح بعدها دخولها شبه مستحيل، فكرت، قد يأتي وقت ويصبح دخولي أنا أيضاً صعباً! من يعرف هل يبقى طريق بيروت مفتوح أصلاً؟ كان هذا كفيلاً بأن أذعن لرأي منذر بالخروج من دمشق إلى بيروت.
بدأت أجهز نفسي لسفر مؤقت ربما يمتد لأشهر، أو حتى نهاية السنة الدراسية، لا بد أن أعود خلالها، فأنا السمكة التي لا ترغب في مغادرة بيتها، أود الاستقرار والاستمتاع بالشام، لكن الشام راحت تتغير على نحو درامي، لا متعة، ولا استقرار، حل مكانهما القلق والخوف.
قمنا بزيارة طبيب الأسنان لإنهاء علاج أسنان داليا، تبادلنا أطراف الحديث وأخبرته أننا نوينا السفر إلى بيروت، سألني بكل ما أوتي من حكمة: وبعد؟
قلت له: لا يوجد ما هو بعد.
أردف: بيروت تصلح لمحطة، لا للمدى الطويل، عليكم التفكير بما هو بعد.
نسيت تلك المحادثة ولم أتذكر ذلك السؤال، وتلك الإشارة إلا وأنا أخط هذه الأوراق.
وضعت ألبومات الصور في مكان واضح، بحيث يمكن أن نأخذها في زيارة قادمة، ومن باب الاحتياط جهزت الوثائق الرسمية الضرورية للسفر، عدا عن ذلك أنت ستودع بيتك بما فيه، وتعلم أن الحنين سيغزو قلبك، إلا أن الأمر سيبدو أكثر تعقيداً من مجرد مكان تودعه، هي حياة بحلوها ومرها، تعلم في قرارة نفسك أنها في سبيلها إلى أن تتحول إلى ذكرى، ولك أن تتصور ما يعني هذا لشخص لمثلي أنا التي “لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا“.
في صباح 10/12/ 2012، وعلى وقع هتاف تسلل عبر مكبر الصوت من المدرسة المحاذية للبيت “أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة.. إلخ..”، انطلقنا.
وقت عصيب
آثرت مغادرة دمشق والسفر وابنتي الصغيرة داليا إلى بيروت في عربة لسائق عرفناه منذ فترة من الزمن ونشأ بيننا وبينه ود وثقة، فقد كان عبدالمعين سائقا ماهراً في تجاوز العقبات لاسيما في ظل الازدحام الشديد على الحدود وكثرة الحواجز الأمنية.
ما إن وصلنا إلى حاجز الفرقة الرابعة حتى تبين لي أن اختياري لم يكن كله في محله، فعبدالمعين ليس بالسائق الأنسب لمهمة التعامل مع هؤلاء المرعبين، فهو خبير في قيادة السيارة، وقمة في الأخلاق، إنما ليس خبيراً بالحواجز ومفاتيحها، لاسيما هذا الحاجز الغني عن التعريف، إذ لدى عناصره صلاحيات كاملة بكل ما يريدون، مصادرة أغراضك، إرعابك، إهانتك، اعتقالك، قتلك، وفي أفضل الأحوال “نقعك” ساعات أو إعادتك من حيث أتيت إن لم تنل رضاهم لأمر ما، لذا عليك التزام الصمت دون أن تبدي أيّ علامات التذمر، بل يفضل أن تنهال منك عبارات الرضا، فتلهج بالدعاء “الله يخليلنا ياكم” أو شيء من هذا.
كنا نرى ركاب السيارات أمامنا، يلقون بأمتعتهم على الأرض، يفرغون السيارة بالكامل، بحيث يمكن لعناصر الحاجز تفتيشها.
بعد وقت طويل، جاء دورنا، بداية هوياتنا مشبوهة، أنا هويتي من حماة، وعبدالمعين من خان شيخون، هويتان “ذهبيتان”، أتى الأمر: “صف على جنب وروح فيش”.
ذهب عبدالمعين إلى “الكولبة” التي يجري فيها تدقيق الهويات، الحمد لله لم يستغرق وقتاً طويلاً، عاد ليضع أغراضنا على الأرض، وقفنا أنا وداليا على جانب الطريق، ننظر إلى العسكري يعبث بحقائبنا.
استغرق الأمر ما يقارب الساعة، ما يعتبر مقبولا في هذه الأيام. الحمد لله أن الأمور سارت دون منغصات خارجة عن المألوف.
فيما بعد سيحدث أن آتي وأذهب مع سائق يعرف المفاتيح، يدفع للحاجز، ويحمل باكيتات دخان مارلبورو، توضع في جيب الباب الأمامي، كفيلة باختصار الوقت بشكل كبير، دون الحاجة لتفريغ السيارة وتفتيش الأغراض، بل على العكس “سلام يا غالي”.
وصلنا إلى الحدود السورية، الزحام في قاعة المغادرين كان هائلاً، نساء وأطفال ورجال من كل الأعمار، حمدت الله أن ابنتي تحمل جواز سفر عراقي، وستقف في رتل المسافرين من غير السوريين، وهم قلائل.
حاولت البحث عن رتل للنساء، لا يوجد، كل الأرتال متشابهة، وقفت في أحدها، التقدم بطيء جداً، وخبرة الشرطي وراء الكمبيوتر تماثل خبرتي في التنجيم، فهو يحتاج إلى البحث عن كل حرف ليضغط عليه بإصبع من يده اليمنى، فيما يتكئ رأسه على اليسرى بملل، وكلما نجا أحد من رتلي أعاود عد الرؤوس المتبقية أمامي، لكن حساباتي شتتها رجل يحمل ما يقارب ستة جوازات تقدم من الطرف المعاكس متجاوزاً الجميع ووصل إلى الكوة ومد يده إلى الشرطي وسلمه ما فيها “تفضل معلم”، لا يمكنك الاعتراض، فالعواقب وخيمة في بعض الحالات!
بعد ما يقارب الساعة ختمت جوازات سفرنا وتوجهنا إلى الحدود اللبنانية، هناك كان الخطب أعظم، فالقاعة صغيرة، وعدد العاملين قليل جداً، ناهيك عن التباطؤ المقصود غالباً، وبكاء الأطفال يملأ المكان.
لا خيار أمام العابر، كل السبل عسيرة، توكلت على الله ووقفت في الرتل الأقرب لي، دون أن أنتبه لطولي، من تقف أمامي يكاد يكون حجمها ضعف حجمي، لكن لا مجال للتراجع، فخلال لحظات أصبح ورائي الكثير من الأشخاص.
الزحام خانق وصوت الشجار يعلو، رجال يلكمون بعضهم البعض في جدال حول من يسبق من، أطفال يبكون، الهواء الخانق أطبق على أنفاسي بين سيدتين من أمامي ومن خلفي، واحدة طويلة حجبت عني الهواء، سأطلب من الله تعويضاً عن قامتي القصيرة! جيناتي هي السبب ولكن ما ذنبي إذا كانت عمتي قصيرة؟
هل يمكن لهذه السيدة الضخمة أن تنحني وترى وجهي المتجهم.. هل يكون لطيفاً مني أن أسألها الابتعاد قليلاً، عساني أتنفس؟
عبدالمعين في الرتل المجاور لاحظ ضيقي، ناولته حقيبة يدي شاكرة، لا مكان لها معي.
سيدة تشتم رجلاً تحرش بها، ورجال الأمن ينهرون الجميع “سنوقف الإجراءات ونترككم ساعات إن لم تلتزموا الصمت”! تذكرت طابور العقاب في باحة المدرسة الابتدائية، في ظهيرة يوم قائظ في دمشق!
شجار جديد، والتقدم ما زال بطيئاً، وجدتني أركز قوتي البدنية متشبثة بمكاني لأمنع السيدة التي خلفي من أن تضغطني أكثر، أخلع معطفي، يسعفني عبدالمعين “هاتيه”. يا له من وقت!
فجأة وسط الضجة يخرج صوت بلهجة لبنانية جعلت كل حروف الألف في اللغة العربية ياء: “والله بدكن كاز يحرقكن حرق بتستاهلوا شو عم يساووا فيكن، من طيبن زتوا عليكن كيماوي“.
لم تكن سيرة الكيماوي واردة بعد!
زاد غيظي ووجدت نفسي أضغط بالاتجاه المعاكس جهة السيدة التي خلفي لأبعدها عني، أحسست بالدماء تغلي في عروقي، لكن من حسن حظها وحظي جاء دوري، ما هي إلا دقائق وننتهي.
خرجت من بين الجموع، كالخارج من عراك، أكمامي مرفوعة، شعري مبعثر، تكاد الشتائم تخرج من فمي.
بحثت عن داليا التي أنجزت معاملتها وراحت تنتظر منذ ساعتين، لطالما كان الوضع معكوساً، كنت أختم جواز سفري في دقائق، بينما ينتظر أفراد عائلتي “العراقيون” ساعات.
وجدتها تنتظر في الخارج مستندة إلى الحائط، كنت خائفة عليها من وجودها وحدها في هذه الفوضى، خاصة وأن شكلها يوحي أنها طفلة صغيرة. حمدت ربي وشكرته، وأنا أشعر بتوتر حد البكاء.
انتظرنا عبدالمعين، لم يتأخر طويلاً، أغراضي معه، شكرته وكدت أردد في سري “جبناك يا عبدالمعين تعينّا”.




